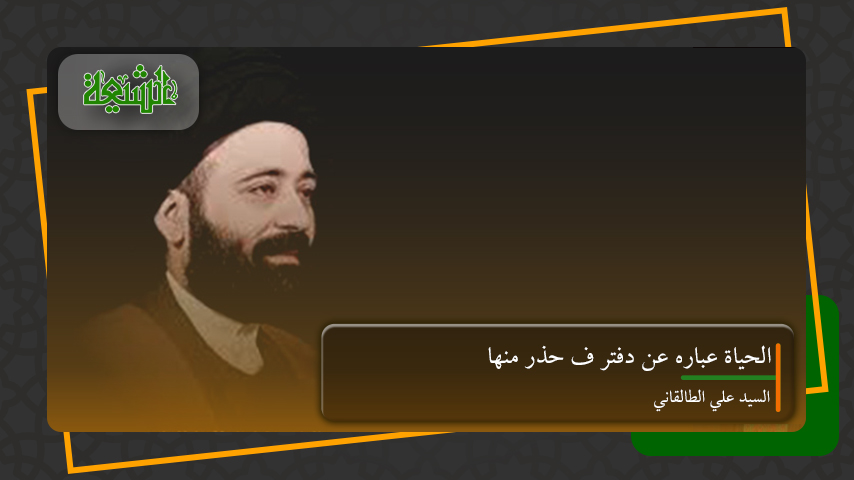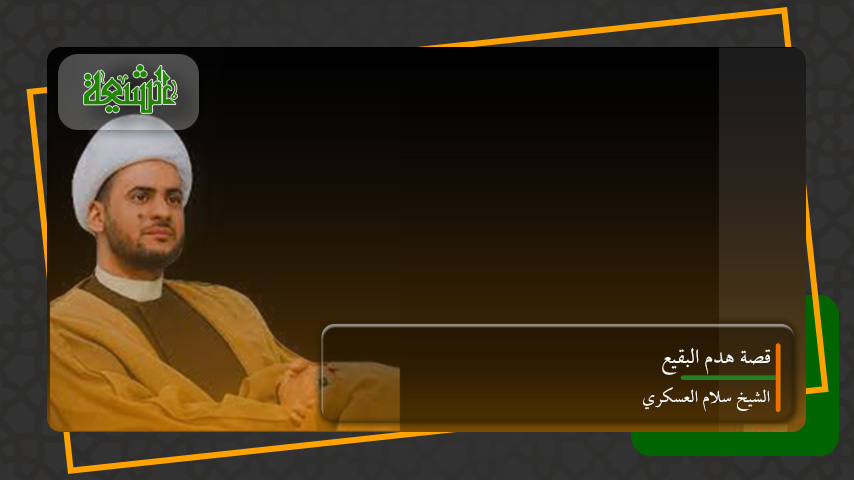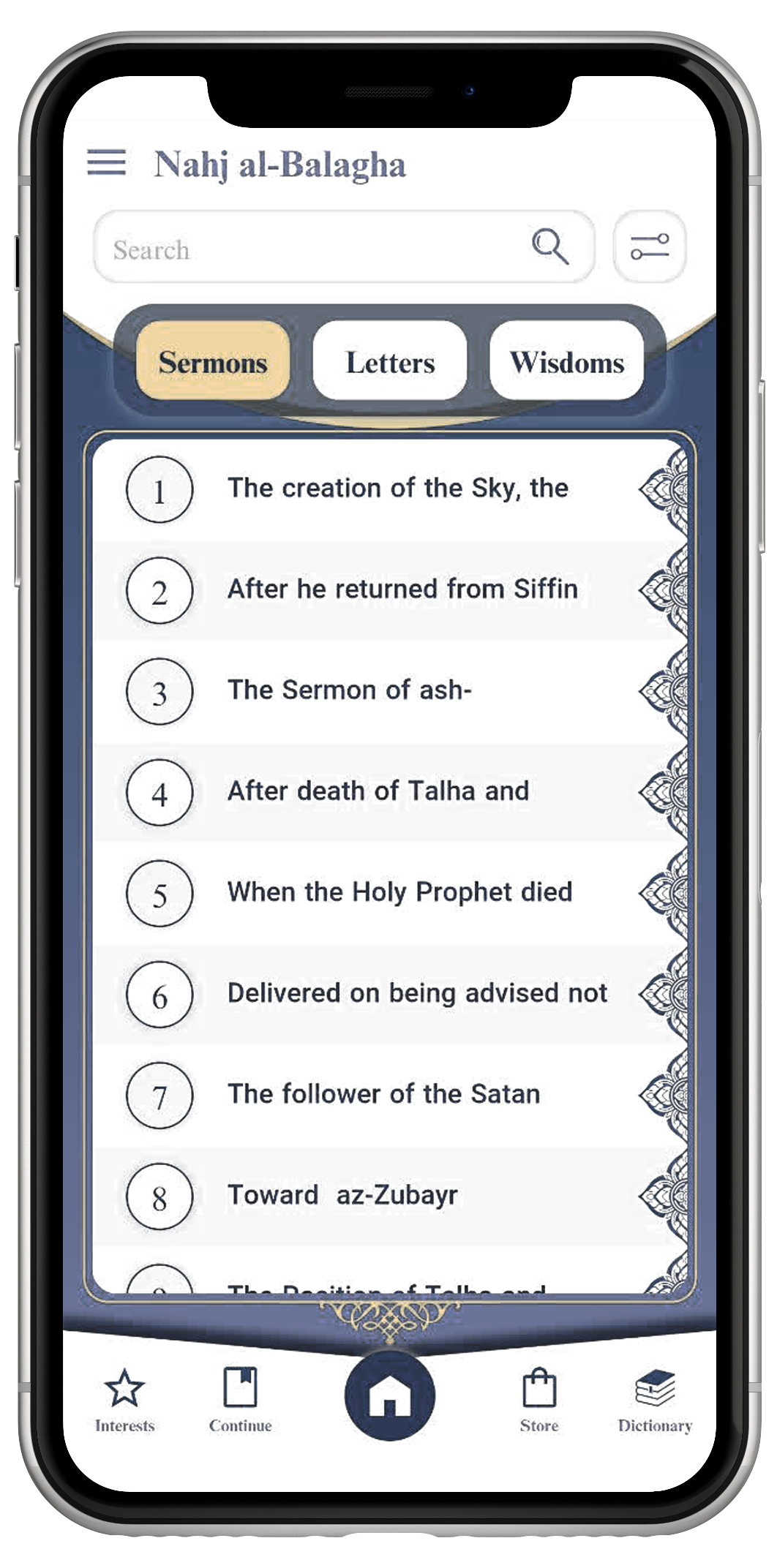وأما ما ظهر منه صلوات الله عليه وآله عقيب البعث وإظهار النبوة من الآيات والمعجزات فضربان :
أحدهما : هذا القران الذي أنزله الله سبحانه عليه وأيده به .
والاخر : غيره من المعجزات .
فوجه الاستدلال من القران : أن كل عاقل سمع ، الأخبار وخالط أهلها قد علم ظهور نبينا عليه واله السلام وادعاءه الرسالة من الله إلينا ، وأنه تحدق العرب بهذا القرآن الذي ظهر على يده وادعى انه اختصه الله به ، وان العرب مع تطاول الأزمان لم يعارضوه ، إذا ثبت ما ذكرناه ، وعلمنا أنهم إنما لم يعارضوه لتعذر المعارضة عليهم فهذا التعذر معجز خارق للعادة . فأما الذي يدل على أنه عليه السلام تحدى بالقران فهو أن المراد بالتحدي أنه كان يدعي أن جبرئيل يهبط عليه بذلك ، وأن الله سبحانه قد أبانه به ، وهذا معلوم ضرورة وهو غاية التحدي في المعنى .
وأيضا : فإن آيات القران صريحة في التحدي وهي قوله تعالى : ( فأتوا بعشر سور مثله ) ( 1 ) وفي موضع آخر : ( فأتوا بسورة من مثله ) ( 2 ) .
وأما الذي يدل على انتفاء المعارضة منهم فهو أنه لو وقعت المعارضة لوجب ظهورها ونقلها ، فإذا لم تنقل وجب القطع على انتفائها ، وإنما قلنا ذلك لأن جميع ما يقتضي نقل القران من قوة الدواعي وشدة الحاجة وقرب العهد ثابت في المعارضة ، بل المعارضة تزيد عليه ، لأنها كانت تكون الحجة والقرآن شبهة ، ونقل الحجة أولى من نقل الشبهة ، وكيف لا تنقل المعارضة لو كانت وقد نقلوا كلام مسيلمة مع ركاكته وبعده عن الشبهة .
فان ادعي ان المانع من النقل هو الخوف من أهل الإسلام وقد بلغوا من الكثرة إلى حد يخاف من مثلهم .
فجوابه : أن الخوف لا يقتضي انقطاع النقل على كل وجه ، وإنما يمنع من التظاهر به .
ألا ترى أن فضائل أمير المؤمنين عليه السلام قد نقلت ولم ينقطع النقل بها مع الخوف الشديد من بني أمية والرهبة من التظاهر بها ، وكان يجب أن ينقل ذلك أعداء الإسلام أو يكون نقلا مكتوما فيما بينهم .
وأيضا فإن الكثرة في الإسلام كانت بعد الهجرة ، فكان يجب نقل المعارضة قبل ذلك في مدة مقامه بمكة ، وإذا نقلت وانتشرت لم تكن قوة الإسلام موجبة بعد ذلك لخفائها إلا أن يدعى أن المعارضة لم تقع في تلك المدة وإنما وقعت بعد الهجرة ، وفي ذلك كفاية في إعجاز القرآن وثبوت خرق العادة به .
على أن الإسلام وإن ، قوي حينئذ بالمدينة ، فقد كانت لأهل الكفر ممالك كثيرة وبلاد واسعة ، ومملكة الفرس كانت ثابتة لم تزل ، وممالك الروم وغيرها من البلاد إلى هذه الغاية عريضة ، فكان يجب ظهور المعارضة في هذه البلاد .
وأما الذي يدل على أن انتفاء المعارضة كان للتعذر إنا قد علمنا أن كل فعل يرتفع من فاعله مع توفر دواعيه إليه وقوة بواعثه عليه فإنه يدل على تعذره ، فإذا ثبت ذلك وعلمنا أن العرب تحدوا بالقرآن ولم يعارضوه مع شدة حاجتهم إلى المعارضة وقوة دواعيهم ، علمنا أنها متعذرة عليهم ، فإذا انضاف إلى ذلك أنهم قد تكلفوا الأمور الشاقة من الحرب وغيره مما لو بلغوا غاية مرادهم فيه لم يكن لهم بذلك حجة ، اتضح الأمر في أنهم قد تعذرت المعارضة عليهم ، هذا وقد دعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المعارضة وهم ذوو الأنفة والحمية ، وطالبهم بالرجوع عن دياناتهم ، والنزول عن رئاستهم ، والبراءة من آبائهم وأسلافهم وأبنائهم ، ومجاهدة من خالف دينه وإن كان من أنسابهم وأقربائهم ، وعلموا أن بالمعارضة يزول ذلك كله ويبطل ، فأي داع أقوى من هذا ؟ وكيف لا يكونون مدعوين إليها وقد تحملوا ضروبا من الكلف والمشاق كالمحاربة وبذل الأموال ونظم الهجاء ، مع أن كل ذلك لا يغني ، فلو تيسرت لهم المعارضة لبادروا إليها ، إذ كانت أسهل مما تكلفوه وتحملوه وأحسم للمادة من كل ما فعلوه .
وأما الذي يدل على أن تعذر المعارضة كان على وجه الإعجاز هو أن ما يمكن أن يدعى في ذلك أن يقال أنه عليه السلام كان أفصحهم فتأتي له ما لم يتأت لهم ، أو يقال : إنه تعمل زمانا لم يكن طويلا فلم يتمكنوا مع قصر الزمان من معارضته ، فإذا بطل هذان الوجهان لم يبق إلا أن هذا التعذر غير معهود ، فهو خارق للعادة .
والذي يدل على فساد الوجه الأول : أن المطلوب في المعارضة ما يقارب الفصاحة ، والأفصح يقاربه في كلامه وفصاحته من هو دون طبقته ، فإذا لم يماثلوه ولم يقاربوه فقد انتقضت العادة ، وأيضا فإن الأفصح إنما تمتنع مساواته ومجاراته في جميع كلامه أو أكثره وليس تمتنع مجاراته ومساواته في البعض منه على من هو دون طبقته ، بهذا جرت العادة ، ولهذا فقد ساوت الطبقة المتأخرة من الشعراء الطبقة المتقدمة منهم في البيت والأبيات ، وربما زادوا عليهم في القليل ، وإذا كان التحدي وقع بصورة قصيرة من عرض القرآن فكونه أفصح لا يمنع من مساواته في هذا القدر اليسير ، وأيضا فليس يظهر من كلامه عليه السلام فصاحة تزيد على فصاحة غيره من القوم ، ولو كان أفصحهم وكان القرآن من كلامه لظهرت المزية في كلامه على كل كلام في الفصاحة كما ظهرت مزية القرآن .
وأما الذي يدل على فساد الوجه الثاني – وهو إنه تعمل زمانا طويلا – : فهو أنه كان ينبغي أن يتعملوا مثله فيعارضوه به مع امتداد الزمان ، فإذا ثبت أن التعذر خارق للعادة فلا بد من أحد أمرين : إما أن يكون القرآن نفسه خرق العادة بفصاحته فلذلك لم يعارضوه ، وإما أن يكون الله تعالى صرفهم عن معارضته ولولا الصرف لعارضوه ، وأي الأمرين كان ثبتت معه صحة النبوة ، لان الله تعالى لا يصدق كاذبا ، ولا يخرق العادة لمبطل ، ولو ذهبنا نصف ما سطره المتكلمون في هذا الباب من الكلام وما فيه من السؤال والجواب لطال به الكتاب ، وفيما ذكرنا ههنا مقنع وكفاية لذوي الألباب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) هود 11 : 13 .
( 2 ) البقرة 2 : 23 .
المصدر: إعلام الورى بأعلام الهدى ج1 / الشيخ الطبرسي