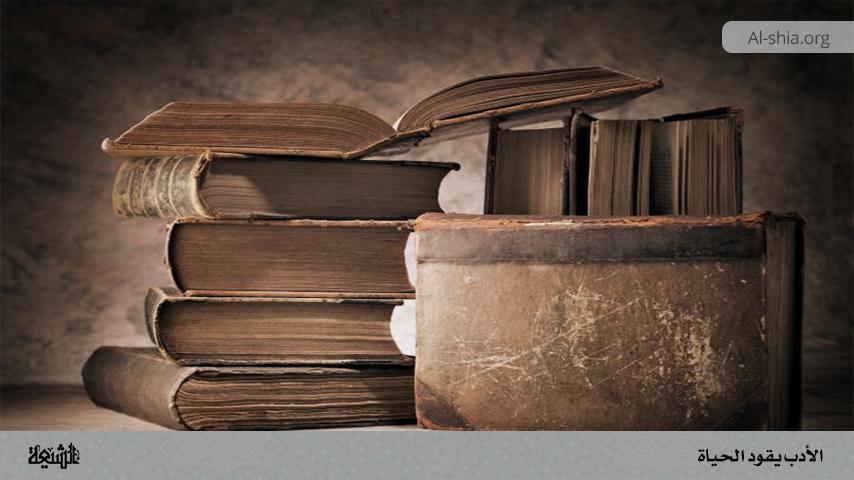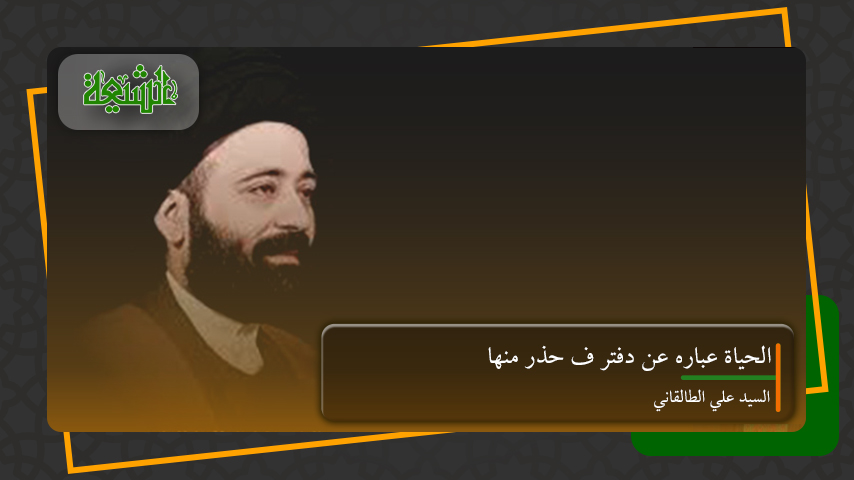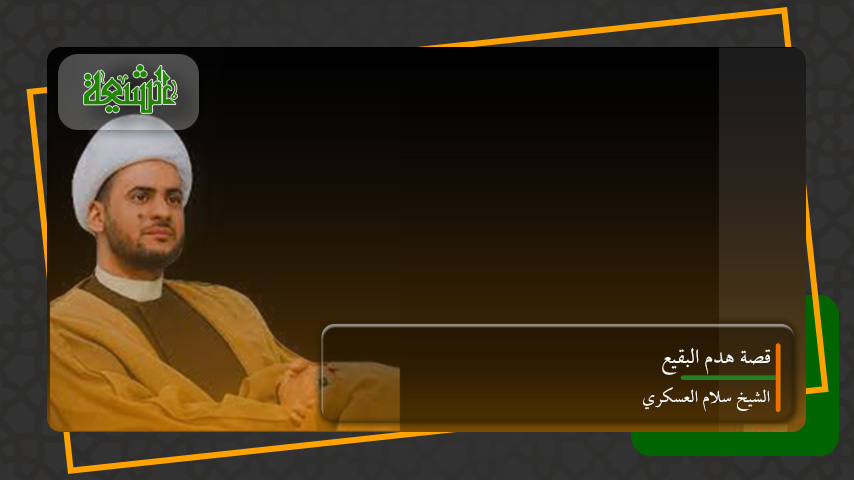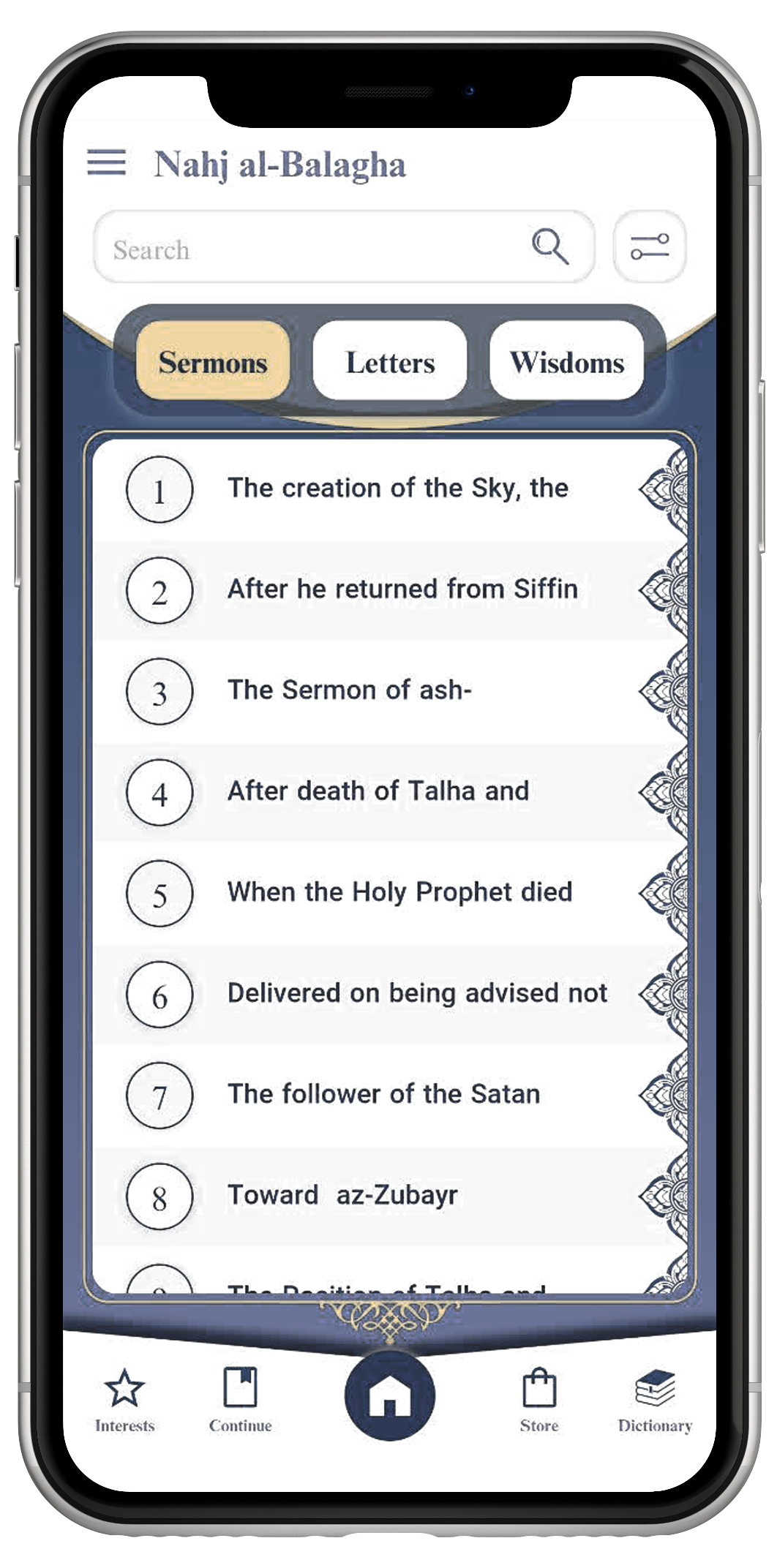يوثّق الأديب في نصوصه الأدبية تاريخ المرحلة التي عاشها بكل تفاصيلها، ويعبّر عنها بمقتضى رؤاه الخاصة وفي سياق قراءته الشاملة للأحداث العامة، لأنه ولد وترعرع في تلك البيئة وتأثر بثقافتها وانصقل قلمه في مناخها السياسي، لذا فراداره الشفاف يلتقط أدق الأجزاء التي قد يغفل عنها باقي الناس، يضيء الزوايا المعتمة لتتنبه عقول الناس، وقد يصرّح بتلك الحقائق علنا أو بشكل ضمني، فالزخم الشعوري الذي ينصب في وجدان المتلقي بفعل نص حي متوقد يوقظ في الذهن كماً من الأسئلة التحفيزية الانقلابية الدافعة إلى الحراك الواعِ والانتفاض على حالة الركود والجمود.
فمن خلال المواقف والأحداث تنكشف حقائق مغيبة عن وعي المتلقي تدخله في طور التفكير بعد أن يخرج من دائرة الرتابة المقفلة على اليأس والإحباط، فيكتشف زيف واقعه وأكاذيب الأنظمة السياسية التي تنتهك كرامته وحقوقه وأنه مجرد كائن بهيمي يعيش حياة آلية تفتقد إلى التجديد والتطوير، يأكل ويشرب وينام ثم يصحو ليعمل ويأكل ويشرب وينام وهكذا دواليك، الحياة الاستهلاكية الضيقة الأفق المحدودة الهدف، فقلم الأديب الرسالي يفتح أمام المتلقي منافذ الهروب من سجن الذات والاستغراق الأناني في النفس للإنطلاق نحو العالم الأرحب حيث التفاعل الاجتماعي مع الناس والانصهار بقضاياهم المصيرية الهامة.
فالأدب (فن) يستخدم كأداة تغيير لواقعنا السياسي والاجتماعي والفكري، وليس هدفاً بحد ذاته أي الأدب للأدب فحسب وعزله عن جوانب الحياة الأخرى حتى لا يتشوه بخبث السياسة وألاعيبها القذرة فتسييسه وأدلجته مبررات لا تسوغ للناقد أن يلغي دوره في التأثير على فكر الأمة، فالقرآن الكريم عبارة عن قصص كثيرة ذات عناصر فنية منسجمة ومتكاملة، كانت وسيلة وعظ وتوجيه وإرشاد للأمم، ففيها من العبر والحكم البناءة والمثمرة في إصلاح النفوس، فقصة النبي يوسف (ع)، وسورة القصص، وقصة أهل الكهف وغيرها من السور، فالأسلوب القصصي المتسلسل الأحداث والمحبوك حتى العقدة كان أكثر تأثيراً في نفوس الناس، فمن الغبن فصل هذا الفن العريق عن الواقع السياسي أو العقائدي وحصره في إطار ضيق ومحدود والانشغال بالقوالب الإبداعية القشرية وتهميش المضمون وهو الأهم فالأجدى توظيف الأدب كفن في تغيير فكر الإنسان وتنويره ليستكشف ذاته جيداً ويفجّر قدراته وطاقاته كي يحرك مياه المجتمع الراكدة والموبوءه بالتبعية والفقر والتخلف والانحطاط كي يتقدم خطوة نحو الخلاص.
فالغرب حينما استعمر الأمة العربية أدرك أن اشتعال حركات التحرير كان بفعل كلمة حرّة ونص ثوري أوقد الفتيل وألهب العزائم، لهذا شنّ حملات التغريب على الثقافة العربية تحت عنوان الحداثة، وابتعث كثير من المثقفين إلى أوروبا للرفد من مناهله المدهشة فعادوا محملين بنية التطبيع لا التطوير، ومن ثم بتر جذور الأصالة والقفز نحو فضاء ثقافي باهت اللون، مبهم الهوية، إذ فقد النص روحه وأصالته فكان مسخ رقيع يتخذ من الأحداث الهامشية والسطحية مضامين تشغل الشعوب عن قضاياها الأساسية ويثير شغف المتلقي في أسلوب حكائي شيق محصور في ذوات الأبطال وفي نطاق عوالمهم الخاصة مع شحن حالة الترقب والتشويق لا الوعي والتنوير، غرض المتعة ودغدغة الغرائز.
ذلك الغثاء من الروايات ودواوين الشعر الاستهلاكية التي تروج كالسلع الغذائية ساهمت إلى حد كبير في تحنيط الفكر وتسطيحه وتكريس ثقافة قائمة على المنفعه الحسية والمادية وسلخ الانسان وعزله عن واقعه الاجتماعي وتعطيل دوره الإيجابي في حراك المجتمع. فمن يعتقد أن الأدب فن جميل لا ينبغي تلويثه بالسياسة إنما يلغي أفتك سلاح في تغيير الأمم وتطويرها حضاريا.