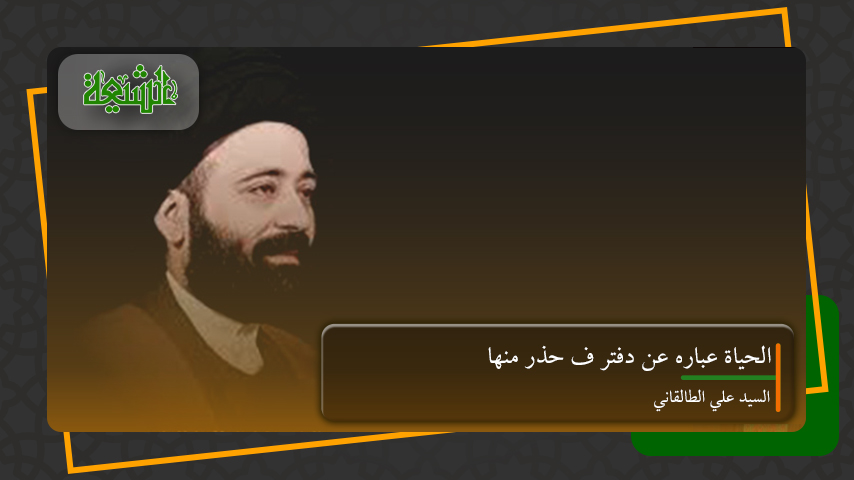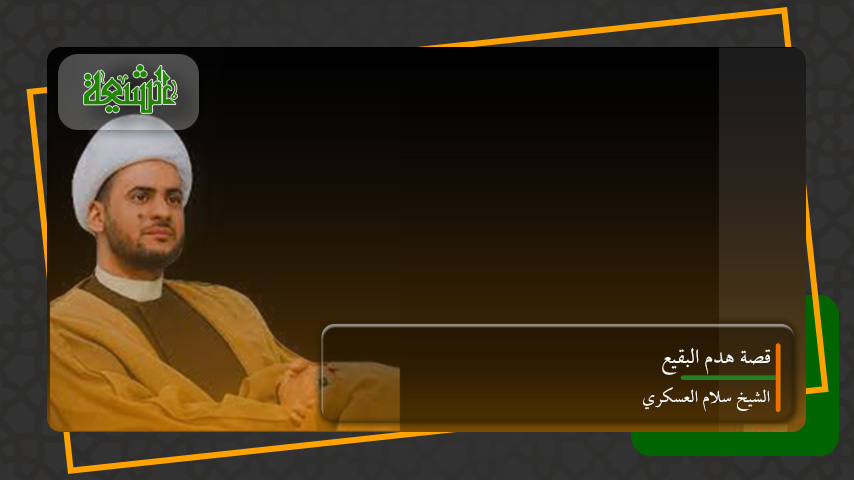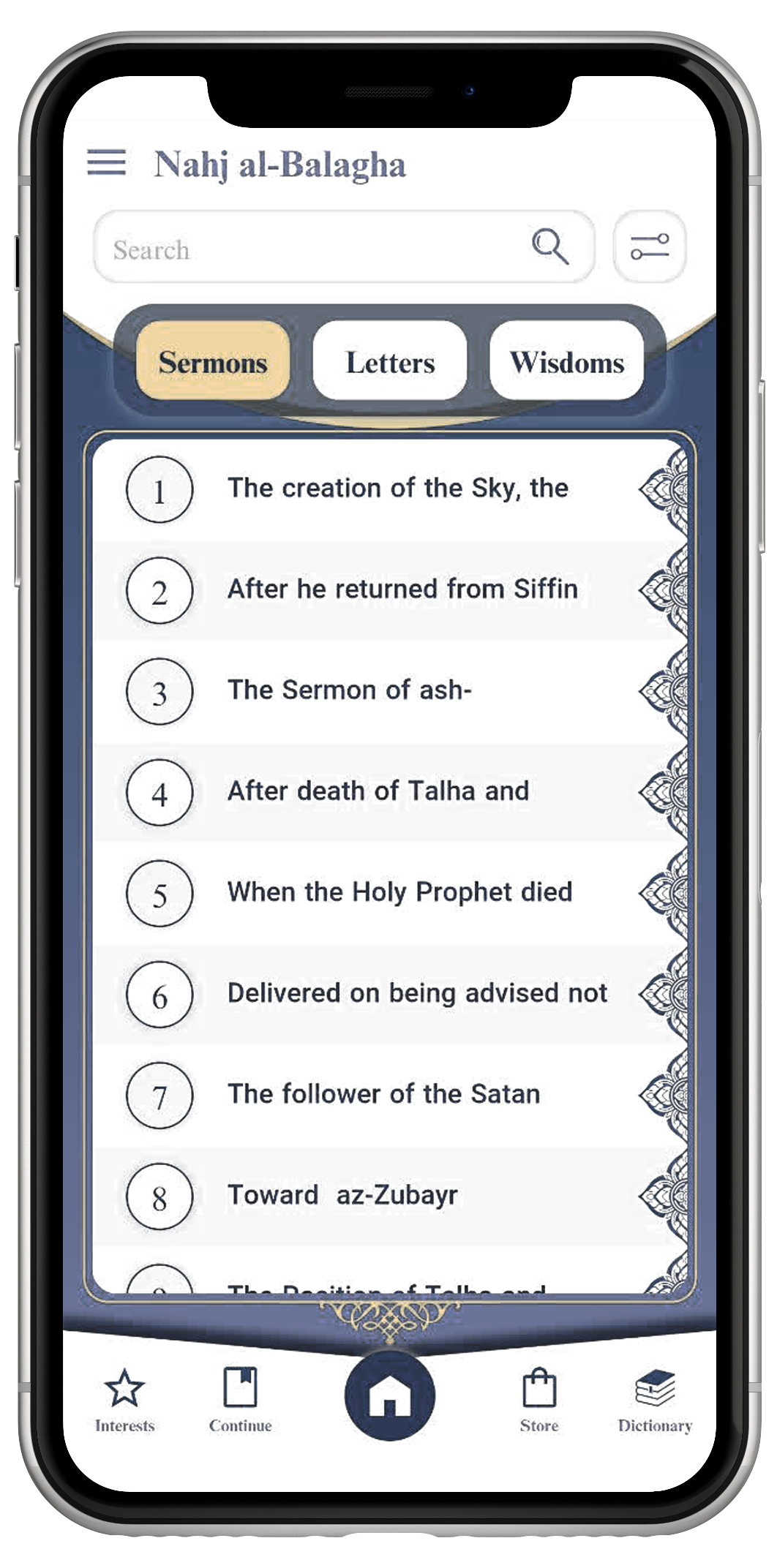ومن أشهر القائلين بأن التشيع تكون يوم خروج الخوارج بصفين ( وات مونتكومرى ) : إن بداية حركة الشيعة هو أحد أيام سنة ( 658 م – 37 ه ) حين قال جماعة من أتباع علي : إننا نوالي من والاك ونعادي من عاداك ويعني ذلك أن هؤلاء كانوا مستعدين للقول بأنهم يقبلون بصورة مطلقة حكم على القضايا المهمة ويظهر أن ( وات ) أخذ هذا الرأي عن الطبري : لما قدم على الكوفة وفارقته الخوارج وثبت إليه الشيعة فقالوا : في أعناقنا بيعة ثانية نحن أولياء من واليت ، وأعداء من عاديت ( 1 ) .
ويبدو أن المستشرق ( وات مونتكومرى ) من أبرز المتحمسين لهذه النظرية وليس بغريب ذلك لأن الذين يحملون صفة الاستشراق أكثر ما يعنيهم في كتاباتهم التعتيم على الحقائق الإسلامية وتشويشها بكل ما لديهم من الأساليب كما يبدو ذلك للمتتبع في مؤلفاتهم عن الإسلام والمسلمين .
ويدعى الدكتور أحمد صبحي في كتابه ( نظرية الإمامة ) : أن التشيع جاء كرد فعل للخوارج يتضح فيه مدى المقابلة بين العقيدتين فبينما جعل الخوارج الإمامة عامة كان لا بد للشيعة من مواجهة ذلك بأن جعلوها في بيت النبي ( ص ) وذرية علي ( ع ) بالنص عليه من النبي ( ص ) ، وبينما طائفة من هؤلاء ترى الإمامة غير واجبة ولا يلزم نصب الإمام وإذا بالشيعة يجعلونها واجبة على الله ، وهكذا يظهر رد فعل التشيع كعقيدة لآراء الخوارج في الإمامة ، ويجب أن نعترف بأن الخوارج كمذهب عقائدي له نظرياته في الإمامة سابق في وجوده على التشيع كعقيدة ، وأضاف يقول : ولا يستبعد أن يكون كثير من عقائد الشيعة قد صيغت متأثرة في ذلك بنظرية الخوارج في الإمامة على نحو عكسي لا سيما وأن كارثة انشقاق الخوارج من أكبر ما حل بأنصار علي من كوارث تبعها مصرع علي نفسه على يد واحد منهم ، ثم جرأتهم البالغة في تكفير علي ( ع ) وهو ما لم يذهب إليه ألد أعداء علي كمعاوية ، فكان لا بد وأن يقابل ذلك بتقديس علي ورفع مقامه إلى مرتبة وصي النبي وخليفته بالنص الإلهي ، وانتهى في تقريب هذه النظرية إلى القول :
إن الذين أرجعوا بداية التشيع إلى وفاة الرسول ينظرون إلى من تابعه وناصره : كعمار وسلمان وأبي ذر وغيرهم ، والذين أرجعوه إلى زمن خلافته ينظرون إلى من ناصره وأيده في حربي ( الجمل ) و ( صفين ) ، وكان هو يسمى المناصرين له في هذه المعارك ( شيعتي ) ، كما جاء ذلك عن ابن النديم ، واستطرد يقول : إن أنصار علي ( ع ) على كثرتهم لم تكن تجمعهم عقيدة مشتركة ولا هدف واحد ، فلقد كان بعضهم من أشد المخلصين له في جميع مواقفه : كعمار ، وابن عباس ، وحجر بن عدي الكندي ، وغير هؤلاء من العشرات الذين رافقوا أكثر المراحل التي مر بها الرسول بعد هجرته ويقدرهم أكثر المؤرخين بألفين وثمانمائة من صحابته ، بينهم سبعة وثمانون بدريا وتسعمائة ممن بايعوه ( بيعة الرضوان ) تحت الشجرة ، وكانت تحدو إخلاصهم لعلي أسباب أخرى إلى جانب الاعتراف له بخلافة الرسول ( ص ) وهو الخوف على مصيرهم من الأمويين فيما لو تم الأمر لمعاوية كما يشير إلى ذلك قيس بن سعد الأنصاري في كتابه إلى النعمان بن بشير الذي كان إلى جانب معاوية الذي يقول فيه : لو اجتمع العرب على بيعة معاوية لقاتلهم الأنصار .
ومضى يقول : لقد ناصر الأنصار عليا ( ع ) لأن وضعهم الطبيعي يفرض أن يكونوا معه وإلى جانبه ، ولم يناصروه باعتبارهم شيعة له بقدر ما آزروه بوصفهم من الأنصار ولا يتنافى هذا مع إخلاصهم في نصرته ، وحينما صالح الحسن معاوية أصر قيس بن سعد على الاستمرار في الحرب وخير جنده بين الاستمرار معه وبين أن يذهبوا إلى ما ذهب إليه الحسن بن علي ( ع ) ، وهناك فريق آخر من أنصاره وهم طائفة القراء والزهاد وحملة القرآن ، وهذه الطائفة لم تكن على المستوى المطلوب ، فكانوا يجتهدون في آرائهم ويخالفونه أحيانا ويرون رأي أبي موسى الأشعري ومن كان على شاكلته ، وهؤلاء حينما رفعت المصاحف كانوا أول من توقف عن القتال وبالتالي أجبروه على قبول التحكيم واختيار أبي موسى كممثل له في مقابل ابن العاص .
وكان بين أصحابه فريق آخر ممن اشتركوا في غزو المدينة لقتل عثمان ، وهؤلاء كان ينقصهم الحماس الديني والعقيدة الفكرية التي تدفعهم إلى الإخلاص في نصرة علي ( ع ) إذ لم يكن ذلك يهمهم بقدر ما يهمهم أن لا يقتص معاوية منهم ولعل معاوية قد عرف منهم ذلك ، ولذا فإنه لم يسع للاقتصاص منهم إذ أعطوه سلما وأعطاهم في مقابله أمانا .
وخلص أنصار هذه النظرية من ذلك كله إلى أن التشيع بالمعنى المعروف لدى الفقهاء والمتكلمين ومؤرخي الفرق لم يكن في أيام علي ( ع ) وأن معناه في أيامه هو نفس المعنى اللغوي القديم كما ورد في الآية : ( فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ) وفي الآية : ( وإن من شيعته لإبراهيم ) وهو فيهما يعني الأنصار والأتباع .
ولكنه تطور بعد ذلك ردا على نظرية الخوارج الذين كفروه وجعلوا الإمامة حقا لكل أحد من الناس ، فرد عليهم أنصاره وأتباعه فقدسوه ورفعوه إلى مرتبة وصيي النبي وخليفته بالنص الإلهي على حد تعبير أنصار هذا الرأي .
بهذا النحو من التضليل والتلفيق أرادوا أن يصوروا التشيع لعلي ( ع ) منذ مراحله الأولى وكأنه صدفة فرضته التطورات التي طرأت على سير المعارك في ( صفين ) بعد الانتصارات الساحقة التي حققها أمير المؤمنين علي ( ع ) ، والتي لولا خيانة بعض القادة الذين يشكلون مع عشائرهم أكثر من نصف الجيش لوقع معاوية أسيرا بيد العراقيين وتم الفتح لعلي ( ع ) .
ومن تتبع أحداث ( صفين ) ومراحلها وما انتهت إليه يخرج منها بأن المنشقين من جيش العراق بقيادة الأشعث بن قيس ، وشبث بن ربعي وغيرهما كانوا على اتصال دائم مع معاوية ، وابن العاص قبل أن يتحرك علي ( ع ) من الكوفة ، وخلال مدة الهدنة في الأشهر الحرم كانوا يتصلون بمعاوية وزبانية بشكل غير مباشر ، ويخططون لكل الاحتمالات التي منها رفع المصاحف عندما تصبح المعركة لغير صالحهم ولكل ما جرى بعد رفع المصاحف من محاولة الجائه إلى التراجع عن التحكيم واستئناف المعارك بعد أن دب الوهن والتخاذل في صفوف الجيش وانقسم على نفسه .
وقد أدرك أمير المؤمنين ( ع ) كل ذلك وتجسدت لديه نتائج المعركة بكل فصولها إن هو استجاب لطلبهم ، فآثر أن يصبر على مرارة ما جرى ويرجع بمن معه إلى العراق تاركا ( صفين ) وأحداثها للأجيال تستلهم من مواقف علي ( ع ) فيها كل معاني الخير والفضيلة والنبل والكرامة والتضحية في سبيل الله وخير الإنسانية ، كما تستلهم من مواقف معاوية وحزبه فيها كل معاني الشر والرذيلة والخداع والحقد على الإسلام ودعاته المخلصين .
ولم تكن أحداث ( حروراء ) وما كان يجري بعدها من تحركات المنشقين عن علي ( ع ) بين الحين والآخر : كالخريت ومن على شاكلته إلا من فصول تلك الحلقة التي سبكها بين معاوية وحزبه من جهة ، وبين الأشعث بن قيس وبقية الخونة في العراق من جهة أخرى ، حتى لا يبقى لعلي ( ع ) من الوقت ما يتسع لمقابلة معاوية ومقاومته بواسطة أنصار معاوية في الكوفة : كالأشعث بن قيس ، وشبث بن ربعي ، وغيرهما ممن أغراهم معاوية بالمال والوعود إذا تم له الأمر واستولى على العراق ، ولعل ذلك كان معروفا بين أكثر أهل الكوفة يومذاك .
ولم تكن طلبات المنشقين على أمير المؤمنين ( ع ) كالتوبة والاعتراف بالجرم وغيرهما من الطلبات إن صح ذلك إلا لتغطية المؤامرة التي تمت صياغتها بكل فصولها ومراحلها قبل معركة ( صفين ) كما لم تكن لطلباتهم المزعومة ذلك الصدى والأثر حتى عند من لا يؤمن بقداسة علي ( ع ) ليضطر أنصاره إلى تغطية ذلك بدعوى الوصاية والعصمة وغيرهما من الأفكار الشيعية كما يدعي أنصار هذا الرأي .
لقد ترك هؤلاء وراءهم أقوال الرسول ( ص ) : ( بأن عليا مع الحق والحق مع علي ) التي كررها الرسول ( ص ) وأكدها في عشرات المناسبات والتي لا ينكرها أحد من المسلمين على اختلاف نزعاتهم وميولهم والتي تعني فيما تعنيه عصمته من الخطأ والذنوب ، كما تركوا كل ما قاله الرسول ( ص ) فيه في بدر ، وأحد ، والأحزاب وفي غزوة تبوك ، وفي ( غدير خم ) ، وما قال فيه وهو على فراش الموت ، وقبل ذلك منذ بعثه الله وحتى النفس الأخير من حياته مما لا ينكره أحد من المسلمين .
لقد تركوا كل ذلك وراءهم وكأن التاريخ لم يسجل له شيئا ، وتجاهلوا مع ذلك مواقف من وقف إلى جانبه بعد وفاة الرسول ( ص ) من أعيان المهاجرين والأنصار وحججهم البالغة على الذين تكتلوا لإقصائه عن الخلافة ، ولم يجدوا لفكرتي الوصاية والعصمة سببا غير تجريح الأشعث بن قيس وابن العاص ومن كان على رأيهما ممن أسموهم بالخوارج والمارقين .
ــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) تأريخ الرسل والملوك : ج 4 ص 46 .
المصدر: نشأة التشيع/ السيد طالب الخرسان