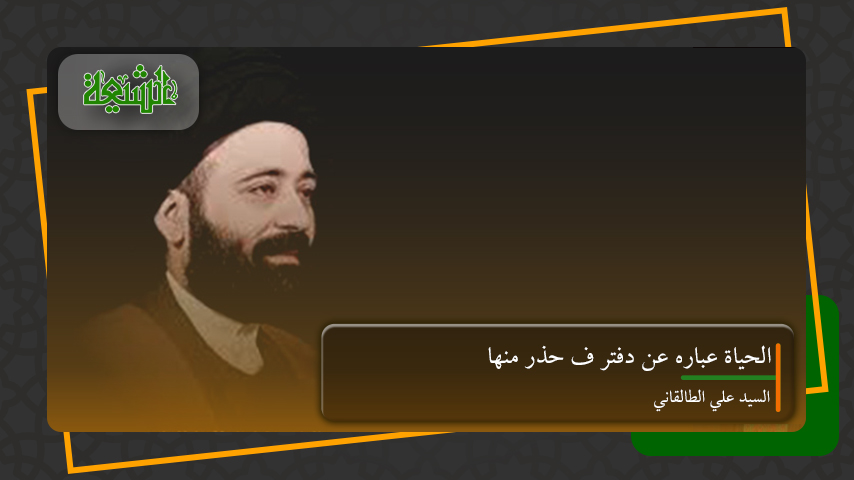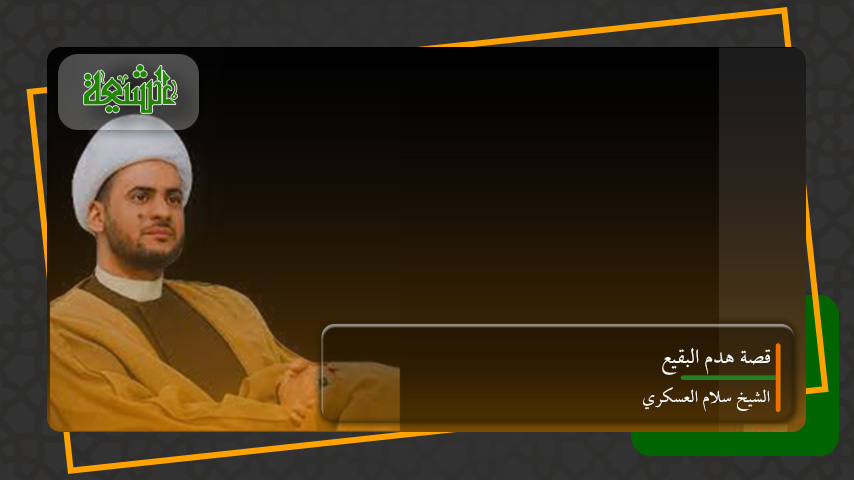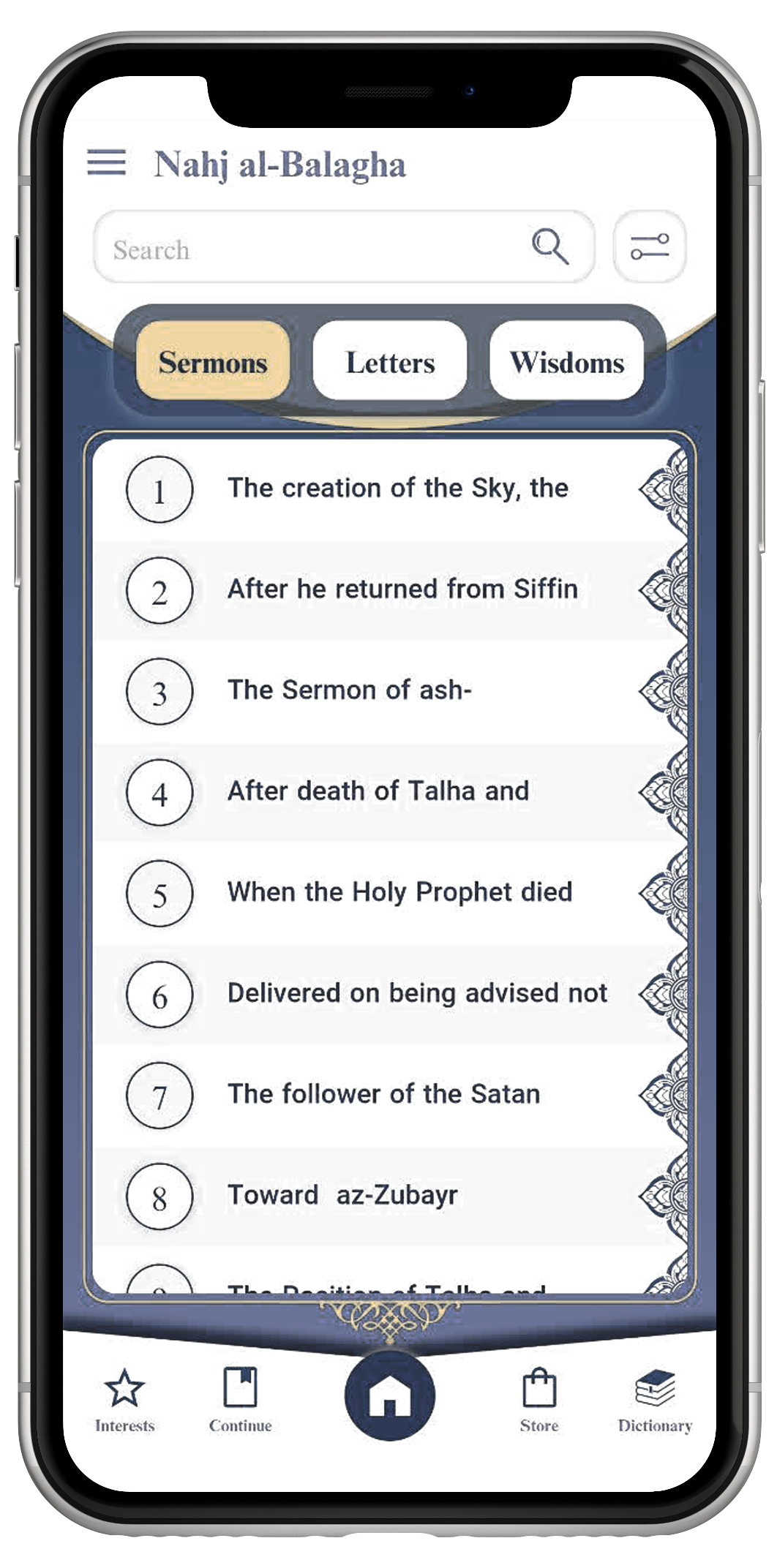المولد والنشأة
من مواليد السودان، نشأ في أسرة تعتنق المذهب السني، كان منذ صغره مهتماً بصياغة أفكاره ورؤاه وفق الأسس والمبادىء السليمة واليقينية، فدفعه هذا الأمر إلى البحث والتحقيق في المذاهب الإسلامية حتى لاح بصره نور معارف أهل البيت (عليهم السلام) فاشتاق لنيل المزيد من هذه المعارف، فلم يجد أرضية مناسبة لتلقي هذه العلوم سوى دولة ايران، فسافر إليها والتحق فيها بكلية الإلهيات والمعارف الإسلامية في مدينة مشهد.
ومن هنا تجلّت الحقائق التاريخية له، وتوصّل إلى قناعات جديدة ترتبط بالاعتقاد والمصير الأبدي، فلهذا لم يجد مجالا للمساومة أو المماطلة، فاعتنق مذهب التشيّع بعد الاعتماد على الأدلة والحجج والبراهين المقنعة.
دوافع توجهه للبحث:
أدرك الأخ طارق بعد وصوله إلى مرتبة النضج الفكري بأنّ الدين الإسلامي هو نظام الحياة الذي به يحدّد الإنسان المؤمن المسار الذي ينبغي أن يسير على ضوءه في هذه الدنيا، فلهذا لابد أن يقوم هذا الاعتقاد على أساس يبعث اليقين والطمأنينة، ولا يصح أن تنال المصائر بالظنون والتوهمات، أو تنال بالتقليد الأعمى الذي لا يعرف صاحبه الدليل والحجة غير ما كان عليه الآباء الأولون، فإذا سئل: لماذا أنت مسلم؟ فإنه لا يجيب إلاّ بالصمت والحيرة، وإذا قيل له: لماذا أنت شيعي أو سني، لم يجد اجابة مقنعة يقدّمها للسائل. كل ذلك لأنّه لم يفكّر في اعتقاده ومصيره من قبل بحريّة، بل قام كما عنده من اعتقاد على التقليد الأبوي والاجتماعي فصار هذا مسلماً شيعياً وصار غيره مسلماً سنّياً.
يقول الأخ طارق في هذا المجال: “لابد من التحقيق من سلامة العقيدة بالفحص واعادة النظر وتقليب البصر وإعمال الفكر والتدبّر في أحوالها، لأنّ العقيدة لا تورث حتى ندعها للفطرة وحدها، والاتّكاء على اعتقاد الاسلاف والآباء والاجداد ممنوع، وقد قال تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَ لَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْـاً وَلاَ يَهْتَدُونَ ) (المائدة: ۱۰۴)”.
ويضيف الأخ طارق: “إنّ الرسول(صلى الله عليه وآله) قد صرَّح محذِّراً أُمَّته إذ يقول(صلى الله عليه وآله): “افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أُمَّتي على ثلاث وسبعين فرقة” إذن فالاختلاف الذي وقع بين المسلمين إلى اليوم يؤيّد ما ذهبنا إليه في وجوب التحقيق والبحث في ما بلَغنا من اعتقاد، وإلاّ فكيف نطمئنّ على حصول السلامة وبلوغ النجاة؟ وكيف نثبت ذلك ونقيم عليه الدليل والحجّة؟ هذا أمر لا أظنُّ سيستَهْوِنه مسلم ارتبط مصيره بيوم فيه حسابٌ ثمَّ ثواب أو عقاب، ولا أظنُّ إنساناً صدَّق باليوم الآخر ولا يرجو فيه النجاة والسلامة، فالتحقيق والبحث هو السبيل إلى بلوغ هذه الغاية والحصول على النجاة المطلوبة.
وما يجدر الإشارة إليه أنَّ الذين يُفجَعون بالمصير السيّء والنهاية المشؤومة في تلك الحياة الأُخرى هم الذين سكنت نفوسهم للموروث من العقائد; ظنّاً منهم أنَّه الحقّ، وتلذّذت أنفسهم بنشوة الغفلة وهدأة النفس لها، ولِما أصابوه من هذه الحياة.
وهؤلاء إمَّا أنّهم قد أطلقوا للنفس زمامها وحبلها على غاربها بالتهاون والتساهل في أمر الدين ونسيان الحياة الآخرة وعدم مراعاة أمرها بتصحيح اعتقاد أو أداء تكليف، أو أنّهم ركنوا إلى الأوهام في اعتقادهم وغاصوا في بحار التوهّم بحثاً عن اللؤلؤ، دون أن يتفطّنوا إلى أنَّ اعتقاداً كهذا لا وجود له حتّى يأتي باللؤلؤ النفيس، فليس الوهم إلاّ عدم محضّ لا يوجد إلاّ في الخيال.
أو أنّ هؤلاء قد استلْقَوا في أحضان الظنِّ في أمر العقيدة. وذاقوا بهذا يسيراً من مذاق الحقيقة بعد اختلاطها بقدر جمٍّ من الباطل، وهم في غمرة هذا المذاق الحلو الذي يتلمّظونه بين كَمٍّ من المرارة ركنوا لمذاق الباطل الذي خلطوه به ظنّاً منهم أنَّ للحقِّ مذاقاً كهذا إذ أنَّهم خلطوا عملا صالحاً بآخَر سيّئاً (إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْـاً) (النجم: ۲۸).
والذين يمحِّصون اعتقادهم الديني ليبلغ حدّ اليقين أو قدراً من اليقين تَضعُف نسبة الشكّ والظنّ فيه بصورة تجعل مقدار الشكّ لا يؤدّي وجوده إلى زوال الطمأنينة في الاعتقاد، فهؤلاء أقرب من غيرهم إلى النهج الذي رسمه النبيّ الأكرم(صلى الله عليه وآله) لكي يسير عليه الناس، بل هؤلاء لا يعجزون عن التماس الأدلّة والحجج القويّة على اعتقادهم هذا من حيث موافقته لآيات القرآن وأحاديث النبيّ(صلى الله عليه وآله)ومسلّمات العقل وفطريّاته، فهم في حقيقة الأمر يأنسون، في اعتقادهم الممحّص هذا، إلى التفسير السليم لنقاط الخلاف بينهم وبين الفرق الأُخرى، تفسيراً يخلو من التكلّف الذي لا يُرتضى أبداً في مثل هذه المواقف، بل يقفون على اعتاب التفسير الحكيم لهذه النقاط الخلافيّة دون أن تتلجلج النفوس الحرَّة في قبوله ودون أن يخالفه القرآن أو الحديث أو مقتضيات العقل المتوازنة، فهكذا يجب أن يكون الاعتقاد في المسائل الدينيّة الأصليّة، ولا يتأتى ذلك إلاّ ببذل الهِمَم في البحث والتحقيق والتنائي عن العصبية والجاهليّة والتقليد الأعمى”.
متطلبات التحقيق في أمر العقيدة:
يقول الأخ طارق حول شروط البحث في الأمور العقائدية:
“إنّ مَن حَزَم الأمر على التحقيق والبحث في اعتقاده فهو لا يستطيع إحراز شيء من تحقيقه إن كان مفعماً بالتعصّب والتقليد اللذين لا يتيحان الفرصة للتحقيق الحرِّ، فلابدَّ له لكي يكون حرّ الحركة والتفكير أن يفرّغ نفسه من كلّ ما يمكن أن يتسبّب في إفساد التحقيق عليه والحيلولة بينه وبين ما يصبو إليه من بحثه، وأن يهيّىء نفسه جيّداً لتقبّل الحقيقة التي يصل إليها، بعد إنجاز التحقيق والاطمئنان إلى سلامته من حيث المنهج السليم والأدلّة المقنعة بلا شكّ; لأنَّ الخوف من خوض التحقيق أو الخوف من تقبّل النتيجة عدوّ المحقّق النزيه، فالنتيجة تحتّم عليه رحابة الصدر لتقبّلها باعتبار أنَّها الحقّ، بل تحتّم عليه الدفاع عنها وعرضها على الآخرين. ومن لا يهدف إلى هذا من تحقيقه وبحثه فعليه ألاّ يشرع في شيء من التحقيق لأنَّه يكون عندئذ مضيعة لوقته، بل يكون عبثاً ولعباً، ولماذا يتحمّل المشاقّ ويقطع الحجّة على نفسه ثمَّ لا يقبل نتيجة بحثه وتحقيقه ولا يدافع عنها؟!”.
الأسباب الموجبة للتحقيق في أمر العقيدة:
يقول الأخ طارق حول الأسباب التي دفعته للبحث والتحقيق في أمر العقيدة:
“لا شكّ أنَّ ما ندين به من عقائد يحتوي على قدر جيِّد من الحقيقة، بل بالنظر إلى وجود القرآن بيننا يجعلنا نتسطيع أن نجزم بأنَّ ما بين أيدينا هو كلّ الحقيقة، ولكنَّ وجود الحقيقة بيننا شيء والعمل على أساس هذه الحقيقة شيء آخر; فالنبيّ(صلى الله عليه وآله) لم يأمر باتّباع القرآن أو العمل به فحسب بل قَرَن به ما قرن، وهذا المقرون بالقرآن ليس فيه حقيقة تنفصل عن القرآن وتخالفه، بل يُبيِّن ما اشتمل عليه القرآن من الحقّ. إذن فالمقرون بالقرآن هذا لا نستطيع أن نقف من دونه على ما جاء به القرآن من الحقّ.
وهذا هو السبب الذي لا نستطيع معه أن نقطع بأنَّ ما ندين به يشتمل بلا ريب على اليقين دون الظنّ، وكثير من الأسباب أدّت إلى عدم القطع هذا فكان دافعاً للتحقيق والبحث، ومن هذه الأسباب:
أوّلا: الفتن والاختلافات الحادّة
إن الفتن والاختلافات التي عصفت بالمجتمعات والأفراد المسلمين، منذ نعومة أظافر الإسلام. وقد بدأت هذه الاختلافات والنبيُّ(صلى الله عليه وآله) لمّا يرتحل من بين الناس آنذاك، فلقد اختلفوا في أهمّ مسألة ترتبط بمصير المسلمين وهم جلوس في حضور نبيّهم(صلى الله عليه وآله)، وهو الاختلاف الذي عُرِف فيما بعد بـ “رزية يوم الخميس”. ولا تخلو من حكايته كتب السِّير والأحاديث. ولا شكّ أنَّ هذا الاختلاف قد ألقى بظلاله على زماننا، وأُحيطت الحقيقة على أثره بقدر من الإبهام أدّى إلى صعوبة التعرّف عليها بعينها، ولا سيّما بعد افتراض عدالة كافة الصحابة الذين كانوا أوّل من أختلف في أُمور الدين، فقد أسدلت هذه العدالة الشاملة ستاراً معتماً على كثير من الأُمور، ومنعت التطرّق إلى البحث والتحقيق فيما وقع بين الصحابة من اختلاف بهدف إدراك الحقيقة، فتهيّب الناس السؤال عمّا حَدَث لمعرفة الحقّ من الباطل. وبسبب هذه العدالة استوى عند المسلمين في هذا العصر الخطأ والصواب! لأنَّ المتخالفين من الصحابة كلّهم مأجورون ومُثابون! فانتشر الإسلام على هذا، يدين الناس بأُمور كثيرة مختلف عليها فيه.
ثانياً: تعدّد الفرق الإسلاميّة
ذلك أنّ اختلافاً كهذا حَدَث بين الرعيل الأوّل ـ ولا سيّما بعد الركون إلى عدالتهم كافّة ـ قد أدّى إلى بروز فرق لا تحصى ولا تعدّ في المجتمع الإسلاميّ. والعجيب أنَّ أعضاء هذه الفرق ـ وهم لا يجوّزون بحث الخلاف بين الصحابة ـ تراهم يبحثون حول ما حدث بينهم أنفسهم من اختلاف، وقد غفلوا عن أنَّ اختلافهم هذا كثير منه معلول الاختلافات الأُولى; فإثبات الحقّ لفرقة وسلبه عن فرقة أُخرى، هو في الواقع نسبة ذلك الحقّ إلى رأي من آراء بعض الصحابة في المسألة المختلف فيها، وسلبه عن الفرقة الأُخرى هو سلب هذا الحقّ عن البعض الآخر منهم في نفس مسألة الاختلاف، وقد طعنوا بذلك في عدالة كافّة الصحابة من مكان بعيد.
ثالثاً: بعد المسافة الزمنيّة بين زماننا وزمان النبيّ(صلى الله عليه وآله)
وهذا من الأسباب القويّة التي تؤدّي بلا شكّ إلى بعث غريزة التحقيق والبحث في أُمور الدين، لأنَّ ما صدر من النبيّ(صلى الله عليه وآله) لابدَّ له أن يطوي كلّ تلك المسافة متنقّلا بين أنواع أفراد البشر والمجموعات المتخالفة التي لا تعتمد إلاّ ما وافق الرأي منها ولا تحتفظ إلاّ بما تراه صواباً.
وهي في تحديدها الصواب من الخطأ تتنازعها أُمور وتتناوشها أشياء; فالنسيان والخطأ والهوى والتقليد والعصبيّة والقبليّة والحقد… كلّ ذلك سيضع آثاره على ما رُوي عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) من كلام، وجب علينا التعبّد به ونحن في هذا العصر البعيد عن زمن الرسالة. فالذين ينقّون ما يمرّ عبرهم من أقوال وأفعال صدرت عن النبيّ(صلى الله عليه وآله).. على أيّ معيار يعتمدون في هذه التنقية؟ ومَن يجرّح غيره ويتّهمه بالنسيان وكثرة الخطأ يجرّحه بأُمور هو نفسه عرضة لها وإن كان ثقة عادلا، هذا فضلا عن الذين شمّروا عن سواعدهم لوضع ما لم يكن عن النبيّ(صلى الله عليه وآله)صدوره ونسبتِه إليه بعد ذلك، وهم أكثر وأشدّ نشاطاً وفعاليّة. وعملهم أسهل وأهون من عمل الإصلاح.
رابعاً: حصار أهل البيت وتكميم أفواههم
لقد كان الخليفة الأوّل وكذلك الخليفة الثاني يرجعان في كثير من الأُمور إلى أهل البيت; فأبو حفص كان مفزعه في أُمور الدين الإمام عليّ (عليه السلام) ، ولهذا صدر منه مراراً قوله: “لولا عليّ لهلك عمر”، وقوله: “اللّهم أعوذ بك من معضلة ليس لها أبو الحسن”، وهكذا كان دأبهما.
وأعلميّة أهل البيت ـ وعلى رأسهم الإمام عليّ (عليه السلام) ـ من الحقائق التي لا مراء فيها ولا جدال، وقد اعترف بذلك أبو بكر وخليفته أبو حفص. واستمرَّ الحال إلى زمان عثمان حيث استولى بنو أُميَّة على مقاليد الأُمور في الدولة الإسلاميَّة، وتصرَّفوا في كلِّ شيء حتّى هيمنوا على السلطة تماماً، فتغيَّر الحال وحورب أهل البيت، وحوصرت أقوالهم، وسُلب حقّهم في المرجعيّة الدينيّة فضلا عن الخلافة. واستمرَّ الحال هكذا إلى آخر يوم في الدولة العبّاسيّة، فنشأ الناس على ترك أهل البيت. ثمَّ إنَّ الحصار في دولة بني أُميِّة لم يقف على إبعاد أهل البيت النبويّ عن المرجعيّة فحسب، بل تعدّى إلى إبرازهم بنحو يؤدّي إلى نفور الناس منهم، ولهذا الغرض استنّوا سبَّ الإمام عليّ (عليه السلام) أكثر من خمسين عاماً.
وضُرِبَ الحصار على من يرجع إليهم في أُمور دينه، وقُتل من لم يطلق لسانه فيهم بالسباب والشتم، وهُيِّئت الفرص لمن يسبّهم ويجافيهم. وأمر معاوية الناس في بقاع الدولة بإبراز محاسن غيرهم في مقابل ما أبرزه النبيّ(صلى الله عليه وآله) من محاسن لهم، ثمَّ قُتّلوا بعد ذلك شرّ تقتيل، فليس منهم إلاّ مسموم أو مقتول.
كتب معاوية نسخة واحدة إلى عمّاله بعد عام الجماعة أن برئت الذمّة ممّن روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيته! فقامت الخطباء في كلّ كورة وعلى كلّ منبر يلعنون عليّاً ويبرؤون منه ويقعون فيه وفي أهل بيته. وكان أشدّ الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة، لكثرة من بها من شيعة عليّ (عليه السلام)(۱).
والسؤال الذي يُطرَح ببراءة: لماذا حارب الأمويّون طيلة حكمهم هذا علماءَ أهل البيت؟ ولأيِّ شيء قتلوهم؟ ولماذا نسج على منوالهم العبّاسيّون؟
وقد يجيب أحد بأنَّهم نافسوهم في الحكم والسلطة.. ولكن، هل كان أهل البيت يعارضون حكم الأمويّين لو كان قائماً على ما جاء به الوحي وقضى به النبيّ(صلى الله عليه وآله)؟! وهل كان من الوحي سبّ الإمام عليّ أو قتل الإمام الحسين بالصورة الوحشيّة التي عرفها التاريخ؟! أو كان من الوحي إطعامهم السمّ الزعاف؟! وهل كان أبناء الرسول يحبّون السلطة من أجل السلطة والحكم؟ وماذا تضرّر العبّاسيّون من عترة النبيّ(صلى الله عليه وآله)حتّى انتهجوا معهم ما انتهجه الأمويّون؟!
إنّ أهل البيت بعد الضربات الأمويَّة لم تبقَ لهم تلك الخطورة السياسية التي تعتمد على قوّة الجيش والسلاح; فقد انفضّ الناس من حولهم إمَّا خوفاً من القتل والسبي، وإمَّا انجذاباً نحو الأصفر والأبيض من أموال السلطة. وصار أهل البيت تحت المراقبة الأمويَّة في منازلهم وبين أهليهم، أو في المحابس وفي سجون الحكومة العبّاسيّة، وهذا يكفي الحكّام لتوطيد حكمهم. إذن.. لماذا القتل؟! وهل كان لأهل البيت كخطر الجيوش والسلاح لا يزول إلاّ بقتلهم؟! وما ذاك الخطر؟! وهل كان السبيل إلى الصلح والتوافق معهم قد أغلق تماماً؟!
لقد كانت المسألة بين الحكّام من الأمويّين والعبّاسيّين، وبين أهل البيت مسألة الدين والشرع، فالحكّام في نظر أهل البيت قد خالفوا الشرع والنهج المحمَّديّ، وأهل البيت في نظر الحكّام خطر دينيّ أساسيّ لا يحتاج إلى جيش وسلاح.
وهذا الإمام الحسين يصوّر حقيقة النزاع بين الحكّام وأهل البيت، يقول الطبريّ: “وقام الحسين في كربلاء مخاطباً أصحابه، فحمد الله وأثنى عليه، ثمَّ قال: أيّها الناس، إنَّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلاّ لِحُرَم الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنّة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول، كان حقّاً على الله أن يُدخله مُدخله. ألاَ وإنَّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد، وعطّلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلّوا حرام الله وحرّموا حلاله، وأنا أحقّ من غيري”(۲).
فإذا كان النبيّ(صلى الله عليه وآله) قد ربّى أبناء الناس على الدين خير تربية، أتراه تاركاً أبناءه على غير تربية الدين؟! لا، بل لهم الأولويَّة في التربية والنشأة على الوحي، وإلاّ فإنّه يكون كالآمر بالبرِّ والناسي لنفسه.
ولمّا كان هدف أهل البيت إقامة الدين وإجراء الشرع الذي تربّوا عليه وهم أولى بذلك، كان الحكّام في زمانهم يهدفون إلى السلطة فحسب، لأنَّ الذي لا يهدف إلى شيء إلاّ أن يرى الدين قائماً، لا يضيره شيء إن قام الدين بغيره من الناس على الوجه المطلوب.
وهكذا حوصر أهل بيت النبوّة من كلّ صوب، ومُنعوا من الكلام في أيّ أمر في مجال الدين سياسيّاً وعباديّاً. فإن كان هذا حال أهل البيت فمَن مِن أتباعهم تكون له جرأة الكلام والتفوّه بما يرضي العترة النبويّة؟! فلو استهان أمر أهل البيت عند الحكّام فلاَمرُ أتباعهم أشدّ هواناً. ومع ذلك ظهر على سطح الساحة الدينية علماء صار حقّ الفُتيا لهم، وارتضاهم الحكّام، وقصدوا إلى فرض ما أفتوا به على الناس ونشره بينهم، فقرّبوهم إليهم وأجزلوا لهم العطاء. فلو كان ما أفتى به هؤلاء يرضي سريرة أهل البيت (عليهم السلام) ويوافق ما هو عليه من أمر، فلماذا لم يترك الحكّام أهل البيت لأن يفتوا أو يقولوا بهذا ما دام لا يضيرهم منه شيء؟! أم أنَّ هؤلاء كانوا أعلم من أهل البيت بأُمور الدين والوحي؟! ولكنَّ أهل البيت لم يكونوا ليقبلوا بالصمت أمام الظلم وجور الحكّام، كما سمعت من كلام الإمام الحسين (عليه السلام) . وأمَّا من قُرِّب من العلماء وارتُضي من قبل الحكّام فلم يكونوا يَرَون ما كان يراه الإمام الحسين وأهل البيت كافّة، ولذا أفتى هؤلاء العلماء بما زعموا أنَّه من رسول الله(صلى الله عليه وآله): “من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهليّة”! وبعد هذا فكيف لا يقبل الحكّام هذه الفتاوى وأصحابها من العلماء؟! وكيف بعد هذا يسمع لأهل البيت فتوى في الدين؟!
ولهذا أُبعد أهل البيت، وقُرِّب من خالفهم من العلماء والناس. واستمرَّ الحال هكذا وطارت فتواهم كلّ مطير وانتشرت في البلاد وسار الناس على مذاهبهم، ولم يلتفت أحد إلى بيت النبوّة ومهبط الوحي، فأخذ الناس الدين عن غيرهم. وها نحن نرى الخلاف بين أتباع المذهب الجعفري من شيعة أهل البيت وبين المذاهب السُّنيّة. أفلا يدعو هذا إلى البحث والتحقيق؟!”.
ومن منطلق البحث والتحقيق وجد الأخ طارق نفسه أمام حقائق لا سبيل لانكارها فاعلن ولاءه لآل محمد والقول بامامتهم والالتحاق بسفينتهم مطمئن البال، مستقر النفس، مرتاح الضمير، لأنّه شعر بعدها أنّه يمتلك عقيدة راسخة وناتجة عن فهم وبحث ودراية.
موقفه ممن خاصمه بعد الاستبصار:
تعرّض الأخ طارق بعد اعلانه الولاء لأهل البيت لجملة من المضايقات من قبل البعض ممن حوله، لكنه لم يعبأ بها ابداً، بل كان يتعجب من اولئك الذين عارضوه وخاصموه بشدّة، فيقول في هذا المجال:
“إن الذي ليس له الشجاعة لتقبّل الحقائق والأدلة المقنعة، ولا يتذوقها إلاّ مرّه، لا يجوز له أن يضايق مَن رضي بالحق وقبل الدليل وتذوّق فيه الطلاوة والحلاوة.
غير أنني لم أغلق الباب أمام من يرى خلاف ما رأيت، ويملك من الأدلة ما لم أملك، على أنّه سيظلّ الباب مفتوحاً له، ما دام ينتهج في حواره قوله تعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُم بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ) (النحل: ۱۲۵) وإلاّ فالباب موصَد”.
مؤلّفاته:
(۱) “دعوة إلى سبيل المؤمنين”:
صدر سنة ۱۴۱۸هـ ـ ۱۹۹۸م عن مؤسسة الطبع التابعة للآستانة الرضوية المقدسة.
جاء في تعريف الكتاب على غلافه الأخير: “لغة الحوار الهادىء مظهر حضاري متقدّم… ومزيّة بينة من مزايا هذا الكتاب; إذ مزج فيه مؤلفه بين عمق الفكرة ووضوحها وبين المحاورة الودودة التي تستهدف التعريف والتبصير من خلال المنطق المرضي والبرهان…”.
إن هذا الكتاب خطوة عسى أن تكون فاعله في ترصيص كيان الأمة الإسلامية من خلال الكلمة المضئية، للوصول إلى المعنى الاعتقادي والتاريخي المشترك الذي يقف على أرضيته مسلمو العالم.
يتألف الكتاب من تمهيد وخمسة فصول وهي:
التمهيد: التحقيق في أمر العقيدة.
الفصل الأول: عدالة الصحابة.
الفصل الثاني: حديث الاقتداء بأبي بكر وعمر.
الفصل الثالث: خلافة أبي بكر الصديق.
الفصل الرابع: أولو الأمر هم أهل البيت.
الفصل الخامس: الخليفة بعد النبي علي(عليهما السلام).
وقفة مع كتابه: “دعوة إلى سبيل المؤمنين”
يدعو الكاتب في كتابه هذا المسلمين إلى التوحد على هدى الرسول الأكرم(صلى الله عليه وآله)وعدم الانشقاق عنه وسلوك سبيل عترته وأهل بيته (عليهم السلام) المؤمنين حقاً بهدى ابيهم الذي لا ينطق عن الهوى، وهم أوائل السائرين على الصراط المستقيم الذين اصطفاهم الله واختارهم أئمة للناس.
ويتناول في كتابه مسألة اختلاف المسلمين في ولي الأمر بعد الرسول(صلى الله عليه وآله)، فيبحث مقدمة في عدالة الصحابة واختلافهم، ثم يتناول خلافة الخليفتين الأول والثاني فيبحث فيها نصوصاً وتاريخاً فيرد ما استدلوا به عليها من اجماع مزعوم وشورى غاب عنها المشيرون، وترشيح أبي بكر للصلاة من قبل ابنته عائشة قرب وفاة النبي(صلى الله عليه وآله).
ثم يواصل بحثه مستدلا بالآيات القرآنية وتفسيرها من قبل كبار أئمة التفسير، وكذلك بالأحاديث النبوية الشريفة التي اتفق عليها المسلمون لمعرفة ولي الأمر الذي تجب طاعته على المسلمين فيجد ان النصوص الشريفة قرآناً وحديثاً قد وضحت ولي الأمر بما لا يقبل اللبس والابهام وهم أهل البيت (عليهم السلام) الذين لم يتلبسوا بظلم أبداً، والذين لا يقاس بهم أحد كما وضحت النصوص المراد بأهل البيت وان حاول البعض التشويش على ذلك عناداً وضلالا.
ثم استعرض النصوص التي تدل ان الخليفة الذي عيّنه الرسول(صلى الله عليه وآله) هو الإمام علي (عليه السلام) الذي اختاره الله ولياً لكل مؤمن والذي اعترف له بذلك من اغتصب حقه في الخلافة في بعض فلتات السنتهم.
ونحن هنا نوضح ـ باختصار ـ ملامح من الفكرة الاساسية للكتاب.
أهمية معرفة ولي الأمر الواجب الطاعة:
يوضّح الكاتب ذلك بالقول:
إنَّ من المسائل التي تفرض علينا التحقيق والبحث حولها باعتبارها من أهم مسائل الدين، هي معرفة وليّ الأمر.
الاعتقاد السائد بين كافّة المسلمين أنَّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) هو خاتم الأنبياء والرسل، أي هو نبيّ لا نبيّ من بعده، وأيّ اعتقاد بخلاف ذلك يستوجب الكفر بلا شكّ. وفرض عدم خاتميّة الرسالة يفرض نبيّاً آخر يأتي بعد محمَّد(صلى الله عليه وآله) لهداية الناس بعد انقضاء فترة الإسلام، ولمّا لم يكن كذلك.. فُهِمَ الإسلام على ضوء ختم الرسالة بأنَّه دين كلّ زمان ومكان، وهذا منطق بلا شكّ يتّفق وختم الرسالة، وعلى هذا تصافق وتوحّد اعتقاد المسلمين باعتباره أمراً قرآنياً مسلَّماً (مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَد مِّن رِّجَالِكُمْ وَ لَـكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَ كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَىْء عَلِيماً) (الأحزاب: ۴۰)، وعلى هذا فإنَّنا نستخلص من هذا الاعتقاد المسائل التالية:
۱ ـ ليس هناك نبيّ يأتي بعد محمَّد(صلى الله عليه وآله)، فهو خاتم وآخر الأنبياء والرسل.
۲ ـ إنَّ الإسلام خاتم الأديان، وهو قد جاء إذاً لكافة الناس إلى يوم القيامة.
۳ ـ ولكي يفي الإسلام بهذه العموميّة لكلّ البشر، وحتّى يفي بمتطلّبات عموم الناس على اختلافهم وتنوّعهم زماناً ومكاناً، لابدَّ أن يكون على درجة من القوّة والكمال حتّى ينهض بالناس دينيّاً واجتماعيّاً وسياسيّاً وخلقيّاً واقتصاديّاً، ولهذا يقول تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الاِْسْلَامَ دِيناً) (المائدة: ۳) والله لا يرضى بما هو ناقص غير مكتمل، كما هو واضح.
بكلِّ هذه الخصائص لابدَّ لهذا الدين أن يشقّ طريقه نحو المجتمعات، ماضيها وحاضرها والناشئة مستقبلا، لإرشاد الناس إلى سبيل المؤمنين، وإبطال كلّ فكر واعتقاد يباعد بينهم وهذه السبيل. فهذه مهمّة لا تنجز منحصرة في عصر واحد، بل تقتضي الحضور الدائم في كلّ عصر، فكما كان النبيّ(صلى الله عليه وآله) هو المتصدّي لهذه المهمّة يكون وليّ الأمر من بعده هو المتكفّل بذلك، وهكذا أُولو الأمر إلى آخرهم.
وأهميّة وليّ الأمر تنحصر في أُمور:
أوّلا: فهو من ناحية أنَّه رئيس وقائد ومدير لشؤون الدولة الإسلامية، فله الأهميّة السياسية بكلّ جوانبها.
ثانياً: ومن ناحية أنَّه المرجع الدينيّ للمسلمين في نواحي الدولة الإسلامية كافّة، فله الأهميّة الدينيّة التي لا تنفصل عن حياة الناس.
ثالثاً: ومن ناحية أنَّه واجب الطاعة فهو يمثّل مسألة من أهمّ مسائل أُصول الدين، إذ أنَّ طاعته أمر إلهيّ تعبّديّ لابدَّ من أدائه، وذلك لقوله تعالى: (أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الاَْمْرِ مِنكُمْ) (النساء: ۵۹)، فهذا أمر مطلق قطعيّ، وواجب يلزم أداؤه لوليّ الأمر.
إذاً، فالأمر الصادر من الله تعالى بإطاعة أُولي الأمر يحتّم علينا التعرّف على وليّ الأمر هذا، لأداء واجب الطاعة له، تنفيذاً لأمر الله تعالى. والطاعة هذه تكون لوليّ الأمر في كلّ ما يقول ويأمر به وينهى عنه، فمخالفته في شيء بعد تعيينه معصيةٌ صريحة، ومخالفته في أمر بسبب الجهل به ليس فيه عذر، لأنَّ تصريح القرآن بالأمر بطاعته هو إشارة إلى وجوده وتعيينه، وإلاّ يكون تكليفاً فوق الطاقة.
فمن هو وليّ الأمر من بعد النبيّ(صلى الله عليه وآله)؟
الاستخلاف واجب على النبيّ(صلى الله عليه وآله):
إنَّ ما يجعل العقل أسيرة الحيرة والدهشة ما يذكره كثير من علماء المسلمين من عدم تعيين النبيّ(صلى الله عليه وآله) خليفة له من بعده، وإماماً يتولّى أُمور المسلمين في غيابه.
وفي الواقع إنَّ هذا الكلام لا يُنتظر من أُولئك الذين وُصِفوا بالعلم والمعرفة. وأنا أجزم بأنَّ الذين يردّدون هذا الكلام لم يكلِّفوا أنفسهم ولو قليلا من البحث والتحقيق حول مسألة تنصيب الإمام وتعيينه من جانب النبيّ(صلى الله عليه وآله); إذ أنَّهم ركنوا إلى تقليد مَن سبقهم من العلماء، وتعوّدوا على اجترار ما قالوا في هذا الأمر، دون أن يفطنوا إلى أنَّ القول بهذا فيه اتّهام شديد للنبيّ(صلى الله عليه وآله) بتركه الواجب وعدم تبليغ أمر الله بتعيين وليّ الأمر من بعده!
فإنَّه أمرٌ ـ تالله يبعث إلى الدهشة والذهول العقليّ ـ إذ كيف يصرف النبيُّ(صلى الله عليه وآله)النظر عن تعيين خليفته من بعده، وكيف هان عليه هذا الأمر، ولقد ثبت أنَّ النبيّ(صلى الله عليه وآله)حينما نُعِيت إليه نفسه طفق يورد الوصيّة للمسلمين تلو الوصيّة في أُمور شتّى، مُظهراً اهتماماً عظيماً بأمر الدين، ومُبدياً قلقاً بليغاً بحال المسلمين بعد وفاته؟!
لقد حذّر النبيّ(صلى الله عليه وآله) المسلمين من الاختلاف والفتن، ووعظهم غداة ومساءً وهجيراً.. كلَّ ذلك لكي يبيِّن لهم طريق النجاة والسلامة إذا ما أقبلت الاختلافات والفتن كقطع الليل..
فهل كان النبيّ(صلى الله عليه وآله) لا يرى لوليّ الأمر من بعده أثراً في نجاة الناس من هذه الفتن ولمّ الشمل إذا ما حلّت بدارهم الاختلافات؟! أم كان إدراكه(صلى الله عليه وآله) قد قصر ـ وحاشاه ـ عن إدراك هذا الأمر، فأدركه أبو بكر وفهمه عمر ومعاوية؟! وفطن إليه بنو أُميّة وبنو العبّاس؟! وهل الأمر الذي صدر به الوحي موجباً طاعة أُولي الأمر لم يكن النبيّ(صلى الله عليه وآله) يرى أنَّه يوجب عليه تنصيب خليفة ووليّاً لأمر الناس؟! أم كان يرى أنَّ الله يكلّف الناس فوق طاقتهم، فيوقعهم بعد نبيّهم في الاختلاف والتنازع والفتن؟!
لقد ثبت، بما لا يدع مجالا للريب، أنَّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) ما كان يخرج من المدينة لغزوة إلاّ ويعيِّن عليها شخصاً خليفة له ريثما يعود.. فهل كان يرى أهميّة الوالي على المسلمين في غيابه القصير في حياته، ولم يكن يرى له أهميّة في غيابه الطويل بعد وفاته؟!!
فما هذا القول؟! وأيّ عقل سليم يحكم بذلك؟! وأيّ حكمة يمكن لمسها فيه؟! وأيّ مصلحة تعود للمسلمين من فعل كهذا؟! وهل له نتيجة غير الخلاف والنزاع والخصام، كما حدث في سقيفة بني ساعدة… فاضطرّ ذلك العلماءَ للزجِّ بأنفسهم في تبرير لا يُسمن ولا يغني من جوع؟!
عدالة الصحابة واختلافهم:
يتابع الكاتب كلامه ويقول: إنَّ عدالة كلّ الصحابة بقضّهم وقضيضهم لا تصحّ; لانحراف البعض عن سواء السبيل، وارتكاب بعضهم ما حرّم الله تعالى، ولهذا لا يمكن أن يوصي النبيّ(صلى الله عليه وآله)باتّباع أيٍّ كان من الصحابة للنجاة والسلامة من الاختلاف والانحراف; ذلك لأنَّ أمراً كهذا ينسب إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله) ـ بل إلى الوحي ـ فيه تجويز لارتكاب الأخطاء وفتح الطريق إلى النزاع والاختلاف.
إنَّ اختلاف الصحابة فيما بينهم أمر معلوم، وقتل بعضهم بعضاً مسألة تعجّ بها صفحات التاريخ، وانحراف الكثير منهم عن الحقّ تثبته كتب السير والأخبار(۳).
ثمَّ إنَّنا علمنا أنَّه كان في زمان النبيّ(صلى الله عليه وآله) بعض المنافقين، عُلِمت أحوالهم وخصالهم ووضح نفاقهم للمسلمين، ولكن كان هناك أيضاً منافقون لم يُعلم عنهم شيء ولم يُعرف نفاقهم، ولم تنكشف أحوالهم وقد أخبر الله تعالى نبيَّه الكريم بذلك في قوله تعالى: (وَ مِمَّنْ حَوْلَكُم مِّـنَ الاَْعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَاب عَظِيم) (التوبة: ۱۰۱).
ويمكنك أن تتصوّر خطورة الموقف الذي سيؤول إليه مصير الإسلام وهو بلا راع، عرضة لهؤلاء المنافقين المتمرّسين بالنفاق، المبتعدين عن الأنظار والأفكار.
إذا كان المنافق المعروف نفاقه أخطر على المسلمين من الكافر المعروف كفره، فسيكون أُولئك المنافقون الذين لم يكن المسلمون يعرفون عنهم شيئاً أخطر من أُولئك الذين عِرفوا; وذلك لجهل المسلمين بهم، لشدّة خفائهم إذ تمرّسوا بالنفاق ومردوا عليه وأتقنوه.
وعلى هذا الأساس لا يستطيع أحد أن يجرِّدهم عن الصحبة للنبيّ(صلى الله عليه وآله)، بل كيف يجرَّدهم عنها وهو لا يعرفهم؟! بل سيُثني عليهم وسيصفهم بالإخلاص والتوقى بلا ريب، بحكم ما يبدونه من مظهر دينيّ يضمن لهم مقاماً بين الصحابة العدول، وبالتالي سيهبهم بكلّ ارتياح صفة العدالة والوثاقة!!
فكيف نسدّ منافذ الخطر والضلال الصادر من هؤلاء المنافقين في الباطن، المؤمنين العدول في الظاهر؟ ولهذا كلّه فمن المحال الممتنع أن يأمر النبيّ(صلى الله عليه وآله)باتّباع كلّ من هبَّ ودبَّ ممّن كانت له صحبة معه من الناس في زمانه، وهو يعلم أنَّ من بينهم وممّن حولهم منافقين مستورين مَرَدوا على النفاق وصُقِلوا فيه.
إذاً، فالقول بعدالة كافّة الصحابة خطأ فاحش، والأمر باتّباع كافّتهم دون تمييز لهم عن طريق الوحي أمر ينطوي على خطر بليغ يهدّد الإسلام من أساسه، فلا يأمر به النبيّ(صلى الله عليه وآله) بحال من الأحوال.
ولهذا تسقط كلّ الأحاديث التي تجعل من اتّباع كافّة الصحابة وسيلة للنجاة من الاختلافات والابتداع والإحداث في دين الله، كما وضح.
عود على بدء، وبعض النتائج الخطيرة للقول بعدم الاستخلاف:
وبعد ذلك كلّه.. فكيف لم يعيِّن النبيّ(صلى الله عليه وآله) خليفة من بعده ويترك الناس يتناوشهم المنافقون مَن ظَهَر منهم ومَن بَطَن، ويترصّدوهم اليهود والنصارى الحاقد منهم على الإسلام الكامن له؟!!
وكيف يسهل على العقل الساذج القبول بأنَّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) مات بين السَّحْر والنَّحْر ولم يوصِ بشيء؟! وكيف تسكن النفوس إلى القول بأنَّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) لم يستخلف أحداً من بعده، وذهب لا يلوي من حال المسلمين في غيابه على شيء؟!!! إنّ هذا كلام لا يُلتفت إليه; إذ أنَّه تهمة لنبيّ الإسلام(صلى الله عليه وآله).
اتّهموه بأنَّه ترك أُمَّته بلا راع عرضة للاختلاف والنزاع والاقتتال، وهذا فيه اتّهام له(صلى الله عليه وآله) بترك الواجب! اتّهموه بها، وهو(صلى الله عليه وآله) الرحيم بأمّته، الرؤوف بالمؤمنين، الذي يأسى لهم ويحرص على هُداهم، كما قال عنه ربّه تبارك وتعالى: (لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ) (التوبة: ۱۲۸).
كلّ ذلك كان منهم في غفلة تصحيح ما نتج من حوادث السقيفة، فقالوا: لم يوص النبيّ(صلى الله عليه وآله) بشيء، ومن هنا لا يكون عيب في أن يتولَّى الخلافة أيٌّ كان من الناس، حتّى لو كان فاسقاً أو خارجاً عن طاعة الله تعالى.
يقول التفتازاني: “ولا ينعزل الإمام بالفسق، أو بالخروج عن طاعة الله تعالى”!(۴) ويقول الباقلاّنيّ: “لا ينخلع الإمام بفسِقه، وظلمه بغصب الأموال وضرب الأبشار، وتناول النفوس المحرّمة، وتضييع الحقوق، وتعطيل الحدود، ولا يجب الخروج عليه!(۵) ثمّ ذكر: “بل يجب وعظُه وتخويفه، وترك طاعته في شيء ممّا يدعو إليه من معاصي الله”.
وهذا إضراب عجيب من الباقلاني، فلو كان الخروج على الإمام الفاسق غير جائز، فكيف جاز ترك طاعته في بعض المعاصي؟! وهل وجوده على كرسيّ الحكم ـ والحالة هذه ـ لا يُعدّ معصية في ذاته؟ ولماذا بعض المعاصي؟! وكيف جاز تخويفه؟ وكيف يكون تخويفه؟ أوَليس تخويفه هذا خروجاً عليه؟!!
ولو كان في استطاعة الناس تخويفه وترك أوامره في بعض الأحوال بهذه السهولة فَلِمَ لا يعزلونه; أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر، وهو فاسق؟!
ما هذه إلاّ خطرفة سببها تجويز إمامة الفاسق. وللسياسة في ذلك الوقت دور كبير في ظهور هذه الفتاوى وانتشار تلك العقيدة: عقيدة إمامة الفاسق!
لقد ذكرنا أنَّ القول بأنَّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) لم يستخلف أحداً على المسلمين من بعده قول يحمل أخطر الاتّهامات للنبيّ(صلى الله عليه وآله); ذلك لأنَّ أمر الله تعالى بطاعة أُولي الأمر على سبيل من الجزم والقطع، كما هو واضح في قوله تعالى (وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الاَْمْرِ مِنكُمْ) (النساء: ۵۹).. يوضّح أنَّ أُولي الأمر طاعتهم واجبة كطاعة النبيّ(صلى الله عليه وآله). ووجوب طاعة أُولي الأمر توجب على النبيّ(صلى الله عليه وآله) تعيينه، فالقول بأنَّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) لم يستخلف اتهام له(صلى الله عليه وآله) بترك الواجب.
إنَّ العقل يحكم بأنَّ الأمر بطاعة أُولي الأمر وإيجاب طاعتهم إنّما هو على قرار طاعة النبيّ(صلى الله عليه وآله)، ممّا يستوجب تعيينهم من قِبل الله تعالى بوساطة نبيِّه الكريم، ولا يجوز ترك تعيينهم للناس; لأنَّ ذلك ليس في مقدورهم، فمعرفة الناس لأُولي الأمر ـ بدون أن يعرّفهم الوحي لهم ـ يفرض أنَّ الناس قادرون على معرفة من تجب طاعته من البشر، في حين أنَّ الناس ليسوا قادرين على ذلك.
ولو كان الناس في استطاعتهم معرفة من وجبت طاعته من البشر ـ نبيّاً كان أم غيره ـ لما احتاج النبيّ(صلى الله عليه وآله) إلى إبداء المعجزة حتّى يُعجِزَ الناس بأمره ويصدِّقوه فيطيعوه.
فالنبيّ(صلى الله عليه وآله) واجب الطاعة، ولكن اتّهمه الناس بالكذب والسحر والجنون ولم يصدِّقوه، إذاً فالناس لا يقدرون على معرفة أُولي الأمر، ولو تُرك لهم تعيين أُولي الأمر فستنتج المفاسد التالية:
إمَّا أن يولّي الناسُ الفاسق، والله لم يأمر بطاعته، بل إنّه لا يحب الفاسقين.
وإمَّا أن يشتدّ الخلاف عند اختيار وليّ الأمر، وتقع الفتن من الناس; لعصبيّاتهم وقبليّاتهم وغيرها من صفات حبّ الذات. والاختلاف ممنوع، والنزاع يجب إرجاعه إلى الكتاب والسنّة لفضّه.
وأيضاً إنَّ هذا الواجب إن كان الناس مسؤولين عنه فيستلزم التكليف بما لا يطاق; لأنَّهم لا يعرفون أُولي الأمر.
وإن لم يكونوا مسؤولين عنه فيستلزم العبث في أفعال الله ـ تنزّه الله عن ذلك ـ حيث أمَرَ أمْرَ وجوب (كوجوب طاعة الله وطاعة الرسول)، ومع ذلك لا يُسأل عنه هل أُنجز هذا الأمر الواجب أم لا؟
ولهذا فلمّا كان عجز الناس عن معرفة وتعيين أُولي الأمر يؤدّي إلى تولية الفاسق أو وقوع الاختلاف والتناحر حول تعيين وليّ الأمر، أو يكون التكليف بما لا يطاق، أو ينسب العبث إلى الله تعالى في فعله.. اتّضح أنَّ تعيين أُولي الأمر لم يتركه الله لاختيار الناس، بل إنّه مُسْنَد إليه تعالى.
مَن هم أُولو الأمر وماذا يجب لهم:
يقول الله تعالى: (يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الاَْمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَـزَعْتُمْ فِى شَىْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) (النساء: ۵۹).
إنَّك تلحظ في هذه الآية أنَّه أمر فيها بأمر واحد إطاعة ثلاثة: الله تعالى ورسوله وأُولي الأمر، بوساطة فعل الأمر: (أطيعوا)، وذلك في قوله تعالى: (أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الاَْمْرِ مِنكُمْ)، فماذا يمكن أن نفهم من ذلك؟ وماذا أراد الله تعالى بإشراك النبيّ(صلى الله عليه وآله) وأُولي الأمر في أمر واحد بطاعتهما؟ على أنَّ الحال لا يختلف لو فُصل الأمر ولم يُجمع في فعل واحد.
إنَّ إصدار الأمر بطاعة الرسول(صلى الله عليه وآله) وأُولي الأمر بهذه الصورة المشتركة في أمر واحد يؤكّد لنا التساوي بين طاعة الرسول وطاعة أُولي الأمر. فلمّا كانت طاعة الرسول(صلى الله عليه وآله) واجبة قطعاً فطاعة أُولي الأمر واجبة قطعاً أيضاً. والعموم والإطلاق الواضح في الأمر بالطاعة لا يسمح باستثناء طاعة أُولي الأمر وفصلها عن طاعة الرسول(صلى الله عليه وآله) بأيّ حال من الأحوال، أو بأيّ شرط من الشروط.. إذاً، طاعة أُولي الأمر هي من الواجبات في الدين على المؤمنين.
ثمَّ إنَّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) معصوم بلا شكّ، ولو على قول من ينسب إليه العصمة في تبليغ الوحي، فهو معصوم إذاً. وهنا نسأل: ما هي الحكمة في أن يكون النبيّ(صلى الله عليه وآله)معصوماً؟
إنَّ الله تعالى لم يَدَعْ لنبيّ من الأنبياء مسؤوليّة التشريع ولم يسند إليهم تأسيس الأحكام والشرع، فالله تعالى هو الذي يعلم ما ينفع الناس وما يصلحهم، ولهذا فهو الذي له أن يقوم بهذا الأمر الذي لا يقدر عليه غيره، وما على الرسول إلاّ بلاغه بلاغاً لا يخالجه الإبهام.
والله تعالى بإسناد الأمر إلى ذاته العليّة يريد أن يَبلُغ تشريعُه الناس دون أيّ تغيير أو نقص، سواء كان عمداً أو سهواً، ولكنَّ الرسول بشر، والبشريّة مجمع الأخطاء والنسيان، فما هو العمل إذا ما أُنزل عليه أمر الله ليبلّغه كما أُنزل عليه دون تغيير يؤدّي إلى التغيير في طريقة وأُسلوب التبليغ، فضلا عن أن يؤدّي إلى تغيير الهدف والغاية؟
ولهذا عصم الله الأنبياء عن الخطأ عمداً أو سهواً، حتّى لا يَحْدُث ذلك التغيير تبعاً للخطأ. وعلى هذا فكلّ ما يصدر عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) هو الوحي بعينه، من حيث اللفظ والمعنى تارة، ومن حيث المعنى فقط تارة أُخرى. ولهذا فالنبيّ(صلى الله عليه وآله) (وَ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ يُوحَى) (النجم: ۳ ـ ۴).
فإذا ثبت ذلك فالنبيّ(صلى الله عليه وآله) لابدّ أن يدركه الموت يوماً، وسيأخذ بزمام الأمر من بعده أُولو الأمر الذين وجبت طاعتهم على الناس مثله(صلى الله عليه وآله)، وإن كان الوحي لا يتنزّل عليهم لاكتمال نزوله.
إنّ العمل بهذا الوحي ـ طبقاً لعمل النبيّ(صلى الله عليه وآله) به ـ لم ينتهِ، بل هو باق ما بقيّ الزمان والمكان. ونحن نعلم أنَّ حفظ كلام كما قيل دون تغيير هو أسهل بكثير من العمل به وتطبيقه على مسرح الواقع الملموس، حيث المشاكل والمعضلات والمنعطفات الحرِجة.
إذاً، كيف يتسنّى لأُولي الأمر القيام بهذه المهمّة الأصعب بعد النبيّ(صلى الله عليه وآله) دون التعرّض للخطأ، إن لم تكن لهم تلك العصمة التي كان يتمتّع بها النبيّ(صلى الله عليه وآله)؟ وكيف يصل ما أراده الله إلى الناس عبر أُولي الأمر دون خطأ وهم بشر؟ ونحن أوضحنا أنَّ العصمة تحفظ الوحي النازل على النبيّ(صلى الله عليه وآله) دون أن ينحرف عمداً أو سهواً، لفظاً أو عملا، والله لا يسمح بشيء من ذلك الانحراف.
فإن لم يكن أولو الأمر على عصمة النبيّ(صلى الله عليه وآله) وقع ما لم يسمح به الله تعالى، وما لم يُرِده في تبليغ الوحي.
إذاً، وجبت عصمة أُولي الأمر كما وجبت عصمة الرسول(صلى الله عليه وآله). على أنَّ وجوب الطاعة بالجزم والقطع إشارة إلى العصمة; فالعصمة أساس وجوب الطاعة، وبسبب هذه العصمة لا يختلف خطاب الله تعالى للناس ـ إذا قُدِّر أن يخاطبهم مباشرة بتكاليفه وأوامره ـ عن مخاطبته إيّاهم عبر النبيّ(صلى الله عليه وآله) به. والسّرُّ في ذلك هو وصول خطاب الله ذاته إلى الناس بسبب العصمة التي للنبيّ(صلى الله عليه وآله).. وهذا يعني ـ من ثَمَّ ـ أنَّّ فقدانها في أُولي الأمر يؤدّي إلى التغيير بلا ريب، وهو ما لا يريده الله تعالى.
نظر الفخر الرازي:
ينقل الكاتب نظر الفخر الرازي في تفسيره ويناقشه فيقول: يقول الفخر الرازيّ(۶): “إنَّ الله تعالى أمر بطاعة أُولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية. ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابدَّ أن يكون معصوماً عن الخطأ; إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته، فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ، والخطأ لكونه خطأ منهيّ عنه، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، وإنَّه محال.
فثبت أنَّ الله تعالى أمر بطاعة أُولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أنَّ كلّ مَن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً. فثبت قطعاً أنَّ أُولي الأمر المذكورين في الآية لابدَّ أن يكونوا معصومين”.
ثمَّ يدلف الرازيّ إلى تحديد وتعريف أُولي الأمر المعصومين هؤلاء، حسبما يرى ويظنّ، فيقول: “ثمَّ نقول: ذلك المعصوم إمَّا مجموع الأُمَّة، أو بعض الأُمَّة; لأنَّا بيَّنا أنَّ الله تعالى أوجب طاعة أُولي الأمر في هذه الآية قطعاً. وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا عارفين بهم، قادرين على الوصول إليهم، والاستفادة منهم. وإنَّنا نعلم بالضرورة أنَّنا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم…”.
ولقد ذهب الرازي إلى أنَّ أُولي الأمر هم بعض الأُمَّة، يتمثّلون في أهل الحلّ والعقد.
وبسبب بُعد إجماعهم عن الخطأ ـ على ما روي عن النبيّ(صلى الله عليه وآله): “لا تجتمع أمَّتي على الخطأ” ـ تتحقّق بذلك العصمة المطلوبة في أُولي الأمر.
قوله: إنَّ مجموع الأُمَّة ليس هم أُولي الأمر واضح لا يحتاج إلى إثبات. وأمَّا كون أُولي الأمر هم بعض الأُمَّة فأمر نتّفق فيه مع الفخر الرازيّ، غير أنَّ قوله: إنَّ هذا البعض من الأُمَّة ـ أي أُولي الأمر ـ هم أهل الحلّ والعقد قول تكتنفه إشكالات عدّة، تجعل قبوله أمراً مستحيلا.
فأوّلها: إمكانيّة وقوع الإجماع ليست متحقّقة.
ثانيها: مَن يعرّفهم للأُمَّة باعتبارهم أهل الحلّ والعقد؟!
ثالثها: أين نتحصّل على عصمتهم؟! هل في الأفراد منهم أو في هيأتهم الاجتماعيّة؟!
إنَّ إمكانيّة تحقّق وقوع الإجماع من المستحيلات في هذه الأُمَّة، لا سيّما في اختيار القادة والرؤساء، ودونك الواقع يصرّح مؤكّداً ما نقول.
نعم، من المحال أن تجتمع الأُمَّة على الخطأ بأسرها، لكن من المحال أن يتحقّق إجماع الأُمَّة بأسرها، وفرق شاسع بين الحالتين; فلو دعا بعض الأُمَّة إلى الحقّ فلابدَّ أن يوجد من يخالفهم من الناس لأيّ سبب من الأسباب التي لا حصر لها; فالقوميّة، والعصبيّة، والنعرات القبليّة، واختلاف الإدراك ووجهات النظر، والعناد، واللجاج… كلّها منفردة أو مجتمعة تجعل من وقوع الإجماع أمراً لا يُرجى تحقّقه بين الناس.
وإنَّ مسألة الخلافة لهي من المسائل التي كان للأُمَّة أن تجتمع عليها، لو كان للإجماع إمكانيّة الوقوع، مع قلّة المجتمعين في السقيفة، وما كان لهم من الصحبة التي تجعلهم في مصافّ أهل الحلّ والعقد في زمانهم. وعلى رغم ذلك فقد نشب الخلاف واستحال الإجماع، وسُلّت السيوف، وأُخِذ البعض بالقوّة، وأُغري آخرون بالمال.. فكيف للرازيّ أن يحلم بإجماع استحال أن يقع بين صحابة النبيّ(صلى الله عليه وآله) وهم الجيل الأوّل الذي عاصر النبيّ(صلى الله عليه وآله)، ليقع بين الناس في عصره أو ما تلاه من عصور، أو في هذا العصر الذي ازداد فيه تشعّب العقائد وتشتّت الأفكار؟!!
على أنَّ الانقسام المشاهَد في كلّ فرقة من الفرق الإسلاميّة هو تصريح باستحالة تحقّق الإجماع. ولا أرى إمكانيّة وقوع الإجماع بين أهل السنّة فيما بينهم، ولا بين الشيعة بانفرادهم، فضلا أن يقع الإجماع بينهما مجتمعين.
فاجتماع الأُمَّة بأسرها على الخطأ غير ممكن، ولكن لا يمكن أيضاً اجتماعها على الحقّ بأسرها.
إنَّ واقعة صِفّين كانت بين أُمَّة المسلمين، وقد كان الحقّ عند أحد الطرفين بلا شكّ، ولكن لم يجتمع المسلمون عليه كما لم يجتمعوا على ما يقابله من الباطل; فنشبت بينهم الحرب، وقتل بعضهم بعضاً.. فلماذا يتكلّم الفخر الرازيّ بكلام يبعد عن الواقع ويعطي مصداقاً لآية قرآنيّة ليس له وجود؟!
ثمّ كيف يتمّ التعرّف على أنَّ أهل الحلّ والعقد هم هؤلاء؟! فالإشكال الذي أشكل به الفخر الرازي ـ وهو إشكاله بصعوبة التعرّف على الأئمَّة المعصومين، واستحالة الوصول إليهم ـ هو إشكال يرد عليه، إذ كيف يتمّ التعرّف على أهل الحلّ والعقد والوصول إليهم؟! ومن الذي يقدّمهم إلى الأُمَّة بهذه الصفة؟! ونحن ليس لدينا في مجال التعيين إلاّ الإجماع أو الانتخاب والترشيح أو النصّ.
فأمَّا القول بضرورة الإجماع عليهم فنحن به محتاجون إذاً إلى إجماعَيْن: إجماع من الأُمَّة يعرّفنا بأهل الحلّ والعقد، وإجماع آخر يعرّفنا بصواب ما يُصدره أهل الحلّ والعقد من أحكام وأوامر ونواه، بحيث تلتزم الأمّة بما يصدر عنهم. وبهذا تتضاعف المشكلة; لأنَّ العبور من الإجماع الأوّل إلى الإجماع الثاني محال; لعدم إمكانيّة وقوع الإجماع الأوّل.
فالجهد الذي قام به الفخر الرازيّ لإبعاد نفسه عن الاعتراف بالأئمَّة المعصومين على قول الشيعة ـ لا سيّما بعد الاعتراف الموفّق منه بعصمة أُولي الأمر ـ فهو جهد مقدّر ومشكور علميّاً، لكنَّه ناقص ولا يحلّ المشكلة; فقد كان عليه أن يبيِّن لنا معيار وملاك الاتّصاف بأهليّة الحلّ والعقد، وكيفيّة تعريف الأُمَّة بهم، وعلى رغم أنَّ ذلك تترتّب عليه مشكلاته، غير أنَّه يتيح فرصة أطول لمن أراد السفسطة.
أُولو الأمر هم أهل البيت (عليهم السلام) :
يقول الكاتب هنا على ذلك بالقول: إنَّ أولويّة أهل بيت النبيّ(صلى الله عليه وآله) في تولّي أُمور المسلمين، والانفراد بلقب “أُولي الأمر” بعد النبيّ(صلى الله عليه وآله) دون غيرهم من الناس.. لهي أولويّة تأخذ شكلها الطبيعيّ من عبارات الوحي بشقَّيه; فالنبيّ(صلى الله عليه وآله) لم يكن يرى مَن هو أولى منهم بهذا المقام، بل لم يكن يراه لغيرهم أبداً، إذ أنَّنا نلمس ذلك في المقام الذي حفظه النبيّ الكريم لهم. وليس ذلك من حيث الإحساس الأبويّ الخاضع لقوانين النفس البشريّة، وإنَّما هو أمر تلقّاه النبيّ(صلى الله عليه وآله) متنزّلا من مقامات الوحي الإلهيّ، موضّحاً السِّنْخِيّة والشَّبَه الذاتيّ بين أهل البيت النبويّ وبين محمَّد(صلى الله عليه وآله) ذلك لأنّ الأبوّة مهبط لوحي العاطفة التي كثيراً ما تتخطّى الحقّ وتنطق عن الهوى ولهذا فمقام أهل البيت لما كان مرتكزاً على الأمر القرآني بوجوب طاعتهم من حيث إنهم أولو الأمر،ترى الشقّ القرآني يمثل اساساً منيعاً لمقام العترة، وحينماترى وصف السُنّة لعترة النبيّ عليه وعليهم الصلاة والسلام بأنهم الهداة الذين لا يضل من تمسّك بهم تعلم طبيعة هذا المقام الصادرة من جانب الوحي الإلهيّ وعندئذ نعلم السنخية بين العترة ومحمّد النبيّ(صلى الله عليه وآله). وبيان هذا المقام ليس له مسير غير قنوات الوحي الذي ينتظّم كلّ نفس النبيّ(صلى الله عليه وآله)وكلّ حياته بحركاتها وسكناتها، ولهذا كان الاستحقاق للخلق العظيم الذي يبرّىء النبيَّ عليه وآله الصلاة والسلام من نزعات الأبوة البشريّة في بيان مقام العترة. وعلى هذا الأساس فهو مقام لهم من صميم أنوار النبوّة، بل مقام من مقاماتها، صاغه الوحي في عبارات لا تخفى على من له مُسكة من الإدراك وقدر من ملكة التدبّر.
آية المودة:
(قُل لاَّ أَسْـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبَى) (الشورى: ۲۳)، فالأجر لابدَّ أن يكون على قدر نوع العمل، ولذا فمودّة أهل البيت لابدَّ أن تساوق من حيث القدر ما جاء به النبيّ الأكرم من نعمة الإسلام والرحمة التي ما أُرسل إلاّ بها. ولو كان هناك أجر يضاهي ذلك غير مودّة أهل البيت يمكن أن يكافأ به النبيّ(صلى الله عليه وآله) لكان هو الأجر.. وهذا أمر لو تدبّرنا عظيم.
إنَّ هذا الأجر أدناه تسليم زمام الأمر في قيادة المسلمين وإدارة شؤونهم بعد النبيّ الأكرم لأهل بيته الذين ساوت مودّتهم ـ من حيث إنَّها الأجر ـ نعمةَ الدين الإسلاميّ من حيث إنَّه مأجور عليه بهذه المودة.
وهذا التساوي يبيِّن السِّنخية والشَّبَه القويّ بين النبيّ(صلى الله عليه وآله) وهذا الدين الذي هو خلق النبيّ المعصوم وطريقة حياته(صلى الله عليه وآله) من ناحية… والشَّبَه القويّ بين العترة الطاهرة والنبيّ(صلى الله عليه وآله) من ناحية أُخرى.
ووجه الشبه بين العترة والنبيّ الأكرم هو تلك المودّة، من حيث إنَّها واجبة في حقّ العترة، ومن حيث إنَّها الأجر الذي استحقّه النبيّ(صلى الله عليه وآله) مقابل ما جاء به للناس من هداية ورحمة.. فمودّة العترة كأجر ترضي النبيّ(صلى الله عليه وآله) بلا ريب، فهي في حقيقة الأمر مودّة للنبيّ نفسه، فتدبّر.
ولكن، هل تصحّ هذه المودّة مع المخالفة للنبيّ في نهجه؟ وهل يمكن تصورّها مع مشاقّة النبيّ(صلى الله عليه وآله)؟!
أبداً. فلا يستطيع أحد ادّعاء مودّة النبيّ(صلى الله عليه وآله) وهو مخالف له. فهذه المودّة لا تستقيم إلاّ باتّباع النبيّ(صلى الله عليه وآله)، ولمّا كانت مودّة النبيّ(صلى الله عليه وآله) هي في عترته.. فما هو أنسب أُسلوب للمودّة يمكن أن يُحفظ به النبيّ(صلى الله عليه وآله) في عترته؟! أليس هو الاتّباع للعترة والاقتداء بهم؟
أجل، إنّ مودّة النبي(صلى الله عليه وآله) في أهل بيته (عليهم السلام) لا تعني إلاّ اتّباع النبيّ الكريم باتّباع أهل البيت من عترته، لأنَّ هذا هو الذي يرضي النبيّ(صلى الله عليه وآله) ويُسرّه لا غير.
ولو كان ودّهم يعني المحبّة دون الاتّباع فهذا لا يختصّ بأهل بيت النبيّ وحدهم، وإنَّما هو أمر مطلوب بين عامّة المؤمنين الذين هم في توادّهم وتراحمهم كالجسد الواحد..
إذاً، فلا يختصّ أهل البيت بذلك، ولكن إضافة إلى هذا المعنى الشامل لكلّ المؤمنين يتوفّر معنى آخر يتميّز به ودّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) عمّا سواه من ودّ بين المسلمين، وهو الاقتداء والاتّباع بلا ريب، كما كان حبّ الله هو اتّباع النبيّ(صلى الله عليه وآله); إذ ليس لحبّ الله معنى إذا قُرِن بمخالفة النبيّ(صلى الله عليه وآله) (قُل إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) (آل عمران: ۳۱).. فحبّ الله يستلزم اتّباع النبيّ(صلى الله عليه وآله)الذي هو سبب حبّ الله للتابعين، وهو رحمته.
إنَّ الهدف الأساسيّ والدائم للقرآن هو تهيئة وسائل وسبل الهداية والنجاة للناس بحكم أنَّه رحمة جاءت للناس عبر النبيّ(صلى الله عليه وآله) الذي ما أُرسل إلاّ رحمة بهذا القرآن. ولا يمكن أن يحدّد الله الأجر للناس مقابل هذا الدين وتلك الرحمة، ويكون هذا الأجر متضمّناً للشقاء! فهذا الأجر الذي هو مودّة العترة أحد قنوات هذه الرحمة الإلهيّة. كما لا يمكن أن تتحقّق هذه الرحمة مع المخالفة.. إذاً، لكي تنتقل الرحمة أيضاً عبر هذا الأجر ـ أي مودّة أهل بيت النبيّ(صلى الله عليه وآله) ـ لابدَّ أن تعني تلك المودة الاتّباع والاقتداء. وبهذا يتحقّق الهدف الأساسيّ للدين، وهو هداية الناس وإرشادهم لما هو خير لهم وأبقى; لأنَّ المخالفة عمداً أو تساهلا تبعد المخالف عن قنوات الرحمة تلك.
ولهذا، لا يستقيم ودّهم وحبّهم مع مخالفتهم في أمر أو نهج; لأنَّ في هذا إيذاءهم وإيلامهم بلا شكّ. ولا يلتئم ودادهم ووداد من صَدَر منه إيذاؤهم وإيلامهم ووداد من كانت منه شكواهم.
ولهذا كانت مودّة أهل البيت أعظم أجر يتلقّاه النبيّ(صلى الله عليه وآله) من أُمَّته.. لماذا؟
لأنَّ النبيّ الأكرم ـ الذي هو عزيز عليه ما عَنِتَ المؤمنون، حريص عليهم في هدايتهم، رؤوف بالمؤمنين رحيم ـ لا يسرّه شيء مثل أن يرى أُمَّته في نجاة وسلامة في أمن من عذاب يوم عظيم. ولذا كان اتّباع الناس لأهل بيته في دينهم أجراً يتحقّق به رضاه وسروره لما سيجده الناس من نجاة وسلامة.
آية الانذار وحديث الدار:
النبيّ(صلى الله عليه وآله) وأهل بيته الكرام هم حملة هذا الدين، وهم العارفون به، والرافعون عنه ضلالات المضلِّين وأخطاء الجاهلين، وأحقاد الحاقدين، ونفاق المنافقين. وليس هذا مختصّاً بزمان دون زمان، أو مكان دون مكان، وإنَّما هذه مهمّة ومسؤوليّة كانت على عاتقهم منذ أن أنزل الله تعالى قوله (وَ أَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الاَْقْرَبِينَ ) (الشعراء: ۲۱۴) فأراد الله بذلك إعدادهم لتلك المسؤولية التي انحصر القيام بها فيهم; استمراراً لمنهاج النبيّ(صلى الله عليه وآله).
ثمَّ إنَّ هذه المسؤوليّة نالها أهل البيت في مقابل الالتزام الذي تأسّس يوم عَرَض النبيّ(صلى الله عليه وآله) هذا الدينَ على عشيرته الأقربين، طالباً منهم العون والمؤازرة في مسؤوليّة القيام بتبليغه، على أن تكون لمن يلتزم المؤازرةَ والمناصرة الخلافةُ والولاية على الناس من بعد النبيّ(صلى الله عليه وآله). فالتزم الإمام عليّ (عليه السلام) بذلك مؤسّساً بالتزامه هذا مسؤوليّة عترة النبيّ الكريم الذين نشأوا وتربّوا عليها أحسن تربيّة وأفضل تنشئة في كنف النبيّ(صلى الله عليه وآله)، يَرْفع إليهم كلّ يوم عِلْماً; إعداداً لهم واختصاصاً بهذا المقام، باعتباره ثواباً وأجراً لما التزم به عليّ (عليه السلام) ، مؤسّساً بذلك المقامَ والمسؤوليّة الطبيعيّة لذرّيّته من أبناء الرسول(صلى الله عليه وآله).
قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) بعد أن جمع إليه أربعين نفراً من قريش من بني عبدالمطّلب: “.. يا بني عبدالمطلب، إنّي واللهِ ما أعلمُ شابّاً في العرب جاء قومه بأفضل ممّا جئتكم به، جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، فأيُّكم يُؤازرني على أمري هذا، على أن يكون أخي ووصيّي وخليفتي من بعدي؟
فقام عليّ (عليه السلام) ، فقال: “أنا يا نبيّ الله، أكون وزيرك عليه.
فأخذ رسول الله برقَبته; وقال: إنَّ هذا أخي ووصيّي، وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا..”(۷).
إذاً، فهذه الأولويّة في تولّي أمر المسلمين بعد النبيّ الأكرم أمر ثابت للعترة، ولا يجوز لأحد أن ينافسهم فيه وينازعهم. والقبول بهذا الالتزام لنيل هذا المقام هو إشارة واضحة إلى الإيمان والتصديق بنبوّة محمّد(صلى الله عليه وآله).. فنالت ذلك العترةُ بالإيمان المبكّر الذي شعَّ في قلب سيِّدها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وهكذا ظلَّ الأمر فيهم إيماناً خالصاً لم تخالطه شوائب الشِّرك أو نزعات الشكّ التي أصابت البعض قبل إسلامهم وبعده.
آية المباهلة:
ثمَّ إنَّه لما حانت لحظة من لحظات الدفاع عن هذا الدين أمام افتراءات نصارى نجران، لم يستنفر الله تعالى لهذه المهمّة العظيمة غير النبيّ(صلى الله عليه وآله) وأهل بيته الأكارم.
فهؤلاء نصارى نجران يُحاجُّون النبيّ الكريم من بعدما جاءه من العلم في أمر عيسى (عليه السلام) ، فيأمره الله تعالى بمباهلتهم، ولكن بعد أن يدعو أهل بيته إذ أنَّهم شركاء في الأمر، فقال له تعالى:
(فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنم بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ) (آل عمران: ۶۱).
إنَّ هذا الأُسلوب في الدفاع عن الدين والذبّ عنه ليس في مقدور أيّ فرد من الناس; ذلك لأنَّه ليس فيه سلاح سوى سلاح الإيمان واليقين الصادق بما نزل به الوحي، بل ليس إيماناً مسبوقاً بالشرك أن يمكن أن يخالجه شكّ مِن بعد. وإنَّ الدفاع عن هذا الدين بالسيف هو دفاع لا شكّ فيه، ولكن قد يكون المدافع لا يملك إلاّ سيفه وشجاعته وحميّته، أو قد لا يملك إلاّ الرغبة في الغنائم ومكتسبات الحرب..
أمَّا الوقوف أمام النصارى، ودعوتهم إلى التوجّه إلى الله تعالى بالمباهلة ـ لتحديد الكاذب من الصادق في أمر الدين ـ فهو أمر يستوجب يقيناً بهذا الدين وربّه، لا يشوبه شيء. ولمّا كان الله تعالى لا يمكن أن يختار لهذا الأمر شخصاً شابَ إيمانَه شكٌّ وريب أو نقص وضعف.. كان إيمان العترة في أوج كماله وتمامه، فانتدبهم الله تعالى للذبِّ عن الدين بهذا السلاح الإيمانيّ التصديقيّ. فدعا الحسنَ والحسين، لقوله “أبناءنا”، ودعا فاطمة لقوله “نساءنا”، ودعا عليّاً وجاء بنفسه لقوله “أنفسنا”، إذ قصد من قوله “أنفسَنا” محمَّداً وعلياً في آن واحد، وهو يوضّح أنَّهما من نفس واحدة.
وبهذا يؤكِّد الوحي تقدّم أهل البيت في القيام بمسؤوليّة هذا الدين. ولازم ذلك عدم أهليّة غيرهم لهذه المسؤوليّة في هذا المقام المتقدّم بالذات، أي مقام أُولي الأمر. فالعامل في السفينة ليست له مهمّة الربّان فيها، وليس هو أهل لقيادتها. وإن حَذَق في وظيفته. وإنَّما هو أهلٌ لما هو فيه من وظيفة ومسؤوليّة تُدار من مقام الربّانيّة.
حديث الثقلين:
ونسبة لهذه الأولويّة في مقام القدوة والاقتداء، في جميع مناحي الحياة بلا استثناء، قال النبيّ(صلى الله عليه وآله) محذِّراً: “إنِّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلُّوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فلا تَقَدَّموهم فتهلكوا، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلّموهم فإنَّهم أعلم منكم”.
ويقول ابن حجر: “وفي قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصّروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلّموهم فإنَّهم أعلم منكم.. دليل على أنَّ من تأهّل منهم للمراتب العليّة والوظائف الدينيّة كان مقدّماً على غيره”.
على أنَّ قوله(صلى الله عليه وآله): “ولا تعلّموهم فإنَّهم أعلم منكم” إشارة إلى أعلميّتهم الأزليّة، وبالتالي تقدّمهم الأزليّ على غيرهم.. فلا يُنتظَر أن يتحقّق لهم هذا التقدّم لاحقاً ثمَّ به يتقدّمون على غيرهم فيما بعد.
وبعد هذا كلّه.. كيف يمكن أن يتقدّم أبو بكر وعمر على باب مدينة علم الرسول(صلى الله عليه وآله)؟! أو كيف يتأتّى لمعاوية أن يفوق الإمامَ الحسن (عليه السلام) في علمه؟! أو يبذّ ابنُه يزيد السكّير الإمامَ الحسين (عليه السلام) علماً ومعرفة؟!
فكيف تقدّم هؤلاء على العلماء من عترة النبيّ سيِّد الأنبياء، والنبيُّ يناديهم في أُخراهم: “واجعلوا أهل بيتي منكم مكان الرأس من الجسد، ومكان العين من الرأس، ولا يهتدي الرأس إلاّ بالعينين”؟!
فواعجبي من القوم! فبعد هذا كلّه تقدّموهم وجعلوهم في سوقة الرعيّة، لا يؤتمّ بهم في دين، ولا يُقتدى بهم في عبادة!! وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.
إنَّ أهل البيت هم أُولو الأمر بلا مراء ولا جدال. إنَّه أمر حكم به النقل والعقل، ويحكم به العقل لو فُقد النقل. ولكن لو تُرك النقل وفُقد العقل حَكم لغيرهم الجهل.. وعندها لات ساعة مندم!
وهكذا يكون الكاتب قد وفق في عرض دعوته إلى المؤمنين باستدلال متين واسلوب قوي لا يترك للمراء مجالا، وللفرار من الحق فرصة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(۱) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ۱۱ / ۴۴، الباب ۲۳٫
(۲) تاريخ الطبري: ۴ / ۳۰۴، حوادث سنة إحدى وستّين.
(۳) شرح المقاصد للتفتازاني: ۵ / ۳۰۲٫
(۴) شرح العقائد النسفيّة: ۱۸۵ ـ ۱۸۶٫
(۵) التمهيد للقاضي الباقلاّنيّ: ۱۸۱٫
(۶) تفسير الإمام الرازي: ۱۰ / ۱۴۴٫
(۷) تاريخ الطبري: ۲ / ۲۱۷، الكامل في التاريخ: ۲ / ۲۲، السيرة الحلبيّة: ۱ / ۳۸۱٫
المصدر: مركز الأبحاث العقائدية