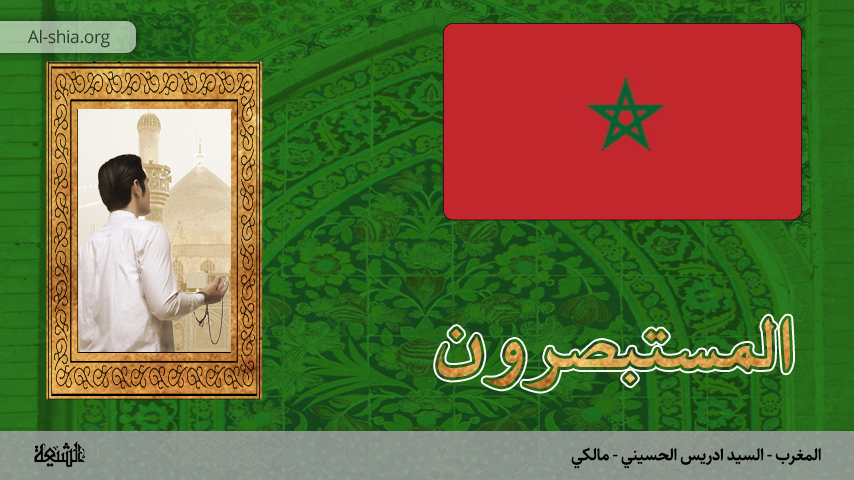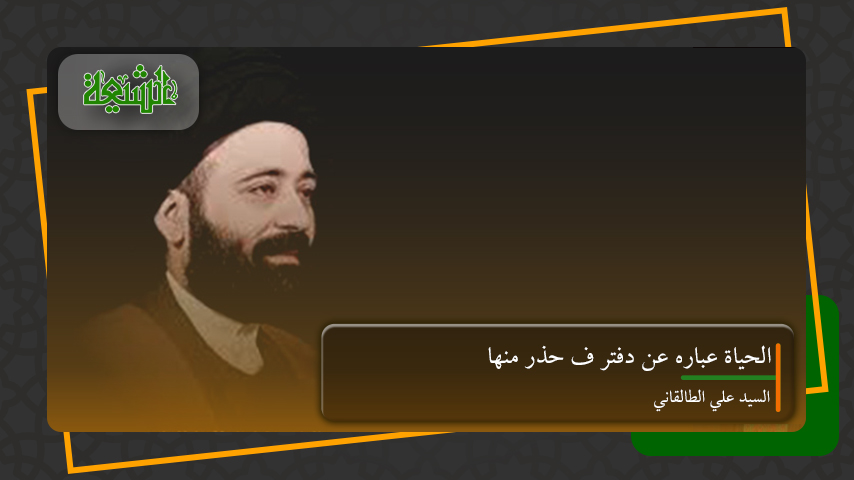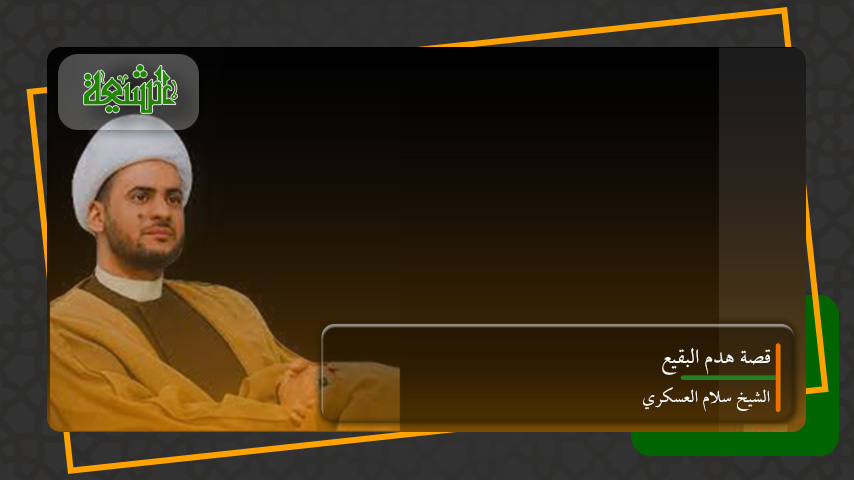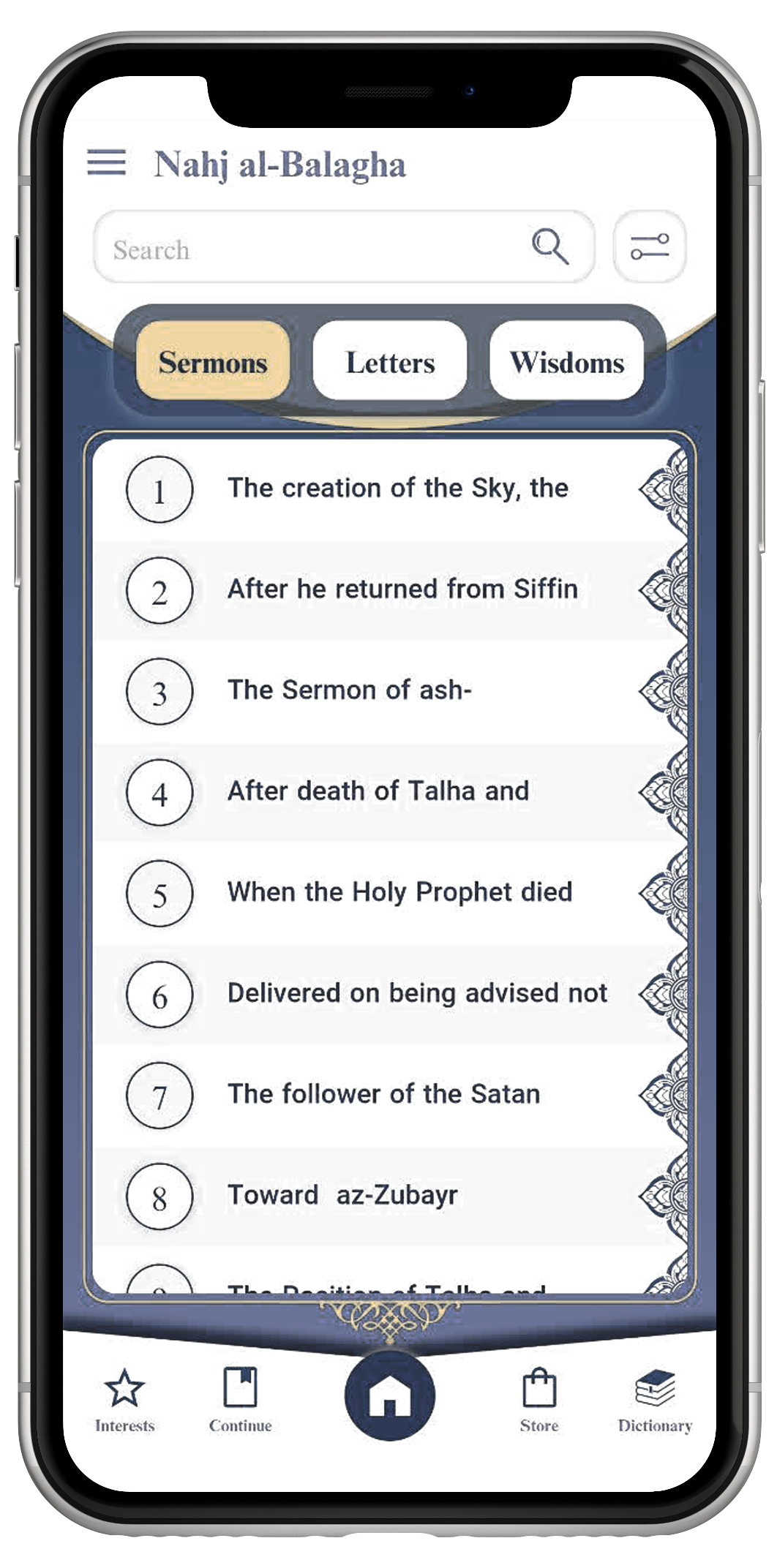المولد والنشأة
ولد عام ۱۹۶۷م بمدينة “مولاى إدريس” المغربية، وترعرع في مدن المغرب: القصر الكبير، مكناس، الرباط، وذلك نتيجة الظروف التي كانت تحددها وظيفة والده في وزارة الفلاحة.
الأجواء التي ترعرع فيها:
نشأ السيد إدريس في أوساط عائلية وبيئة اجتماعية منحته منذ البداية الثقة بالنفس والعقلية المنفتحة والواعية نتيجة هيمنة قانون حرية الرأي وحرية الفكر فيها، فكان متحرّراً من كل فكر عقائدي في بيئته ولم يواجه أي لون من ألوان الأزمة في الحرية.
فيقول السيد إدريس في هذا المجال: “إنني لم أنشأ في أسرة تضرب أبناءها اطلاقاً، لأنّ المغاربة لا يعرفون كيف يضربون أبناءهم. وهذه الحرية العقائدية في بيتي ساعدتني على أن أدخل في معترك الاختيارات الفكرية دون مسبقات”.
كما أنّ دولة المغرب بشكل عام كما يصفها السيد إدريس بلد يتمتع بمجتمع مدني، وفيه أن تختار فكراً لا يعني أن المسألة أصبح لها مدلولا طائفياً، كما هو الوضع في بلدان أخرى، بل الكل حرّ في أن يختار طريقته دون أن يذهب به ذلك إلى الاخلال بالأمن العام.
وفي هكذا أجواء ترعرع السيد إدريس متسماً بالعقلية المتفتحة والناقدة، فنمى لديه طموح البحث في الفكر الانساني عموماً والفكر الاسلامي على وجه الخصوص، وهذا هو الطموح الذي ظل يراوده منذ الصبا والذي دفعه ليجتاز كل العقبات التي اعترته من أجل تحققه.
بداية الرحلة الجادة في البحث:
أدرك السيد إدريس في بداية توجهه للبحث أن ليس ثمة شيء في الدين إلاّ وله علاقة بالتاريخ، وأنّ ما تملكه اليوم الأمة الإسلامية من عقائد وأحكام وثقافات كلّها جاءت عن طريق الرواية، فلهذا ينبغي أن يكون التاريخ هو أحد المصادر العلمية المهمة. فتوجه السيد إدريس إلى الأبحاث التاريخية بصورة موضوعية ومن دون تحيّز أو تعصّب لاتجاه معين.
مرحلة اجتياز العقبات:
أول عقبة واجهها السيد إدريس في مسيرته تحذير بعض العلماء له من البحث في القضايا التاريخية القديمة، محتجين لذلك بأن هذا الأمر باعث على الفتنة وأنه يورث الباحث شبهات توجب تزلزل بنيته العقائدية.
لكن السيد إدريس سرعان ما تمكّن من اجتياز هذه العقبة، فلم يتقبل هذه الفكرة فيقول في هذا المجال: “لقد تحوّل البحث عن الحقيقة، فتنة في قاموس هذا الصنف من الناس، وكأنّهم يرون البقاء على التمزق الباطني، حيث تتشوش الحقيقة وتغيب، أفضل من الافصاح عن الحق الذي من أجله أنزل الوحي، وكأن مهمة الدين هو أن يأتى بالغموض، وكأن الله عزّوجلّ أراد أن يبلبل الحقائق”.
وكانت العقبة التالية أمامه هي قداسة بعض الشخصيات، لكن بعد عزمه على معرفة الحق أدرك أن الحقيقة أغلى وأنفس من الرجال دون استثناء، وأنّه لابدّ أن يوطن نفسه ويهيئها للطوارىء في معترك التنقيب عن الحقائق الضائعة. فلهذا لم يفسح المجال لأي قداسة مزعومة أن تجمّد فكره في مجال البحث عن الحقيقة.
وبهذه العقلية خاض السيد إدريس غمار البحث، واستغرقت رحلة بحثه فترة طويلة عاشها بين أنقاض التاريخ المدفون.
ويقول السيد إدريس: “لقد قمت بكل ما يمكن أن يفعله باحث عن الحقيقة، ومصرّ على المضي في دربها المضني والوعر”.
بداية تعرفه على التشيع:
يقول السيد إدريس: “وقع بيدي كتابان يتحدّثان عن فاجعة كربلاء وسيرة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) ، وكنت لأوّل مرّة أجد كتاباً يحمل لهجة من نوع خاص مناقضه تماماً لتلك الكتب التي عكفت على قراءتها، لم أكن أعرف أنّ صاحب الكتاب رجل شيعي، لأنني ما كنت أتصوّر أنّ الشيعة مسلمون!
فكانت تختلط عندي المسألة الشيعية بالمسألة البوذية أو السيخية!!”.
ومن هنا تفتحت ذهنية السيد إدريس فتعرف على بعض أفكار ورؤى التشيع فتبادر إلى ذهنه: لماذا هؤلاء شيعة ونحن سنة.
ويقول السيد إدريس: “تحوّل هذا السؤال في ذهني إلى شبح، يطاردني في كل مكان، فتجاهلت الأمر في البداية وتناسيته حتى اخفف عن نفسي مضاضة البحث، بيد أن ثقل البحث كان أخف عليّ من ثقل السؤال وأقل ضغطاً من الحيرة والشك المريب”.
ومن هذا المنطلق قرّر السيد إدريس ولأجل التخلص من هذا الضغط النفسي أن يزوّد فكره بالجديد حتى يحسم مسلماته الموروثة، لأنه أدرك عدم قيمة أفكار تتراكم في ذهنه من دون أن تبلور عنده أساس عقائدي متين.
فلهذا قرّر السيد إدريس أن يتوجه إلى معرفة الفكر الشيعي من أجل الالمام بالفوارق بينه وبين الفكر السني.
ثمار الانغماس في التراث الشيعي:
لم تمض فترة قصيرة من دراسة السيد إدريس للتراث الشيعي إلاّ وأدرك أموراً خطيرة قلبت عنده الموازين، وكان منها وعيه بأن الوضع السني لا يجد حرجاً في أن يملي على اتباعه صورة مشوّهة عن معارضيه وأنّه لا يستحي من الله ولا من التاريخ في تغذيته نزعة التجهيل والتمويه لمنتميه.
ويقول السيد إدريس: “وفجأة وجدت نفسي مخدوعاً”.
وانتفض ضميره قائلا: “لماذا هؤلاء لا يكشفون الحقائق للناس، كما هي في الواقع؟ لماذا يتعمّدون ابقاءنا على وعينا السخيف”.
فقرّر السيد إدريس أن يبحث عن الحق الضائع في منعطفات التاريخ الإسلامي، وكان من أكبر الأحداث التاريخية التي تركت الأثر العميق في وجدانه هي فاجعة الطف الدامية، ومنها عرف أنّ هذا الظلم الذي يشكو منه اليوم ليس جديداً على الأمة، وأن الظالمين اليوم يسلكون طريقاً أسسه رجالات كانوا يشكّلون حجر عثرة أمام مسيرة الأئمة من آل البيت (عليهم السلام) .
عقبة أحقية الأكثرية:
يقول السيد إدريس: “كنت كلما طرحت سؤالا على نفسي، رأيت شيطاناً يعتريني ويقول لي: دع عنك هذا السؤال، فهل أنت أعظم من ملايين المسلمين الذين وجدوا قبلك، وهل أنت أعلم من هؤلاء الموجودين حتى تحسم في هذه المسألة” ويضيف: “كنت أعلم أنّ هؤلاء الملايين لم يطرحوا هذا السؤال على أنفسهم بهذه القوّة والإلحاح”.
وعلى كل حال لم تكن هذه الاعتراضات بذلك المستوى الذي تردع السيد إدريس عن اندفاعه إلى كشف الحجاب عن الحقيقة المستورة.
ولقد حزّ في نفسه هذه الكثرة الغالبة، حيث أنها كبرت في عينه وصعب عليه مخالفتها، بيد أن شيئاً واحداً جعله ينتصر عليها وذلك بايمانه بأنّ الأكثرية فقط لا يمكنها أن تمثل الحقيقة، ولا يسع في البحث الموضوعي عدّ الأكثرية ملاكاً لمعرفة الحق، وهذا ما جعله يتمكن من الصمود أمام الأمواج البشرية الهائلة التي ليس لها منطق في عالم الحقائق سوى كثرتها.
ويقول السيد إدريس: “كنت أطرح دائماً على أصدقائي قضية الحسين [ (عليه السلام) ] المظلوم، وآل البيت (عليهم السلام) … فأنا ضمآن إلى تفسير شاف لهذه المآسي… كيف يستطيع هؤلاء السلف “الصالح” أن يقتلوا آل البيت (عليهم السلام) تقتيلا! لكن أصحابي، ضاقوا مني وعزّ عليهم أن يروا فكري يسير حيث لا تشتهي سفينة الجماعة”.
ويضيف السيد إدريس: “من هنا بدأت قصة ـ الحركة نحو الاستبصار ـ وجدت نفسي أمام موجة عارمة من التساؤلات التي جعلتني حتماً أقف على قاعدة اعتقادية صلبة. أنني لست من أولئك الذين يحبون أن يخدعوا أو أن ينوّموا، لا، أبداً، لا أرتاح حتى أجدد منطلقاتي، وأعالج مسلماتي، فلتقف حركتي في المواقف، ما دامت حركتي في الفكر صائبة”.
ومن هنا شدّ السيد إدريس عزمه لمواصلة طريق البحث مهما كانت النتائج، كما أنّه أدرك بأن هذا الطريق وعر، تتجلى فيه أقوى معاني التضحية، وفيه يكون الاستقرار والهناء بدعاً. لأنّ أئمة هذا الطريق ما ارتاح لهم بال ولا قرّ لهم جنان، حتى يُتّموا، وذبحوا، وحوربوا عبر الأجيال!
فأدرك السيد إدريس مدى قيمة الحقيقة في حسبان الباحثين عنها، وأدرك مدى الجهد الذي ينبغي بذله لخلع جبة التقليد عن نفسه، واختراق الجدار السميك من الضلالات والاعراف والتقاليد.
فعد لنفسه العدة المطلوبة لهذه الرحلة الفكرية، فكانت نتيجه هذا الجهد الذي بذله في البحث هو انجلاء تلك الصورة التي ورثها عن الشيعة، وحلّ محلها المفهوم الموضوعي الذي يتأسس على العمق العلمي المتوفر في الكتابات التأريخية. كما تبيّن له أن مذهب أهل البيت (عليهم السلام) هو أول مذهب في الاسلام، وهذا لا يعني أن الشيعة انفردوا عن غيرهم بطريقة ابتدعوها، ولكنهم احتفظوا بموقعهم الاصيل الذي عُرفوا به، هذا في الوقت الذي شردت فيه جميع الملل والنحل، وتفرّقت تبتغي الحق عند غير أهله.
اتخاذ الموقف النهائي:
يقول السيد إدريس: “في اللحظات التي ظهرت لي الأحداث على حقيقتها، قامت ـ فوراً ـ حرب بين عقلي ونفسي، فالنفس عزّ عليها اقتلاع “ضرس” العقيدة السابقة، والعقل عزّ عليه أن يتغاضى عن الحقائق الواضحة القطعية، فإما أن أتبع طريقاً موروثاً، وإما أن أسلك سبيل القناعة ونور العقل”.
ويضيف: “كان هذا أخطر قرار اتخذته في حياتي، لكي انتقل بعدها إلى رحاب التحديات الفكرية والاجتماعية”.
ومن هنا استقر المقام بالسيد إدريس في هدى الأئمة الأطهار، فأعلن تشيعه في المغرب ثم هاجر إلى سوريا من أجل الالتحاق بالحوزة العلمية في دمشق. فتلقى دراسته الحوزوية على يد جملة من المشايخ والعلماء، ولا يزال متابعاً لدراسته إلى جانب مزاولة التدريس بالحوزة العلمية، اضافة إلى عمل الصحافة والكتابة الاخرى.
وقد تبلور عند الاستاذ اتجاهين في رحاب العلم والمعرفة: الأول الاهتمام بالمباحث المعاصرة والجديدة والحديثة التي تطرح بكثافة في ساحة المغرب، الثاني هو الاهتمام بالمباحث الدينية والمذهبية التي بدأ يتلقاها على أيدي اساتذة الحوزة العلمية التي انتسب إليها.
وقد أبدع الاستاذ في نتاجاته في كلا الاتجاهين، فألّف بعض الكتب فيما يخص المباحث الدينية مثل كتاب لقد شيعني الحسين، وكتاب الخلافة المغتصبة، والّف جملة من الكتب تدور حول الافكار والرؤى المعاصرة ككتاب: محنة التراث الآخر.
ولقد ارتأينا فيما يخص وقفه مع كتب المستبصرين أن نقف عند كتابين من كتب الاستاذ إدريس الحسيني، أحدهما يرتبط بالكتب التي دوّنها حول المباحث المذهبية، والثاني يرتبط بالكتب الي دوّنها على غرار الاسلوب المعاصر في البحث(۱).
مؤلّفاته:
(۱) “لقد شيعني الحسين (عليه السلام) ” (الانتقال الصعب في رحاب المعتقد والمذهب):
صدرت الطبعة الأولى عام ۱۴۱۴هـ ـ ۱۹۹۴م عن دار النخيل للطباعة والنشر ـ بيروت، ترجمه مالك محمودي إلى اللغة الفارسية تحت عنوان “راه دشوار از مذهب به مذهب” وصدرت الترجمة عام ۱۴۱۶ عن دار القرآن الكريم ـ قم.
يتضمّن هذا الكتاب دراسة موضوعية حول بعض الأمور العقائدية التي من خلالها تمكّن المؤلف أن ينتقل من المذهب السني إلى مذهب أهل البيت (عليهم السلام) .
ويحتوي الكتاب على مقدمة ذكر فيها المؤلف الأهداف التي توخاها من نشره لهذا الكتاب، ثم أعقبها بموضوع حول الرجوع إلى التاريخ وأسباب الحديث عن الشيعة والسنة. وفي الكتاب ستة فصول متضمنة لمجموعة محاور أهمها:
الفصل الأول: تصوّر المؤلف للتاريخ الإسلامي والخلافة الراشدة.
الفصل الثاني: مرحلة تحول المؤلف وانتقاله الفكري من السنة إلى الشيعة.
الفصل الثالث: اعادة تحليل التاريخ ودرء جملة من الشبهات المثارة ضد الشيعة والتشيع.
الفصل الرابع: حقائق ورؤى جديدة من التاريخ حول سيرة الرسول(صلى الله عليه وآله)ووفاته والملابسات التي اعقبت رحيله، وسيرة الخلفاء الذين جاؤوا بعده، ثم ذكر بيعة الإمام عليّ (عليه السلام) وما جرى في زمن خلافته، ثم التطرّق إلى خلافة الإمام الحسن (عليه السلام) وكيفية تحوّل الخلافة إلى مُلك، ثم الاشارة إلى ملحمة كربلاء التي كانت سبباً في تشيع المؤلف.
الفصل الخامس: مفاهيم كشف عنها الغطاء من قبيل مفهوم الصحابي، وشخصية عائشة بنت أبي بكر، ومفهوم الإمامة.
الفصل السادس: التركيز على خصائص العقيدة الإمامية في ما يخص: الصفات، التفويض والجبر، الرؤية والبداء.
(۲) “الخلافة المغتصبة” (أزمة تاريخ أم أزمة مؤرخ):
صدرت الطبعة الأولى عن دار الخليج، والطبعة الثانية عام ۱۴۱۶هـ عن دار النخيل العربي للطباعة والنشر ـ بيروت.
يحتوي هذا الكتاب على مقدمة ومدخل وثلاثة أبواب وخاتمة:
يتضمن المدخل مجموعة أبحاث منها: حركة النفاق في المجتمع الاسلامي; التدابير النبوية في تركيز الأمّة.
وأما الابواب:
الباب الأول: اصطلاح ومفهوم أهل البيت والخلفاء والواقع التاريخي.
الباب الثاني: أزمة تاريخ أم أزمة مؤرخين، نموذج ابن خلدون ومناقشة ما ذكره حول وفاة النبي(صلى الله عليه وآله)، بدء الخلافة، خبر السقيفة، خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ثم ذكر شبهات ابن خلدون والرد عليها.
الباب الثالث: أوهام مقدسة، أضواء على خلافة عمر وخلافة عثمان.
الخاتمة: ذكر الزبدة والنتيجة التي توصل إليها المؤلف خلال البحث.
(۳) “هكذا عرفت الشيعة” (توضيحات وردود):
صدر عام ۱۴۱۸هـ. عن دار النخيل العربي للطباعة والنشر ـ بيروت.
يحتوي الكتاب على مقدمة وثلاثة أبواب، يتضمّن كل باب مواضيع متعددة، منها:
الباب الأول: تقييم الصاح، عبدالله بن سبأ، القرآن، المتعة.
الباب الثاني: الوهابية وهوس التكفير، اصول الدين عند الشيعة الامامية، القبوريون، القضاء والقدر، البداء، الامام المهدي.
الباب الثالث: الوحدة وامكانية التقريب، الوجه الآخر للتشيع، اعيان الشيعة.
(۴) محنة التراث الآخر: النزعات العقلانية في الموروث الامامي” صدر عن دار الغدير ـ بيروت سنة ۱۴۱۹هـ.
وهو بحث ينطلق لصياغة رؤية موضوعية ومتكاملة للتراث الشيعي الذي تعرّض طوال تأريخيه للاقصاء من دائرة التأثير.
ويتناول الاستاذ ادريس في هذا الكتاب أربعة حقول وهي: الكتابة التاريخية وعلم الكلام والحكمة واصول التشريع.
المقالات:
(۱) “في نقد الاسطورة السبئية” نشرتها مجلة المنهاج التي تصدر عن مركز الغدير ـ بيروت، العدد الثالث ـ خريف ۱۴۱۷هـ ـ ۱۹۹۶٫
تتضمّن هذه المقالة نقاش وردّ لما أورده بعض القائلين: بالأصل السبئي للتشيع تلك الخرافة لاتي لم يزيدها تكرار الألسن لها إلاّ انفضاحاً وتهرءاً. وقد ركّز الكاتب نقاشه مع صاحب الكتاب “أصول مذهب الشيعة الاثني عشرية” ناصر بن عبدالله القفاري.
وقد أورد الكاتب: ” وسوف اقتصر في النقاش على كتاب “اصول مذهب الشيعة…” لجمعة تلك الافتراءات ولاشتباهه في الكثير من الامور في هذا المجال!”.
ويذكر الكاتب في نهاية المقالة د “ان غاية ما نصبوا إليه، وزبدة بحثنا في الموضوع، هو العمل على دحض الفكرة القائلة بالأصل السبئي للتشيع.
لقد اكتظت رفوف المكتبات والخزانات بما يخرس الألسنة في الأصل النبوي للتشيع”.
(۲) “الجابري… واللامعقول الشيعي” نشرته مجلة المنهاج ـ العدد الثامن ـ شتاء ۱۴۱۸هـ. ـ ۱۹۹۷م.
والجابري هو الكاتب المغربي صاحب كتاب: “نقد العقل العربي”.
جاء في أحد هوامش المقالة بشأن الجابري: “التركيز هنا على الجابري لما يسوِّغه، فهو أول مغامر جازف في قراءة التراث قراءةً لم تسىء إلى المنهج العلمي فحسب، بل تم فيها التركيز على الشيعة، حتى كان أشد عليهم من السلفية وأكثر حقداً. فلم يخل كتاب من كتبه هذه من تشنيع على الشيعة وتعريض بهم”.
وجاء في أول المقالة: “الخاصية التي تتبادر الى الذهن ونحن نقرأ أبحاث د. الجابري حول الفكر الشيعي وتاريخيه السياسي، هي تلك المحاولة التي لم تقطع من طرائق الجدل، ونعني بها طرائق الخطاب القائمة على كثرة الاقيسة الناقضة والمصادرات على المطلوب، والمغالطات…، حتى وهي تتستر وراء مناهج ومفايهم، تبدو ـ في مظاهرها ـ علمية وبرهانية، على أنه لا يكفي، في التحليل العلمي، إيراد المفاهيم العلمية هذه التي من اليسير تحويلها إلى أساس لرؤية مفارقة، حينما لا نحسن استخدامها أو توظيفها”.
(۳) “الانطلوجيا المشائية في افق انفتاحها، ومقاربة لنظرية الوجود عند صدر المتألهين الشيرازي”.
نشرته مجلة المنهاج ـ العدد التاسع ـ ربيع ۱۴۱۸هـ ـ ۱۹۹۸م.
جاء في بداية المقالة: “إذا جاز الحديث عن تيار وجودي بامتياز داخل حقل الثقافة الاسلامية، فليس هناك من هو أقدر بهذا الوصف من الفيلسوف صدر الدين الشيرازي، المعروف بـ “الملا صدرا” و”صدر المتألهين”; إذ انه جعل إشكالية “الوجود” مدار فلسفته وانشغالاته المعمَّقة، انطلاقاً من أنّ الوجود هو أشرف الأشياء عنده. وحتى نكون موضوعيين يجب ان نضع فلسفة “ملا صدرا”، بخصوص إشكالية الوجود في إطارها التاريخي، من حيث أنّها مثلت ثمرة عمل لجيل كامل من الفلاسفة. غير أنّ هذه المسيرة من النظر في إشكالية الوجود لم تجد مخرجاً لها إلاّ مع مجيء “ملا صدرا”. ونستطيع التحدث عند مذهبية إمامية متجانسة ـ باستثناء السهروردي ـ في مجال البحث الوجودي، تلك التي دشنها الخواجة نصير الدين الطوسي، وبلغت قمة نضجها مع “ملا صدرا” وأصبحت، بعد ذلك تمثّل وجهة النظر الفلسفية الإمامية”.
وجاء في الخاتمة: “إذا جاز أن تنسب نظرية “ملا صدرا” في الوجود إلى جهة ما، فانما إلى جوهر التصور الاسلامي، الذي يثبت موضوعية العالم، ويقرّ بحقيقة الموجود، مع التأكيد على عالم المثل، غير الخاضع لقانون الطبيعة، وهو عالم الروح”.
(۴) “مع ابن تيمية في ردوده على المنطقيين” نشرتها مجلة المنهاج ـ العدد الرابع عشر ـ صيف ۱۴۲۰هـ ـ ۱۹۹۶م.
جاء في بداية المقالة: “ليس ابن تيمية خصماً أشعرياً تقليدياً للفلسفة، على غرار أبي حامد الغزالي أو الشهرستاني أو ابن خلدون، أولئك الذين وان وقفوا منها موقفاً سلبياً، فهم ممّن مارس إحدى كيفياتها بصورة ما. لكننا الآن أمام حالة فارقة في عالم النقض على الحكماء والمناطقة، إنه المدعو ابن تيمية الحراني، ذلك المحدّث السلفي الذي حمل على عاتقه مهمة الدفاع عن الحديث، وعقيدة السلف من وجه النظر الظاهرية، وهو موقف صريح وواضح في انتصاره للسماع، ودحضه للعقل”.
وجاء فيها أيضاً: “لقد صنف ابن تيمية كتابه الشهير “نقض المنطق” دفاعاً عن أهل الحديث ودحضاً لمزاعم المتكلمين والفلاسفة وأهل المنطق، طبعاً، وعلى طريقة أهل التجريح من المحدثين، لم يدخر شيخ الاسلام شيئاً من الذم والقدح إلاّ وجاد به في مصنفه، حيث نعت الفلاسفة بالكفر والزندقة والبدعة…
لقد ربط ابن تيمية بين المنطق والالهيات. وربما انه جعل المنطق سبيل الالهيات اليونانية فانه لا مناصة من الحكم بضلال هذه الصنعة المتكلفة وفسادها; فمن “حسن الظن بالمنطق وأهله” ان لم يكن له مادة من دين وعقل يستفيد بها الحق الذي ينتفع به، وإلاّ فسد عقله ودينه”.
(۵) “آفاق النهضة في الفكر العربي المعاصر وجدلية العلاقة مع الغرب من منظار نقدي”:
نشرتها مجلة البصائر ـ بيروت ـ العدد (۱۰) ـ ربيع ۱۴۱۳هـ ـ ۱۹۹۳م.
جاء في بداية المقالة: “اثيرت ولا تزال ـ في الآونة الأخيرة ـ زوبعة من الاهتمامات بمستقبل العالم في ظل نظام عالمي جديد. رسم الغرب مبادئه، وحدد آلياته. مستقبل الحداثة وما بعدها في عالم متغير، وفي تاريخ بعيد المسار، تحاول الأيدلوجية الليبرالية ـ عبثاً ـ ايقافه أو الاستئثار به، ذلك المستقبل كما يتحدّد في الرؤية الغربية للعالم المعاصر. وفي هذا الافق المختنق بدخان كثيف، يصدر عن ذلك الغرب المستهتر، والممعن في التفوق والسيطرة، وتلك الشعوب التي خضعت قهراً وتغريراً، لنمط من الارغام والقسر على ثقافة واحدية، جاءت مع البضاعة الغربية… في هذا الافق الضيق المختنق، تعلو احتجاجات، للتأكيد على التميز، ومناهضة الثقافة العالمية الجديدة، التي تسيرها أجهزة الغرب، من أجل خلق نوع من المركزية الحضارية، ونبذ التميز والتنوع. لغايات تسلطية”.
وجاء في اواخر المقالة: “من أجل التفاعل الحقيقي مع الحياة، في انتعاشها المتواصل ستكون الأمة، أمام مسؤوليتين:
أولا: كيف تبعث إسلامها الحضاري من تحت قرون من الانحطاط والتمزق وتجعله يقفز من زمن الانحطاط الى مرحلتنا بعد توقف زمن طويل لم يمارس فيه البعد الحضاري من الاسلام، توقف شل جزءاً هائلا من امكانيات الاسلام الحيوية في عملية التفاعل مع الحياة.
ثانياً: كيف تواجه الأمّة باسلامها كيانات حضارية تؤمن بالخصوصية لنفسها، وتلغيها عن الآخرين، بل وتجعل من خصوصيتها محوراً كونياً لباقي الشعوب.
(۶) “المقبول واللامقبول في “اصوليات” روجيه غارودي”:
نشرته مجلة البصائر ـ العدد (۱۰) ربيع ۱۴۱۳هـ ـ ۱۹۹۳م.
قراءة في كتاب: “الأصوليات المعاصرة، أسبابها ومظاهرها” لروجيه غارودي، الكاتب الفرنسي المعروف.
جاء في مقدمة القراءة: “لعل ما يميز الكتابة عند “روجيه غارودي” هو أنها ليست من جنس الكتابات الاستهلاكيه، ذات الطابع الحرفي إنها انتاج يعكس جهد الباحث المخلص للمعرفة، ويتميز بالعمق والتحليل والمتابعة، يضاف إلى ذلك عمق التجربة التي خاضها “غارودي” على طول إحتكاكه بالفكر الغربي، الماركسي والمسيحي، وسعة إطلاعه على الفلسفات القديمة والحديثة. ولا تزال الرحلة “الغارودية” مستمرة إلى أن استقرت راحلتها على واحة العقيدة الإسلامية حيث باتت تلك هي أرضيته في كل إبداع يصدره للوجود”.
ذكر غارودي أنّ “الاصولية” التي يتهم الغرب بها الإسلاميين لا تختص بهم، بل هناك “أصولية” علمانية غربية، وأصولية مسيحية فاتيكانية، وأصولية يهودية اسرائيلية، وأصولية ماركسيه ستالينيه.
وجاء في قراءة الكتاب عند تعرض غارودي للاصولية الإسلامية: “الدخول المباشر في مناقشة غارودي في أخطر ثغرة تحليلية وجدت في كتابه وهو حديثه عن الأسباب الموضوعية لنشوء الظاهرة الاصولية في العالم العربي، تتطلب طرح السؤال عن مدى الجديد الذي اتى به غارودي، في تقريبه الأخير، للمسألة الاصولية، فالتحليل كان “أعرجاً” من ناحية التماس الدقة في المعلومات التاريخية”.
ولخّص الكاتب قراءته لكتاب غارودي بالقول: “لقد تمكّن غارودي من المواجهة الفكرية والسياسية للغرب، لكنه اخفق في محاولته للعبث بأساسيات الشريعة الاسلامية.. انه الوجه غير المقبول في مقاربة غارودي”.
(۷) “حوار الحضارات”:
صدر عن المركز الثقافي العربي ـ الدار البيضاء ـ المغرب ـ الطبعة الأولى، عام ۲۰۰۰٫
يقول المؤلف في مقدمة الكتاب: “هذا العمل الذي بين يدي القارىء، محاولة لمزيد من التوضيح (حول حوار الحضارات). فالخطر المترتب على الوهم بوجود حضارات متعاصرة يجعل الانهام بالذات المسلوبة الاقتدار، بداية الكارثة، ما يجعل حواراً بين بين الخواء والعمران، وبين السلب والايجاب، مشروعاً ناجزاً”.
ويشتمل هذا الكتاب على الأقسام والفصول التالية:
القسم الأول: مأزم الحداثة وبؤس آليات التثاقف.
الفصل الأول: مشكلة الحداثة في الثقافة العربية ـ الإسلامية.
الفصل الثاني: من المدينة الكالفانية إلى المدينة الإسلامية.
القسم الثاني: تحرير النزاع فيما بين الحضارة والثقافة من اتصال أو انفصال.
القسم الثالث: انشودة المثاقفة وآفاق الحوار الحضاري بين قمع الحداثة وصرخة الهامش.
الفصل الأول: الوجه الآخر لاطروحة هنتنغتون.
الفصل الثاني: مساءلات في الحوار الحضاري.
ملحق: مداخلات في مؤتمر: كيف ندخل حوار الحضارات.
(۸) “المفارقة والمعانقة” (سؤال المقابسة في قرن جديد، رؤية نقدية في مسارات العولمة وحوار الحضارات”:
صدر عن المركز الثقافي العربي ـ الدار البيضاء ـ المغرب، الطبعة الأولى عام ۲۰۰۱م.
يقول المؤلف في مقدمة الكتاب: “لقد سعينا من خلال هذا العمل إلى ابراز الوجه الآخر للعولمة غير وجهها البادي الغارق في المساحيق. نظرنا إليها بوجدان قلق لا بشبق غريزة. فانتهينا إلى ما انتهى إليه غربيون من ذوي الرأي والاختصاص والاحتكاك. وهم في الخندق المتقدم في مواجهة اجهاضات العولمة… هذا في القسم الأول. أما في القسم الثاني فقد تطرقنا إلى موضوع حوار الحضارات وعدنا حينئذ إلى البدايات حتى لا نقف في مأزق النهايات، مؤصلين ومقاربين للمفاهيم والمحدّدات الأولى. وخالفنا في ذلك من رام القول بتعدد الحضارات” ويحتوي هذا الكتاب على عدة مواضيع منها:
العولمة والعالم، أعولمة حقاً أم صناعة الحرب؟، العرب والعولمة: التحدي والاستجابة، العولمة الثقافية كمشروع اختراق، حوار حضارات أم ثقافات، اشكالية حوار الحضارات وراهنية العلاقات الدولية، الموضوعي واللاموضوعي في النموذج الحضاري.
وقفة مع كتابه: “لقد شيعني الحسين”
يعتبر هذا الكتاب، تدوين تجربة خاضها الاستاذ إدريس الحسيني في دائرة الفكر والاعتقاد، ليختار لنفسه المعتقد الذي يفرض نفسه بالدليل والبرهان، فكانت النتيجة أنه وجد الحق في غير ما ورثه من اسلافه.
وفي هذا الكتاب يسجل المؤلف تجربته في التحوّل من المذهب السني إلى مذهب أهل البيت (عليهم السلام) فيقول في المقدمة: “في تجربتي هذه، ليس هاماً أن أعرّف الناس بشخصيتي، فقيمة الموضوع الذي يتبنّاه هذا الكتاب، أهم بكثير، هذه تجربتي في خط العقيدة وأنا مسؤول عنها، لذلك أتوخى لها أن تكون حرّة، طليقة بلا قيود!”.
الفصل الأول: كيف كان تصوري للتاريخ الاسلامي؟
يرى المؤلف أن الأجواء التي عاش فيها، تركت اسمى التأثير في صياغة اطاره الفكري الذي ينظر من خلاله إلى التاريخ، فيقول: “فمنذ البداية كانوا قد زرقوني بهذا التاريخ… ونكف إذا رأينا الدم والفسق والكفر، ليس لنا الحق سوى أن نغمض الأعين، ونكف الألسن ـ حين قراءة التاريخ الاسلامي ـ ثم نقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت…”.
ويصف المؤلف هذه الحالة أنها عملية لجم مبرمجة وقيود توضع على عقل الانسان، قبل أن يدخل إلى محراب التاريخ المقدس: “لقد علمونا، أن نرفض عقولنا، لنكون كائنات “روبوت”، توجهنا كمبيوترات مجهولة، وغلبت السياسية على التاريخ، وحولته إلى بؤس حقيقي”.
ولكن ما إن سمى وعي الاُستاذ ادريس تحوّل إلى صاحب عقلية ناقدة لا تقبل شيء إلاّ بعد البحث والتنقيب ومن هنا كانت الازمة التي يصفها بقوله: “ما اثقلها من ازمة على طلاب الحقيقة!”.
الفصل الثاني: مرحلة التحوّل والانتقال
يذكر المؤلف في هذا الفصل قصة استبصاره، ويرى أنّ من أهم الموانع التي كان يضعها أبناء مجتمعه حين مبادرته إلى البحث العقائدي ودراسة احداث صدر الإسلام أنهم كانوا يقولون له: “تلك فتنه طهرنا الله منها، وليس لنا مصلحة في استحضارها والخوض فيها”.
لكن الاستاذ إدريس يذكر أنه كان يقول: “كيف طهرنا الله منها، وهي ما زالت حاضرة فينا، بعيوبها ومسوخاتها”.
وكان يطرح الاستاذ إدريس دائماً على اصدقائه قضية مظلومية الإمام الحسين (عليه السلام) يوم عاشوراء، وكان يبحث عن تفسير شاف لهذه المأساة، ومن هنا بدأت قصة استبصاره! لأنه خلال التفكير حول هذه القضية وجد نفسه أمام موجه عارمة من التساؤلات التي جعلته أن يقف حتماً على قاعدة اعتقادية صلبة، فاندفع ليجدد منطلقاته ويعالج مسلماته!
فيقول الاستاذ: “لم تكن عندي يومها المراجع الكافية لاستقصاء المذهب الشيعي… ويعلم الله، أنني رسخت قناعاتي الشيعية، من خلال مستندات أهل السنة والجماعة انفسهم. ومن خلال ما رزحت به من تناقضات”.
الفصل الثالث: وسقطت ورقة التوت
يحاول المؤلف في هذا الفصل أن يعيد تحليل التاريخ، فيتناول المسألة “الشيعية” من وجهة نظر تاريخية، وليس من وجهة نظر مذهبية، ثم يبحث حول أصل نشوء الشيعة.
فيقول حول ادعاء انتساب التشيع إلى عبدالله بن سبأ: “ليس هذه أول خرافة، تلقى بهذا الشكل “التهريجي على التشيع” بل أخريات من تلكم الشبهات المحبوكة بالأصابع المأجورة والمسيئة، بالترغيب والترهيب الأموي، لابد من الوقوف على هزالها!”.
ثم يذكر تهمة فارسية التشيع ويقول: “لم يكن التشيع من ابداع الفرس إلاّ عند مهرجي التاريخ، والعرب سباقون إلى التشيع، وهم الذين ادخلوه إلى فارس، والدليل على ذلك، أن معظم علماء السنة الكبار في التفسير والحديث والأدب واللغة… هم من فارس، وبقيت ايران ـ لفترة ـ على السنة الأموية في سبّ علي (عليه السلام) ولعنه في المساجد وعلى المنابر”.
الفصل الرابع: من بؤس التاريخ إلى تاريخ البؤس!
يدعو المؤلف في هذا الفصل إلى الحكم بالوجدان حين قراءة التاريخ، ثم يبيّن سيرة الرسول(صلى الله عليه وآله) مع التركيز على المحطّات الحساسة التي يعتبرها مفتاحاً لفهم الظاهرات التي شهدها التاريخ الإسلامي فيما بعد.
ثم يوضّح أن المؤامرة على الرسول(صلى الله عليه وآله) قد بدأت بعد الفتح، حيث حاول المنافقون الذين كانوا يشكلون جزءً من المجتمع الإسلامي أن يغتالوا الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) في اللحظات التي توفرت لديهم فيها الفرصة.
ويطرح المؤلف مسألة الوصاية والخلافة، فيقول: “إن المشروع الرسالي في عصر النبي(صلى الله عليه وآله) يقتضي الإهتمام، ولفت الأنظار لذلك الامتداد القيادي لرسالة الإسلام، حتى لا يطرأ على التصوّر المناوىء أن المشروع النبوي، مشروع وقتي ينتهي بانتهاء صاحبه.
ولم يكن من منطق الرسالات السابقة أن تغيب هذه المسألة المتصلة بواقع الرسالة الإسلامية ومستقبلها المصيري”.
ويخرج المؤلف في نهاية المطاف بهذه النتيجة: “إنّ الأصل في القيادة، هي الوصية، ولم تكن الشورى، سوى تبرير تاريخي لما وقع في سقيفة بني ساعدة. إذ أن التاريخ يفضح حقيقة الشورى التي اعتمدوها في السقيفة. بل أنّها ـ أي الشورى ـ اثبت “بؤسها” في انتخاب صيغة الحكم، وفي خلق الممانعة الشرعية والمطامع النفسية والقبلية التي كانت سائدة يومها وليس من السهولة التغاضي، عما وقع حول الخلافة من خلاف وتضارب!”.
ثم يثبت المؤلف بأنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) أقام عليّاً (عليه السلام) كمؤازر ووزير ووصي، ثم يستنطق التاريخ وليكشف عن اعماقه فيذكر عدّة مواقف نصّب فيها النبيّ(صلى الله عليه وآله) عليّاً كوصي وخليفه من بعده، منها: حديث الدار، والمؤاخاة، وحديث غدير خم و….
ثم يقول: “إن الرسول(صلى الله عليه وآله) لم يكن ـ حاشاه ـ غافلا عن قيمة الخلافة والاستخلاف، وكانت خطبة الوداع، برنامجاً لهم، يقيهم عثرات المستقبل، واكّد فيها على آل بيته (عليهم السلام) وولّى فيها الإمام عليّاً (عليه السلام) … وحذّرهم من مغبّة التجاوز للنص ابتغاء الرأي والباطل، كما حذّرهم من مغبة التضليل والردة والافتتان. ذكر اليعقوبي في تاريخه: “لا ترجعوا بعدي كفاراً مضللين يملك بعضكم رقاب بعض إني خلفت فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي”، ثم أمر الناس بالالتزام بما أعلنه واودعه فيهم قائلا: “إنكم مسؤولون فليبلغ الشاهد الغائب”(۲).
ملابسات وفاة الرسول(صلى الله عليه وآله):
اشار الاستاذ إدريس الحسيني في هذا الخصوص إلى جملة من الأحداث التي وقعت اثناء مرض الرسول(صلى الله عليه وآله) واحتضاره وبعد وفاته، وخص بالذكر الأحداث التي خلفت وراءها محناً سياسية واجتماعية رهيبة. منها: تجهيز الرسول لجيش أسامة بن زيد، وتخلّف بعض الصحابة عن تلبية أمره، ووقوف عمر موقفاً قمعياً حينما حال بين الرسول(صلى الله عليه وآله) في مرضه والكتابه، وقوله “حسبنا كتاب الله”.
وأمّا بعد وفاة الرسول(صلى الله عليه وآله): “فبقى(صلى الله عليه وآله) جثة هامدة بين يدي آل البيت، يغسلونه، في الوقت الذي راح الآخرون يتطاحنون على حق محسوم بالنص واستغلالا للظرف، وركوباً لفرصة غياب الإمام عليّ (عليه السلام) وآل البيت”.
وفيما يخص مقولة عمر بعد وفاة النبيّ(صلى الله عليه وآله): “إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله(صلى الله عليه وآله) توفي وإنه والله ما مات ولكنه ذهب إلى ربّه كما ذهب موسى بن عمران…” يذكر المؤلف: إنّ عمر لم يكن يجهل وفاة الرسول(صلى الله عليه وآله)، ولم يكن يجهل الآية التي تلاها عليه أبو بكر بعد مجيئه وهي قوله تعالى: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَئِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَـبِكُمْ) (آل عمران: ۱۴۴)، بل كان غرضه من اثارة هذا الموضوع، هو أن يصرف الناس عن التفكير بأمر الخلافة، حتى يربح الوقت لكي يأتي أبو بكر وتتم العملية.
ثم يذكر احداث السقيفة واللعبة التي لعبها أبو بكر وعمر وأبو عبيدة من أجل الوصول إلى مآربهم.
عصر ما بعد السقيفة:
يركّز المؤلف في هذا الخصوص على المحطات المهمة بعد السقيفة، ثم يورد المشاكل المعقدة التي افرزها واقع السقيفة، منها:
۱ ـ منع فاطمة الزهراء(عليها السلام) من ميراث ابيها لفدك وموقف الزهراء ازاء ذلك.
۲ ـ دخول أبي بكر في معركة مع المسلمين واتهامهم بأهل الردة، ذلك لمنعهم اعطاء الزكاة له.
۳ ـ استبداد أبي بكر في تنصيبه عمر بن الخطاب من بعده رغماً عن المسلمين وتحدياً لحرياتهم وتسفيهاً لمقاماتهم الكبرى.
ويقول: “الكل يحاول أن يرسم عمر بن الخطاب في صورة اسطورية كما شاءها له مناوئو بني هاشم، حتى يغطّوا بدخانها الكثيف فضائل البيت العلوي! بينما الواقع أن عمر بن الخطاب لم تكن له مؤهلات الخلافة النفسية والاجتماعية”.
ثم يقول: “إن سلبيات عمر التاريخية، ونوادره في السلوك السياسي والاجتماعي والفقهي لم ينسها التاريخ، ومن تلك النوادر:
۱ ـ سطحيته السياسية:
ـ ويسرد المؤلف اثباتاً لهذا الأمر شواهد كثيرة ثم يقول: فملخص القضية أن عمر راح ضحية قشريته السياسية، إذ ركز على عليّ (عليه السلام) وشيعته، وأرخى اللجام للزمرة الأموية ـ.
۲ ـ القمع الاجتماعي:
ـ إنّ عمر بن الخطاب لم يكن رجلا مذكوراً، عند العرب، ولم يكن له وزن قبلي يثبته ولا سند من الأنساب يسنده. لذلك كان يحاول الانتقام من خلال الخلافة، ليس من أجل كسب ما ضاع منه، وإنما من أجل الانتقام من الأمراء واصحاب الرفعة والشرف ـ.
۳ ـ الشذوذ الفقهي:
يؤخذ على عمر بن الخطاب، أنه خلافاً لما يدعي مؤرخو البلاط، رجل عديم الملكة الفقهية، وليس هذا فحسب، بل متجرىء على الفتوى فكان يأتي بالنوادر، متجاوزاً كل النصوص. يقول ابن أبي الحديد: “وكان عمر يفتي كثيراً بالحكم ثم ينقضه، ويفتي بضدّه وخلافه…”(۳).
كما اعترف عمر غير مرة بقصوره الفقهي أمام جمهور المسلمين، وشاع عنه قوله: “كل الناس افقه من عمر””.
الخلافة بعد وفاة عمر:
يقول الاستاذ إدريس في هذا الصدد: “دخلت الخلافة في المشهد الثالث من لعبتها، لتفضي ويفضي معها الاختيار الأرعن إلى اسوأ وضع عرفته الأمة وإلى أول اهتزاز سياسي شهده المجتمع الاسلامي”.
ويرى المؤلف أنّ الاطروحة التي قدمها عمر لتعيين الخليفة من بعده، كانت لعبه متقنة، ثمّ يتساءل: هل إن عمر هو الذي رأى أن الأمر بعد الرسول متروك للمسلمين ينظرون فيه؟ إذن لماذا لم يترك للناس حرية النظر في شؤون الأمة؟ ثم لماذا يلزم المرشحين الستة بمخططه ويقضى بقتل من خالف؟
ويجيب على هذه التساؤلات: إنّ عمر بن الخطاب كان يمهد منذ البداية لخلافة عثمان، ولكن الحرص على إحضار الستة له أسبابه التكتيكية. لقد حاول عمر من خلال هذا الترتيب أن يظهر للناس من بعده، أن عليّاً (عليه السلام) على الرغم من حضوره، فإنه لم يستطيع الفوز بها لعدم جدارته، ورفض الناس له، وبهذا سيسلب منه ورقة الخلافة ويسقطه سياسياً، كما أنه أراد أن يسقط معه مناوئيه القدامى وهما طلحة والزبير، وما وجود سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف سوى لتحقيق التوازن في المخطط، ليفضي الأمر في نهاية الجولة إلى عثمان بن عفان”.
عثمان أو الفتنة الكبرى:
يرى المؤلف أن الخليفة الثالث عثمان صنيعة وضع هو في حدّ ذاته مسلسل لواقع التآمر التاريخي على عصبة بني هاشم، وأن عثمان كان ضعيف الشخصية، لا يقوى على اتخاذ القرار ولا على الصمود في العدل بين العامة والأقرباء.
ولهذا استفز عثمان بسياسته المسلمين جميعاً، لأنه سلك منذ البداية نمطاً من الخلافة العشائرية حيث حمل بني أمية على رقاب الناس، فادى ذلك إلى انفجار ثورة شعبية عامة أدت إلى مقتله.
ويصف الاستاذ إدريس هذه الثورة: “لقد كانت حقاً ثورة من أجل تثبيت العدالة الاجتماعية من جديد، ثورة شاركت فيها كل فصائل المعارضة في المجتمع، بكل همومها وأهدافها، فكل الناس قتل عثمان وما من صغير وكبير إلاّ ونقم عليه.
ثم يتساءل: لكن هل استطاعوا ارجاع الأمور إلى نصابها، هل قضوا فعلا على النفوذ الأموي؟
فيجيب: إنهم لم يفعلوا سوى أن صنعوا المنعطف الآخر، ليدخل التاريخ الإسلامي، إلى حقبة الاضطرابات الكبرى، فنفوذ بني أمية أوسع وأعمق وأقوى من أن تزيحه ثورة فقراء، وسنين من الخلافة مضت كان فيها بنو امية على يقظة في بناء قدراتهم.
ثم يضيف: إنّ قتل عثمان قوّاهم بدلا من أن يضعفهم، وما أن قتل عثمان، حتى اكفهَّر التاريخ عن وجوه ذميمة، طالما بيّتت النفاق، مقتل عثمان كان مدخلا لفهم حقيقة التاريخ الاسلامي!”.
بيعة الامام علي (عليه السلام) :
يرى المؤلف أنّ المؤامرة ضد الإمام عليّ (عليه السلام) اصطدمت مع التاريخ، ولم يبق أمام الناس سوى الرجوع إليه، وكان لابد أن يكون للمؤامرة سقف تقف عنده، وكان هذا السقف هو يقظة الجماهير المسلمة على اثر مقتل عثمان.
ولكن الإمام عليّ (عليه السلام) واجه في حكومته بيئة تحكمها الامتيازات الطبقية، فتقدّم ليرفع صخوراً ثقال، إلى سماء الروح ليعطي للجميع حقه، فلهذا سخط عليه من الذين اعتادوا على الاستئثار، فانحاز هؤلاء في النهاية إلى معسكر الآخر: معسكر بني امية، حيث يجدون فيه تحقيقاً لأطماعهم.
ولذلك دخل الامام عليّ (عليه السلام) في معركة تاريخية مع فئتين احداهما إقطاعية والاخرى فقيرة انتهازية.
ومن هذا المنطلق وقعت حرب الجمل وهي الحرب التي كانت تلقائية، تخططها عقول ارتجالية وتقودهم امرأة ضعيفة العقل، ثم تلتها حرب صفين نتيجة محاولة الإمام عليّ (عليه السلام) لعزل معاوية من الحكم مهما كانت مضاعفات هذا الاجراء، ثم وقعت حرب النهروان نتيجة سذاجة البعض ومخالفتهم لما ارتآه الإمام عليّ (عليه السلام) من موقف ازاء معاوية في الظروف الحرجة التي كانت تحيطه والتي دفعته للتمسك بجعل الحكمين فيما بين جماعته وفئة معاوية.
ثمّ يستمر المؤلف بسرد أهم الأحداث التاريخية التي صاغتها ايدي المخالفين للوقوف بوجه الحق، فيذكر ما حدث في خلافة الحسن (عليه السلام) والمؤامرة الكبرى لقتله (عليه السلام) ، ثم مبادرة معاوية لتغيير الخلافة إلى ملك، ثم دخول يزيد إلى معمعة السلطة مما أدى إلى وقوع ملحمة كربلاء، ويذكر المؤلف عموميات مختصرة حول المشهد الدراماتيكي لملحة كربلاء كما اتفقت عليها تواريخ المسلمين، ثم يبين استنتاجاته التي ادت به إلى التشيع والانتماء إلى مذهب أهل البيت (عليهم السلام) .
الفصل الخامس: مفاهيم كُشف عنها الغطاء
يختار المؤلف في هذا الفصل مفهومي الصحابي والإمامة، فيكشف في الأول عن السلوك السياسي والاخلاقي للجماعة التي سميت بالصحابة، فيذكر نماذج منهم: أبو بكر، وعائشة، فيجعلهم في الميزان.
ثم يخرج بهذه النتيجة: ليس كل الصحابة عدول، ويبين أن الرسول(صلى الله عليه وآله) ذكر بأن بعض الصحابة سيرتدّون على اعقابهم.
وأما بالنسبة إلى مفهوم الإمامة، فيورد بحثاً كاملا حوله وحول ضرورته وصفات الإمام وافضليته وعصمته و…
الفصل السادس: في عقائد الإمامية
يبين المؤلف في هذا الفصل كيفية ظهور علم الكلام، فيقول: “لقد ظهر علم الكلام على أثر الأحداث التي تلت وفاة الرسول(صلى الله عليه وآله) إذ أن أمواجاً من التحديات الفكرية والفلسفية التي وردت على المسلمين من البلدان المفتوحة، كانت تفرض على المسلمين الاهتمام بالكلام، لإثبات عقيدتهم اثباتاً عقلياً يلزم حتى الخارجين عن الاسلام”.
ثم يركّز الاستاذ إدريس على بعض مباحث علم الكلام، منها: التوحيد والصفات، العدل الالهي، الرؤية والتجسيم، في كلام الله والبداء، فيستعرض في كل من هذه الخصائص بايجاز وجهة نظر كل من الفرق الثلاثة: الشيعة، المعتزلة، الاشاعرة، ويذكر الأدلّة التي دفعته للاقتناع بآراء مذهب أهل البيت (عليهم السلام) .
ويلخّص الاستاذ إدريس الحسيني في نهاية الكتاب رحلته السريعة في رحاب المعتقد قائلا: “نعلن أهمية الرجوع إلى أصل المعتقدات لإعادة بناء القناعة، على أسس علمية دقيقه، بعيداً عن ذوي التقليد”.
ثم يضيف: “إنني لم أتذوق حلاوة العقيدة إلاّ في ظل هذه الجولة وفي ضوء تلك الرحلة”.
وقفة مع كتابه الآخر: “محنة التراث الآخر”
إنّ من أهم القضايا التي قد أولاها المسلمون الأهمية الكبرى في زماننا المعاصر، هي السعي من أجل تشييد منهج متكامل لحلّ الأزمة الفكرية التي يعاني منها المجتمع في يومنا هذا.
وكان من جملة الأبحاث التي طرحت في هذا المجال على طاولة البحث هي صياغة رؤية واضحة ومتكاملة للتراث الذي واجه على مرّ العصور مختلف أشكال النفي والالغاء.
وقد خصّص الأستاذ إدريس هاني جزء من وقته للبحث في هذا المجال من أجل غربلة التراث وفرز الصحيح والنقي منه وطرح الباطل الذي تراكم عليه بمرور الزمان.
ودعت شمولية البحث واتباع الموضوعية أن يوسع الاستاذ دائرة بحثه ولا يقتصر على التراث الرسمي الذي نال مشروعيته من الحكومات ورجال السياسة، فتناول في هذا المجال التراث الآخر غير الرسمي.
وقد ارتأى البحث عن الموروث الإمامي الذي تعرّض على مرّ العصور لأشدّ ألوان الاضطهاد والمحاربة.
الدافع للنظر في دفائن التراث:
يذكر المؤلف أنّ من أهم الأسباب التي دفعته للخوض في مغامرة استكشاف التراث هي مفاجئته بالكم الهائل من القراءات التي اجتاحت حقل التراث، والتي شرعت في اقامة الحدّ عليه بسوط الحداثة كما استضعفته تحت سلطة خطاب مناهج شتى.
فيقول الاستاذ: “آنئذ عزمنا على اقتحام هذا المعترك، عنوة ـ لا خلسة ـ، كي نساهم قدر الوسع، بجهدنا الذي لا يسمح لنفسه بأكثر من العمل في إطار مشروع محاولة للفهم، وتقريب ما تعذّر استيعابه من قبل الناظرين في دفائن التراث، أو ما استنكفوا عن مقاربته، لأسباب، ما زلنا نصرّ على أنها غير موضوعية وغير نزيهة، البته!”.
ثم يعترف المؤلف: “إننا لا ننكر أنّ الحداثة، بغض النظر عن انشقاقاتها وخلافاتها، ظلت قضية فارضة نفسها على عالمنا العربي بمنظومته الفكرية والقيمية”.
ثم يضيف المؤلف: “أمام هذا الوضع، كيف نستطيع الظفر بفهم شمولي وتكاملي للتراث؟ وما هو السبيل إلى بلورة وعي تاريخ عربي، ينزهنا عن هذه النزعات المؤثرة على البحث التاريخي وآليات النظر في وقائعه؟”.
ثم يذكر المؤلف نماذج متعددة من اطروحات قراءة التراث لجملة من الشخصيات، منهم: حسين مروة، حسن حنفي، اركون، الجابري، وصرّح بأنّ هذه النماذج تمثل الخيارات البارزة على صعيد التفكير العربي المعاصر.
مشروع المؤلِّف في الكتاب:
يذكر المؤلف في صدد ما يريد العمل على ابرازه في هذه المناسبة، فيقول: “تأتي محاولتنا هذه، من أجل تقديم صورة عن الآخر المقصي، في صميم موروثنا الثقافي والتاريخي، وقد اخترنا نموذجاً من التراث ـ كتأطير اجرائي للبحث ـ: الموروث الإمامي”.
واختار المؤلف المجال الأول هو “الكتابة التاريخية”، ثم انتقل إلى مجال “علم الكلام، فاستحضر أهم الاشكاليات المطروحة، فأوضح ما به امتيازها وما هو من مختصات النظر في الخطاب الكلامي الامامي، وفي الحقل الثالث، يتطرّق المؤلف إلى مجال الحكمة، فيقدّم نموذجاً لهذه الحكمة من خلال الفيلسوف الشيرازي صدر المتألهين. وأمّا الحقل الرابع فيتعلق بمجال اصول التشريع، حيث تتبع المؤلف تاريخية التأصيل وآليات الاشتغال الفقهي وبيّن مواقع الخصوصية والتمييز في مسار النظر الفقهي الإمامي.
الفصل الأول: الكتابة التاريخية
ذكر المؤلف في بدء هذا الفصل اشكالين يرتبطان بنقد الخطاب التاريخي العربي وهما: أولا: كيف نقدّم فهماً معقولا وواقعياً لأحداث الماضي، والثاني: كيف يمكن تخطّي أزمة العقل العربي وتخلّفه التاريخي.
ثم ألحق المؤلف بهذين الاشكالين سؤالا آخر وهو: هل أزمة الخطاب التاريخي العربي، ظاهرة لازمة لهذا الخطاب من حيث هو عربي، أم أنها تتعلّق بالخطاب التاريخي بصورة عامة.
ومن هنا بدأ المؤلف بحثه فقال حول استطاعة التاريخ الظفر بعلميته: “إنّ الخطاب التاريخي العربي يشكو أكثر من أي قطاع معرفي آخر شدة الفقر العلمي، لأنّه صورة عن الماضي قد تمّ تبينها على هوى المؤرخ”.
ثم ميّز المؤلف بين التاريخ والاسطورة، ويذكر أنّ التاريخ هو علم حقيقي بالماضي، وأن الاسطورة هي تأمل تخييلي لا زماني ولا مكاني.
وأمّا ما يخص العرب والمسلمين في مجال الكتابة التاريخية، قال المؤلف: “إنّ مشكلتهم تكمن في كونهم حوّلوا هذه الممارسة الموضوعية إلى وظيفة لتركيز ايديولوجيا ما أو اثبات الشرعية لكيانات سياسية مختلفة”.
وقال المؤلف في هذا الصدد: “التاريخ العربي قتلته السياسة، لذا جاء مجزءاً ومتلبّساً، بناء على تجزئة الخريطة السياسية والمذهبية التاريخية للعرب والمسلمين. فالمؤرخ، بالدرجة الأولى رجل منخرط في الصراع السياسي، لأن قطاع المعرفة كلّه بيد البلاط، ولا حديث حينئذ عن استقلال المؤرخ! وحينما لا يستقل المؤرخ لا يستقل التاريخ، هكذا ورثنا تاريخاً عربياً متناقضاً ومتمذهباً ومنمطاً.
ومن هنا تطلب الموقف أمام التاريخ هو ضبط الرجال وابتكار علم جديد يُعني بأحوال الراوي فقال المؤلف في هذا المجال: “غير أن التجربة الاسلامية انتهت إلى نوع من التجزئة السياسية والمذهبية، جعل مفهوم الثقة ذاته يخضع لمعايير ذلك التشطير المذهبي”.
نماذج الكتابة التاريخية العربية:
يعرض المؤلف في هذا الخصوص أولا ابن جرير الطبري، ويذكر أن السبب الذي مكّنه من الاستئثار بالريادة على صعيد الكتابة التاريخية العربية هي أن الطبري لم يكن مؤرخاً خالصاً، بل هو قبل كل شيء فقيه ومحدّث وقاضي، وهذا ما ساعده على انجاز مدوّنته الأخبارية الشاملة على أساس اسلوب “الاسناد” الذي ظل يمثل المنهج الأكثر أهمية لدى المحدّثين.
ثم يذكر المؤلف ابن كثير ويقول عنه أنه مارس التاريخ بدافع اعادة بناء الحقيقة القدسانية كما يتصوّرها السلفي، وهي التي تجعل من الانتصار للمذهب غايتها القصوى.
ثم يقارن المؤلف بين الطبري وابن كثير فيقول: “الطبري قد يضحي بالنص من أجل الوصول إلى الوفاق، في حين نجد ابن كثير يضحي بالوفاق من أجل تحديد موقف السلف”.
ثمّ يقول: “وكلاهما قد يضحي بالحقيقة من أجل بلوغ غاية ايديولوجية ما!”.
ثم يذكر المؤلف نموذج آخر، وهو ابن خلدون، ويصف نمط كتابته للتاريخ بـ: “التاريخ المتسيس”، وهو نوع من الكتابة التاريخية، تنطلق من داخل الظروف والملابسات السياسية.
الآخر الامامي، في ضوء الرؤية “المللية”:
يستعرض المؤلف في هذا المقطع رؤية معظم الفرق الاسلامية حول التشيع، فيقول: “إن معظم أصحاب الملل والنحل تعتقد بأن التشيع ظل محلا للبدع ومأوى للضلالات الوافدة عبر الترجمة أو بواسطة الاحتكاك بالفلسفات الإغريقية والتيار الغنوصي والهرمسي.
ثم يقول المؤلف: لكن وعلى الرغم من الهجمة الواسعة التي ساهم في تعميقها جمهرة من العلماء، وأيضاً الخلفاء، الذين احتفظوا بعدائهم الشديد للشيعة، نجد الشيعة تمكّنوا من الاستمرار في الوجود باصرار نادر وعزيمة فذّة”.
الإمامية في المقروئيات الاستشراقية:
يذكر المؤلف تحت هذا العنوان نماذج من المستشرقين من قبيل: فلهوزن، ودوزي، وجولد زهير، ولوي ماسينيون، وكوربان، ثم يورد آراءهم حول الشيعة والتشيع، ويقوم بعد ذلك بتحليل سرد الأسباب التي دعت هؤلاء إلى اتخاذ هذه الرؤية حول الشيعة والتشيع، ويبين كيف أنّ جملة منهم اكتفوا بملامسات سطحية كان لها أثر على تحليلهم في هذا المجال، ويذكر اسماء من توجهوا إلى البحث الموضوعي والانصاف في كتاباتهم حول الشيعة والتشيع.
الجابري واللامعقول الشيعي:
يورد المؤلف تحت هذا العنوان بحثاً موجزاً حول موقف الجابري من الفكر الشيعي، فيقول: لم تكن محاولة الجابري سوى عملية لتحيين ذلك الصراع التقليدي، الذي يتم فيه الانتصار لعقلانية فانتازية، تجد إطارها في ظاهرية ابن حزم وسلفية ابن تيمية”.
ثم يذكر المؤلف حول السبب الذي دفع الجابري لاتخاذ هذا الموقف قائلا: “وحينما نعود إلى جملة المصادر التي اعتمدها الجابري في تناوله للفكر الشيعي، وهي العملية التي ستكشف، ليس فقط، عن عجز في الاستيعاب، بل، وهو الأخطر من ذلك، عن عجز في الفرز بين مختلف الفرق الشيعية”.
ثم قام المؤلف بالرد على جملة من وجهات نظر الجابري الحادة بالنسبة للفكر الشيعي، وبادر إلى تفنيد مزاعمه التي ذكرها في جملة من كتبه.
الفصل الثاني: علم الكلام
يذكر المؤلف في بدء هذا الفصل أن معرفة أصول الاعتقاد عند الإمامية، مقدمات ضرورية ـ عقلانية وعرفانية ـ ممّا يجعلنا نؤكد على أن التشيع في كليته ينطوي على رصيد فلسفي وعرفاني كامن في ثنايا أكثر نصوصه وتعاليمه!
ثم يذكر المؤلف مبحث الحسن والقبح العقليين، ويعتبر هذا المبحث في علم الكلام من أكثر المباحث أهمية وأغناها مضموناً، فطرحه على طاولة البحث مع ذكره لآراء الاشاعرة والمعتزلة في هذا المجال، ثم اتبعه بمبحث التوحيد، ثم العدل الالهي، ثم القضاء والقدر، ثم عقيدة الجبر والاختيار، ثم البداء وقدم القرآن.
وذكر في كل من هذا المباحث العقيدة الإمامية واقوال فقهاء ومتكلّمي الشيعة فيها، وموقف أهل السنة منها وردود فعل باقي الفرق منها، والفهم الخاطىء الذي تلتقه بعض الفرق من الطرح الشيعي، وقد ألحق بكل من هذه الأبحاث الأدلة التي دفعت الشيعة لما ذهبوا إليه، كما قام في بعض المباحث بدرء بعض الشبهات المطروحة حول تلك المواضيع.
الفصل الثالث: الحكم
يطرح المؤلف في بداية هذا الفصل موضوع، التفكير الفلسفي عند الإمامية، فيقول: “إنّ الامامية ظلوا ـ على الرغم من النبوغ الفلسفي لعدد من أبنائهم ـ المدرسة الشيعية الوحيدة التي لم تقطع صلتها بموروثها الإمامي، الشيء الذي جعلها حقّاً، رائدة فلسفة إسلامية، خالصة”.
ثم يقول المؤلف: “لم تكن معالم الفلسفة الامامية قد انتظمت قبل مجيء نصير الدين الطوسي خارج اطار علم الكلام; الذي وجد فيه الإمامية مجالا خصباً لبلورة معقولهم، وقد ظل موقفهم من الفلسفة محكوماً بنوع من التردّد والحذر… غير أن الإمامية سرعان ما اقتحموا مجال الفلسفة من أوسع أبوابه”.
ثم ذكر المؤلف جملة من الأسماء الشيعية اللامعة في سماء الفلسفة، منها: نصير الدين الطوسي، السهروردي، حيدر آملي، الشيخ زين الدين الأحسائي، ميرداماد، ملا صدرا الشيرازي، وملا هادي السبزواري.
ويقول المؤلف: “إنّ الفيلسوف الإمامي قبل كل شيء أو بعد كل شيء، هو فقيه ومتشرّع مهما بلغ مقدار تخصصه الفلسفي”.
ثم يصرح المؤلف: “لقد نجح الإمامية في أن يزاوجوا ـ فعلياً ـ بين الفلسفة والشريعة… كما أن الفقه ظل عنصراً أساسياً حتى لدى أولئك الذين غاصوا في الفلسفة إلى الاعماق”.
ثم يسلط المؤلف الضوء على الموقف الإمامي الآخر قبال الفلسفة، فيقول: “غير أننا سرعان ما نفاجأ بموقف إمامي آخر، يستدعي منا وقفة خاصة، وهو موقف خصوم الفلسفة، تلك الظاهرة التي لا يخلو منها مذهب من المذاهب الدينية والفكرية”.
ويعتبر المؤلف أنّ الموقف الإمامي المعادي للفلسفة يمثّله فريق من الأخبارية، لكنه يقول: “إنّ الذين حاربوا الفلسفة من الإمامية، لم يتنكّروا للعقل الذي ناصرته الفلسفة، بل أنّهم وضعوا جملة من المحاذير حول الفلسفة، لكي لا تكون بديلا عقدياً، يغني عن تعاليم الوحي، فضلا عمّا كان يروجه الفلاسفة من أفكار تناقض في ظاهرها ـ وربما ايضاً في حقيقتها ـ مفهوم التوحيد ومصير النفس الانسانية”.
ويرى المؤلف أن موقف خصوم الفلسفة الإمامية: “لم يكن موقفاً جذرياً من النظر الفلسفي، إلاّ من حيث كونه ظل مأوى للوافد الأجنبي من الثقافات والأفكار اليونانية والفارسية القديمة، لقد حاربوا ـ إذن ـ موقفاً ايديولوجياً داخل الفلسفة، وليس جوهرها من حيث هي موقف متسائل من العالم”.
صدر المتألهين الشيرازي:
يحاول المؤلف بعد ذلك أن يتعرّض بصورة موجزة إلى معالم الفلسفة الإمامية، فيما يتعلّق بمباحث الوجود ونظرية المعرفة، من خلال اسم بارز، هو الفيلسوف الشيرازي المعروف بصدر المتألهين.
فيقوم المؤلف في البدء بذكر نبذة من حياته، والفترة التي قضاها في تحصيل العلوم، ثم المضايقات التي لاقاها من قبل الفقهاء والعداوة التي كان كثيراً ما يقدحها الكيان السياسي ويؤججها صخب العامة.
ثم يطرح المؤلف جملة من آراء ووجهات نظر ملا صدرا، فيقول: “يعتبر ملا صدرا تحصيل المعارف والمباحث الفلسفية، لا فائدة منه على صعيد تملك الحقائق، فهي ليست سوى أدواة لشحذ الذهن وتقويته، لإذكاء الانتباه وحصول الشوق إلى الوصول، إنها بالتالي مما يعد الطالب لسلوك سبيل المعرفة، والوصول إلى الأسرار إن كان مقتدياً بطريقة الأبرار”.
ويضيف المؤلف: “لقد استطاع الشيرازي حقاً أن يقحم عنصراً أساسياً، لا نكاد نجد له نظيراً عند اسلافه، ألا وهو “المنهج” الذي حاول بواسطته، ايجاد تخطيط جديد للمباحث الفلسفية، وخلق صيغ ناظمة للمعقول تتميز عن الطرق المتعارف عليها.
إن المحور الأساس لهذا المنهج، يخضع لثنائية طرائقية في مجال البحث الفلسفي، مسلك الفلاسفة البحثي والبرهاني، ومسلك العرفاء الالهامي; بمعنى آخر، يجمع بين طريقة المشائية والطريقة الاشراقية، وينتقد بشدة الفصل بين الطريقتين أو سلوك أحدهما بمعزل عن الآخر”.
ثم يذكر المؤلف نظرية ملا صدرا في وحدة الوجود والتي تعرف بـ “الوحدة في عين الكثرة”، ثم اتبعها بذكر أهم ابتكاراته التي جعلت الفلاسفة الإمامية ـ حقاً ـ جديرين بلقب آباء المشائية والمتيافيزقا الإسلامية خلال القرن الحادي عشر الهجري.
فيقول المؤلف: “هذه الابتكارات التي أكسبت الفلسفة الاسلامية مزيداً من النضج والأهمية ووضعت خطواتها على طريق التفكير الايجابي للعالم”.
ثم يعرض المؤلف المعالم الكبرى لهذه النظرية بالقدر المتوخّى من الاقتضاب، فيبحث حول الحركة، ثم يبحث حول الجوهر ثم يقارن نظرية ملا صدرا حول الحركة الجوهرية مع تفاسير باقي العلماء في هذا المجال من قبيل ابن سينا والرازي والسهروردي.
ثم قال المؤلف في نهاية الفصل: “لقد اشتغل الامامية داخل حقل الفلسفة مثلما اشتغلوا داخل حقول اُخرى، برؤية نقدية، ما كانوا ليرتادوها، لولا هذه النزعة العقلانية التي اتحفهم بها تراثهم النظري، من حيث تفتحه على عالم المعرفة من أوسع أبوابه، ألا وهو: أهمية التفكير، وحجية العقل، وبالتالي الاجتهاد المستدام والنظر المبدع”.
الفصل الرابع: أصول التشريع
ذكر المؤلف في بداية هذا الفصل سبب نشوء الاجتهاد، وذكر أن وفاة المعصوم ـ بشكل عام ـ أدى إلى نشوء حيرة في موقف المكلفين، ازاء التراكمات المتدفقة للحالات والموضوعات المتجددة في يوميات المكلفين.
وذكر أنّ لهذا العامل دور كبير في نشأة الاجتهاد وقيام القياس مقام نصوص محنطة فاقدة لديناميكيتها الدلالية، حيث انتهت إلى صيغ لفظية جامدة، تتأطر داخل سياج المعنى الوحيد، بالاحاطة الوحيدة ـ الممكنة ـ إلى أسباب النزول، وخصوصية المورد الأول.
عصر التدوين:
ذكر المؤلف السنة كمصدر للتشريع، ثم اشار إلى عصر التدوين والملابسات التاريخية والنزاعات الايديولوجية التي واكبت أحداث مشروع التدوين، فقال المؤلف: “فقد لعبت ظروف تاريخية وسياسية دوراً حاسماً في تحديد ضوابط النظر الفقهي وآلياته، وهي ظروف فجرّتها أزمة النظام السياسي التاريخي للمسلمين”.
وأضاف المؤلف: “على هامش تلك الصراعات الطاحنة بين مختلف الفرقاء في المجال السياسي، ظهرت عدّة انعكاسات في صميم الموقف الفكري الذي بلغ أوجه في الخلافات الكلامية واستمر الجدال على أشده في مجالات أخرى، كالفقه وأصوله وعلم اللغة وآدابه”.
ثم ذكر المؤلف: “إنّ تراث عصر التدوين لم يتحرر بصورة جذرية من تلك الملابسات، بل ظل مرهوناً بالأيديولوجيا السياسية السائدة، ولا شك أن أمراً كهذا، يبدو طبيعاً، خصوصاً لما نعلم أن الغموض والالتباس والتردد، الذي واكب مجمل حركة التدوين، ينبع من صميم الأيديولوجيا التلفيقية التي ظلت رهاناً تاريخياً للكيان السياسي العربي”.
تدوين القرآن:
أشار المؤلّف إلى القرآن كمصدر للتشريع، ثم ساق الحديث حول تدوين القرآن وما يتعلّق بكتابة الوحي وما يتصل بقرار جمع القرآن في عهد الخليفة الأول، وما يتعلّق بمحنة توحيد القراءات في عصر عثمان.
ثم يخرج المؤلف بهذه النتيجة: بأن القرآن قد جمع ودون كاملا، على عهد الرسول(صلى الله عليه وآله)، وأن ما شاع من أن عملية كتابة القرآن، كانت غير منتظمة، وتعتمد وسائل بدائية مثل عظام الحيوانات وسعف النخل لا تقوم على دليل واضح.
وأمّا فيما يخص محنة توحيد القراءات في عهد عثمان “فيقول المؤلف: تحيلنا العديد من الأخبار، إلى أن القرآن، نزل بأكثر من حرف، وأنه كان يحتمل اكثر من قراءة وكانت كلها قراءات تحظى بتقدير المسلمين واقرار من النبيّ(صلى الله عليه وآله)، بل وأكثر من ذلك اعتبر نزول القرآن على سبعة أحرف رحمة للناس…
وأن توحيد القراءات وحرق كل المصاحف وحمل الناس على قراءة واحدة في عهد عثمان أدّى إلى حدوث اضطرابات كثيرة في شأن حقيقة الأحرف السبعة التي وردت في مختلف الأخبار”.
التأويل:
طرح المؤلّف مفهوم التأويل وثنائية الظاهر والباطن، وذكر أنّ جملة من النصوص التي وردت عن الإمامية تؤكد على أهمية الباطن وضرورته في اغناء المعرفة.
ثم ذكر المؤلف: “إنّ تحميل النصوص، بعضاً من المعاني المحددة، وهو من باب التعاصر الذي تفرضه ديناميكية النص، التي هي ديناميكية متصلة بحركة الواقع ومتغيرات الظروف، أي أن النص يقدم نفسه كفعالية تاريخانية، لا جرم أن يكون خاضعاً لتوجيه ما تقتضيه متطلبات المرحلة التاريخية على أن يتم ذلك وفق آلية محددة، وفي اطار من الاحتمال”.
تاريخية الاجتهاد عند الإمامية:
ذكر المؤلف في هذا الخصوص: على الرغم من أن أئمة أهل البيت ظلوا يمثّلون رافداً تربوياً وتعليمياً مهماً في العصور المبكرة من التاريخ العربي والاسلامي، إلاّ أن المعالم الكبرى لمذهبيتهم لم تظهر إلاّ في عهود متأخرة جدّاً، وتحديداً إبان العصر العباسي، هاهنا برز اسم الإمام السادس، جعفر الصادق، حيث اصطبغ المذهب الفقهي الإمامي بتراثه التعليمي وأخذ بعد ذلك اسم “المذهب الجعفري”… وقد ظل الإمامية يعتبرون تعاليم جعفر بن محمد الصادق، بمثابة “النص” في حين اعتبروا غيرها من التعاليم، ضرباً من الاجتهاد مقابل النص”.
المدرسة الصادقية:
ذكر المؤلف أنّ المعارك والمؤامرات السياسية التي كانت تهدف إلى زعزعة الكيان الأموي البائد مثلت منعطفاً جديداً في المسار الفكري عند الإمامية، فقد قدر للإمام الصادق (عليه السلام) أن يعيش هذه الفترة وأن يستغلها في سبيل تفعيل الساحة الثقافية وخلق واقع تعليمي وتربوي في المجتمع.
وفي هذه الفترة استطاع هشام بن الحكم أن يشكل تراثاً نظرياً من خلال عدد من المناظرات، وأيضاً بعضاً من مصنفاته، كما قد دافع اتباع الإمام الصادق عن مدرستهم الفقهية التي يعود إليهم الفضل في نشر تعاليمها.
عصر الغيبة، وبداية التأصيل الإمامي:
ذكر المؤلف في هذا المجال: أنه كانت الفترة الممتدة من الإمام عليّ بن أبي طالب إلى الغيبة الكبرى، تمثّل مرحلة سيادة النص وحضوره المكثّف، فإن ما جاء بعدها، يمثّل مرحلة تأصيل العلوم الإسلامية، بما يحفظ للتراث الإمامي فرادته واستقلاله النسبي من تراث عصر التدوين.
ثم ذكر أنه يمكننا أن نعتبر الاجتهاد الإمامي بعد عصر الغيبة، يتأطّر ضمن أربع مراحل:
۱ ـ المرحلة الممتدة ما بين الغيبة الكبرى، حتى القرن السابع الهجري.
۲ ـ مرحلة القطيعة وتكامل النظرية الاجتهادية.
۳ ـ مرحلة الاصطدام بالتيار الاخباري.
۴ ـ عودة المدرسة الأصولية، ونهوض مدرسة الوحيد البهباني.
ثم شرع بتوضيح كل من هذه المراحل الأربعة، وذكر ما لاقاه التراث الإمامي من تغيّر خلال هذه المراحل.
ثم ذكر المؤلف في نهاية الكتاب: “وقد كانت هذه المحاولة التي بين أيدينا، مقاربة عملية في إطار المشروع، الذي يهدف إلى معالجة منصفة في إعادة بناء الرؤية المعاصرة للممنوع والمهمش بلغة ديمقراطية أليق بوعينا المعاصر، كخطوة لإعادة بناء الصرح المعرفي العربي الإسلامي على أسس حوارية متينة، ولحمل ما لم يقو على حملة الأسلاف”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(۱) مصادر الترجمة: لقد شيعني الحسين للمترجم له، الخلافة المغتصبة للمترجم له، مجلة المنبر العدد ۳، السنة الأولى، جمادى الاولى ۱۴۲۱هـ.
(۲) تاريخ اليعقوبي: ۳ / ۹۰ ـ ۹۳٫
(۳) شرح النهج لابن ابي الحديد: ۳ / ۱۸۱٫
المصدر: مركز الأبحاث العقائدية