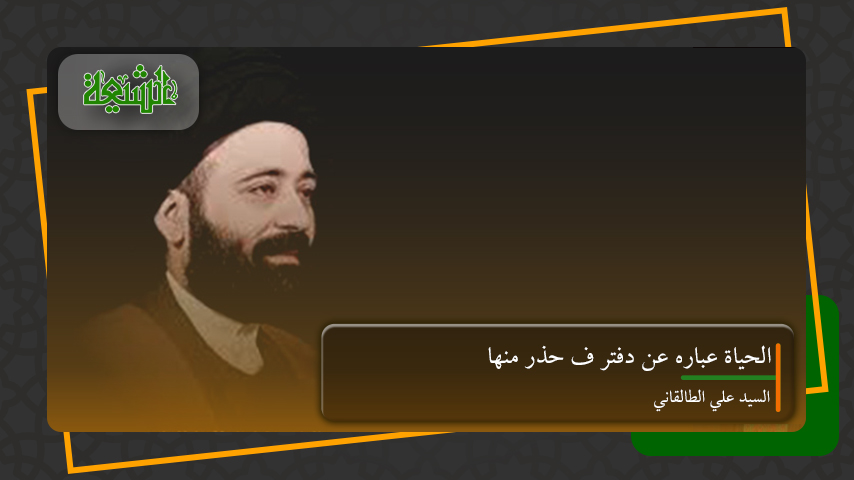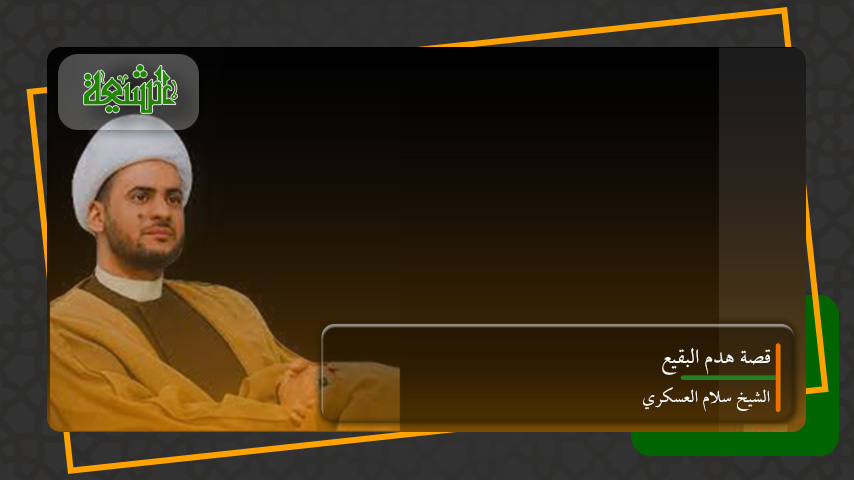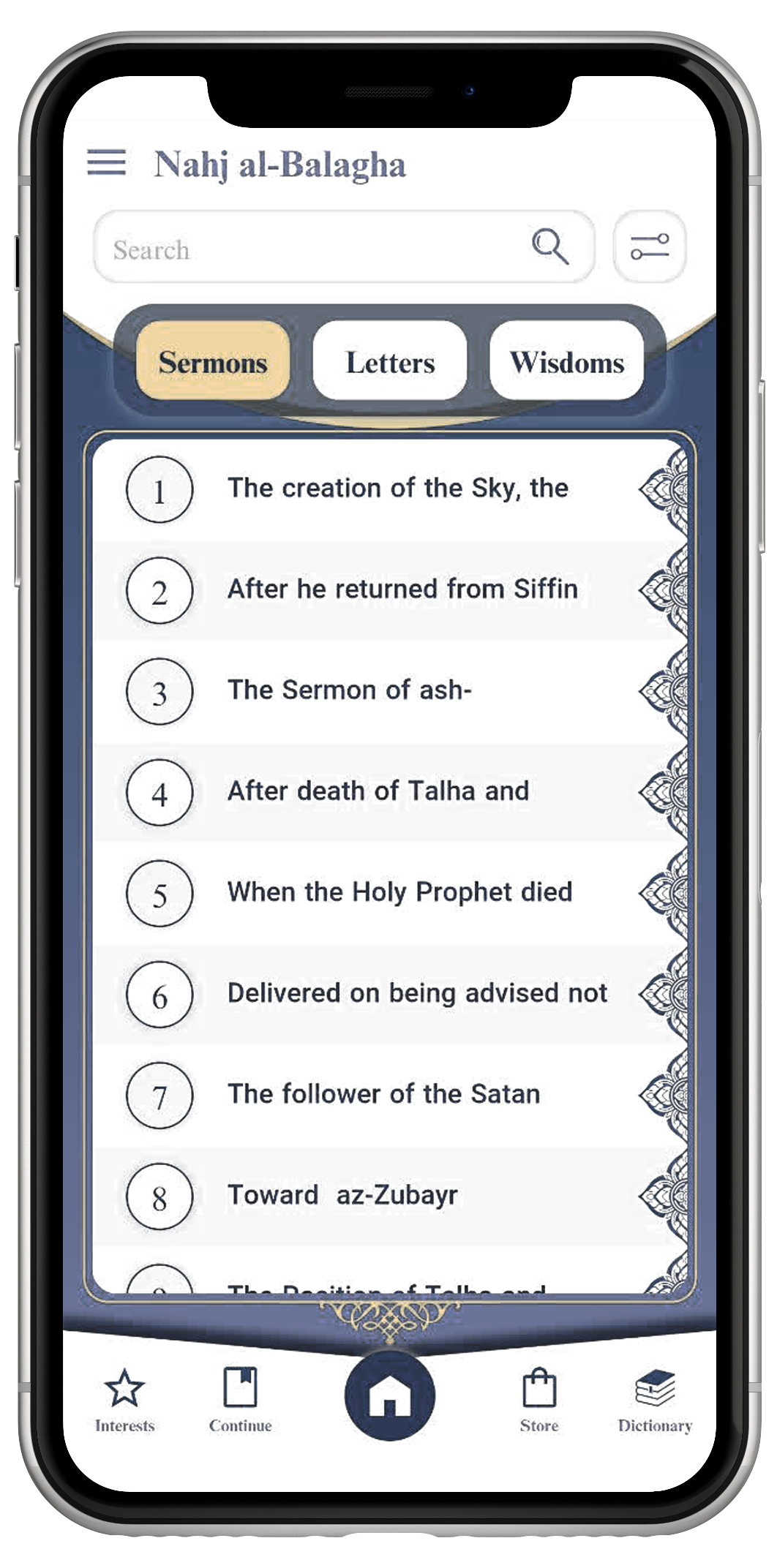وأما النص فعلى ضربين :
متناول للجميع عليهم السلام .
ومختص بكل واحد منهم .
فالأول من طرق :
منها : قوله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ( 1 ) .
وذلك يقتضي علم المسؤولين كل مسؤول عنه وعصمتهم فيما يخبرون به ، لقبح تكليف الرد دونهما ، ولا أحد قال بثبوت هذه الصفة لأهل الذكر إلا خص بها من ذكرناه من الأئمة عليهم السلام وقطع بإمامتهم .
ومنها : قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) ( 2 ) .
فأمر باتباع المذكورين ، ولم يخص جهة الكون بشئ دون شئ ، فيجب اتباعهم في كل شئ ، وذلك يقتضي عصمتهم ، لقبح الأمر بطاعة الفاسق أو من يجوز منه الفسق ، ولا أحد ثبتت له العصمة ولا ادعيت فيه غيرهم ) فيجب القطع على إمامتهم واختصاصهم بالصفة الواجبة للإمامة ، ولأنه لا أحد فرق بين دعوى العصمة لهم والإمامة .
ومنها : قوله تعالى : ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) ( 3 ) .
فأمر سبحانه بالرد إلى أولي الأمر ، وقطع على حصول العلم للمستنبط منهم بما جهله ، وهذا يقتضي كونهم قومة بما يرجع إليهم فيه مأمونين في أدائه ، ولا أحد ثبتت له هذه الصفة ولا ادعيت له غيرهم ، فيجب القطع على إمامتهم من الوجهين المذكورين .
ومنها : قوله تعالى : ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ) ( 4 ) .
وقوله : ( ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم ) ( 5 ) .
فأخبر تعالى بثبوت شهيد على كل أمة – كالنبي عليه السلام – تكون شهادته حجة عليهم .
وذلك يقتضي عصمته من وجهين :
أحدهما : ثبوت التساوي بينه وبين النبي عليه السلام في الحجة بالشهادة .
الثاني : أنه لو جاز منه فعل القبيح والاخلال بالواجب لاحتاج إلى شهيد بمقتضى الآية ، وذلك يقتضي شهيد الشهيد إلى ما لا نهاية له ، أو ثبوت شهيد لا شهيد عليه ، ولا يكون كذلك إلا بالعصمة ، ولم تثبت هذه الصفة ولا ادعيت إلا لأئمتنا عليهم السلام ، فاقتضت إمامتهم من الوجه الذي ذكرناه .
ومنها : قوله تعالى : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ) ( 6 ) .
فأخبر تعالى بكون المذكورين عدولا ليشهدوا عنده على الخلق ” وذلك يقتضي ثبوت هذه الصفة قطعا للأكل واحد منهم للاشتراك في الشهادة ، ولم تثبت هذه الصفة ولا ادعيت لغيرهم ، فدلت على إمامتهم من الوجوه التي ذكرناها .
ومن ذلك : ما اتفقت الأمة عليه من قوله عليه السلام : إني مخلف فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا .
فأخبر عليه السلام بوجود قوم من آله مقارنين للكتاب في الوجود والحجة ، وذلك يقتضي عصمتهم ، ولأنه عليه السلام أمر بالتمسك بهم ، والأمر بذلك يقتضي مصلحتهم ، لقبح الأمر بطاعة من يجوز منه القبح مطلقا ، ولأنه عليه السلام حكم بأمان المتمسك بهم من الضلال ، وذلك يوجب كونهم ممن لا يجوز منه الضلال ، وإذا ثبتت عصمة المذكورين في الخبر ، ثبت توجه خطابه إلى أئمتنا عليهم السلام ، لعدم ثبوتها لمن عداهم أو دعواها له ، وذلك يقتضي إمامتهم من الوجهين المذكورين .
ومن ذلك : قوله عليه السلام : مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح ، من ركبها نجا ومن تخلف عنها وقع في النار.
وفي آخر : هلك .
وذلك يفيد عصمة المرادين ، لأنه لا يمكن القطع على نجاة المتبع مع تجويز الخطأ على المتبع ، وعصمة المذكورين تفيد توجه الخطاب إلى من عيناه وتوجب إمامتهم على الوجه الذي بيناه .
في أمثال لهذه الآيات والأخبار ، قد تكرر معظمها في رسالتي الكافية والشافية.
ومن ذلك : نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن الأئمة من بعده اثنا عشر عليهم السلام ، كقوله عليه السلام للحسين بن علي عليهما السلام : أنت إمام ، ابن إمام ، أخو إمام ، أبو أئمة حجج تسع تاسعهم قائمهم أعلمهم أحكمهم أفضلهم .
وقوله عليه السلام : عدد الأئمة من بعدي عدد نقباء موسى .
وخبر اللوح .
وخبر الصحائف .
وأمثال لهذه الأخبار الواردة من طريقي الخاصة والعامة ، مع علمنا بصحة ما تضمنه نقل الفريقين المتبائنين والطائفتين المختلفتين ، إذ كان لا داعي لمخالف المنقول إليه مع كونه حجة عليه إلا الصدق فيه .
وثبوت النص منه عليه السلام على هذا العدد المخصوص ينوب مناب نصه على أعيان أئمتنا عليهم السلام ، لأنه لا أحد قال بهذا في نفسه غيرهم وشيعتهم لهم ، فوجب له القطع على إمامتهم .
وأما الضرب الثاني من النص على أعيان الأئمة عليهم السلام ، فأفضلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام .
والنص ثابت عليه بشيئين :
أفعال ، وأقوال .
والأقوال على ضربين : كتاب ، وسنة .
والسنة على ضربين : معلوم من ظاهره المراد ومن دليله ، ومعلوم من دليله المراد .
فأما النص بالفعل : فمن تأمل أفعال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، واختصاصه به ، ومؤاخاته له ، وتقديمه على جميع الصحابة والقرابة في جميع الأحوال والأمور وتأميره في كل بعث ، وإفراده من التأمير عليه في شئ بقوله في المأمورين له : إني باعث فيكم رجلا كنفسي ، وتخصيصه في السكنى ، والتبليغ ، والصهر ، والدخول عليه بغير إذن ، وحمل الراية ، والمباهلة ، والمناجاة ، والأخوة ، والقيام له ، ورفع المجلس بما لم يشركه فيه أحد ، وما اقترن بهذه الأقوال من الأفعال المختصة له .
( وقوله ) في البعوث : إني باعث رجلا كنفسي .
وعلي مني وأنا منه .
وعلي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث ما دار .
وأنا وعلي كهاتين .
ومنزلك في الجنة تجاه من منزلي ، تكسى إذا كسيت وتحيى إذا حييت .
وأنت أول جاث للخصوم من أمتي .
وصاحب لوائي .
وساقي حوضي .
وأول داخل الجنة من أمتي .
وأبو ذريتي .
ولا يؤدي عني إلا رجل مني .
وعلي مني وأنا من علي .
وحربك حربي وسلمك سلمي .
ومن سب عليا فقد سبني ، ومن سبني فقد سمت الله ، ومن سب الله أكبه الله على منخره في النار .
وأمثال ذلك من الأقوال والأفعال التي يطول بها الكتاب .
علم كونه مؤهلا لخلافته عليه السلام ، كما يعلم مثل ذلك في ملك اختص رجلا وأبانه بالأفعال والأقوال من أتباعه هذا الضرب من الاختصاص .
وأما نص الكتاب على إمامته عليه السلام فأي كثيرة :
منها : قوله تعالى : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) ( 7 ) .
فأخبر سبحانه أن المقيمي الصلاة والمؤتي الزكاة في حال الركوع أولى بالخلق من أنفسهم ، حسب ما أوجبه بصدر الآية له تعالى ولرسوله ، ولا أحد من المؤمنين ثبت له هذا الحكم غير أمير المؤمنين علي عليه السلام ، فيجب كونه إماما للخلق ، لكونه أولى بهم من أنفسهم .
إن قيل : دلوا على أن لفظة ( وليكم ) تفيد الأولى بالتدبير ، وأنها لا تحتمل في الآية غير ذلك ، وأن الأولى بالتدبير مفترض الطاعة على من كان أولى به ، وأن المشار إليه بالذين آمنوا أمير المؤمنين عليه السلام .
قيل : برهان إفادة ولي لأولي ظاهر لغة وشرعا ، يقولون : فلان ولي الدم ، وولي الأمر ، وولي العهد ، وولي اليتيم ، وولي المرأة ، وولي الميت ، يريدون : أولى بما هو ولي فيه بغير إشكال .
وبرهان اختصاص ( وليكم ) في الآية بأولى : أن وليا لا يحتمل في اللغة إلا شيئين : المحبة ، والأولى .
ولا يجوز أن يريد بالولاية في الآية المحبة ، لأن قوله تعالى : ( إنما وليكم ) خطاب لكل مكلف بر وفاجر كسائر الخطاب ، وكونه خطابا عاما يمنع من حمله على ولاية المحبة والنصرة ، لأن الله تعالى ورسوله والمؤمنين لا يوادون الكفار ولا ينصرونهم ، بل الواجب فيهم خلاف ذلك ، فبطل كون المراد بالولاية في الآية المودة والنصرة على جهة الأخبار ولا الإيجاب .
ولأنه لا يخلو أن يكون خطابا لجميع الخلق برهم وفاجرهم ، أو الكفار خاصة ، أو لجميع المؤمنين دونهم ، أو لبعض المؤمنين .
وكونه خطابا للجميع أو للكفار خاصة يمنع من كون المراد بالولاية المودة والنصرة على ما بيناه .
ولا يجوز أن يكون خطابا لجميع المؤمنين ، لأن الآية تتضمن ذكر ولي ومتول ، وذلك يقتضي اختصاصها بالبعض .
وكونه خطابا لبعض المؤمنين يمنع من حمل الولاية على المودة والنصرة ، لعموم فرضها للجميع .
ولأن حرف ( إنما ) يثبت الحكم لما اتصل به وينفيه عما انفصل عنه بغير تنازع بين العلماء بلسان العرب .
كقوله تعالى : ( إنما إلهكم الله ) ( 8 ) أثبت الإلهية له ونفاها عمن عداه ، وكقوله : ( إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها ) ( 9 ) خص العبادة .
برب البلدة ونفاها عمن عداه ، وقوله : ( إنما أنت منذر ) ( 10 ) على هذا الوجه .
وقول النبي عليه السلام : إنما الأعمال بالنيات ، وقوله : إنما الماء من الماء ، وإنما الربا في النسيئة ، وإنما الولاء لمن أعتق ، كل ذلك يفيد إثبات الحكم للمتصل بحرف إنما ونفيه عن المنفصل ، إلا ما علم بدليل آخر : من إيجاب الغسل من غير الماء ، وثبوت حكم الربا في غير النسيئة .
وقول الفصيح : إنما لك عندي درهم ، وإنما الفصاحة في الجاهلية ، وإنما الحذاق البصريون ، على هذا النحو بغير إشكال .
وإذا تقرر ما ذكرناه ، فحرف ( إنما ) في الآية يفيد الولاية فيها لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين ، وينفيها عمن عداهم ، وذلك يمنع من حملها على ولاية المودة والنصرة المعلوم عمومها .
وإذا بطل أحد القسمين ثبت الآخر .
ولأن ( الذين آمنوا ) مختص ببعض المؤمنين من وجهين :
أحدها : وصفهم بإيتاء الزكاة ، وذلك يقتضي خروج من لا يخاطب بالزكاة أو خوطب ففرط على الصحيح من المذهب عن الآية .
الثاني : وصفهم بإيتاء الزكاة في حال الركوع في قوله : ( وهم راكعون ) ، لارتفاع اللبس من قول القائل : فلان يجود بماله وهو ضاحك ، ويضرب زيدا وهو راكب ، ويلقى خالدا وهو ماش ، في أنه لا يحتمل إلا الحال دون الماضي والمستقبل .
ومعلوم أن هذا حكم لم يعم كل مؤمن ، بل لا دعوى لاشتراك اثنين من المؤمنين معينين فيه .
وإذا ثبت الخصوص ، وكان كل من قال لخصوص المؤمنين في الآية قال باختصاص الولاية بالأولى ، لأن خصوصها يمنع من حملها على المودة والنصرة الواجبة على الجميع .
وبرهان إفادة الأولى للتدبير الأحق بالتصرف في المتولي للإمامة وفرض الطاعة ظاهر ، لأن هذا المعنى متى حصل بين ولي ومتول أفاد فرض الطاعة ، لأنه لا يكون أولى به وأملك بأمره منه بنفسه إلا لكونه مفترض الطاعة عليه ، إذ لا معنى لفرض الطاعة غير ذلك ، ووجوب ذلك للمذكور على جميع الخلق يفيد إمامته لجميعهم ، كإفادة قوله تعالى : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ ) ( 11 ) لذلك .
وبرهان اختصاص ( الذين آمنوا ) بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من طرق :
منها : وصف المذكور من إيتاء الزكاة في حال الركوع ، ولا أحد ادعى فيه ذلك غيره عليه السلام .
ومنها : أنا قد بينا اختصاص الحكم ببعض المؤمنين ، وكل من قال بخصوصه – ممن يعتد بقوله – خصها بعلي بن أبي طالب عليه السلام .
ومنها : قيام البرهان على أن الولاية في الآية تفيد الأولى ، وكل من قال بذلك خص بها عليا .
ومنها : تواتر الخبر من طريقي الشيعة وأصحاب الحديث بنزول الآية فيه عليه السلام عقيب تصدقه بالخاتم راكعا .
ومنها : احتجاجه عليه السلام بذلك على وليه وعدوه مع عدم النكير ، وارتفاع أسباب الامساك عنه عدا الرضى والتصديق .
ومنها : حصول العلم لكل متكامل الأخبار بأحواله وذريته ، لدعوى ذلك منه عليه السلام لنفسه ودعوى كافة ذريته ، وذلك يقتضي صدقه وصدقهم عليهم السلام ، إذ كونهم كاذبين على الله تعالى ورسوله عليه السلام ما لا يذهب إليه مسلم .
ولا قدح في شئ مما قدمناه بما رواه الشاذ من نزول الآية في ابن سلام .
لأنا لم نستدل بالاجماع فينا ، وإنما عولنا على تواتر الفريقين ، ولأن الإجماع مبني على دليل لا يقدح فيه إلا ما قدح فيه .
ولأنه لا يخلو أن يكون ابن سلام هو المتولى في الآية والمتولي ، ولا يجوز أن يكون المتولى على جهة الخصوص ، لأنه رجوع عن عموم الآية بغير دلالة ، ولأن ذلك يقتضي تخصص الولاية به ، والاجماع بخلاف ذلك على كلا المذهبين في ولاية الآية ، وإن كان متوليا مع غيره فلا ينفعهم ولا يضرنا .
ولا يجوز أن يكون متوليا على مذهب من قال إن الولاية فيها بمعنى المودة ، لأن ذلك يقتضي اختصاصها بابن سلام مع حصول الإجماع بعمومها ، ولا على مذهب من قال إنها بمعنى الأولى ، لأن ابن سلام لا يستحق ذلك بإجماع ، فلم يبق لتوجهها إليه خاصة وجه .
وليس لأحد أن يقدح بتضمن الآية لفظ الجمع ومدح المتصدق ووصفه بإيتاء الزكاة ، وعلي عليه السلام واحد وفقير وقاطع الصلاة بما فعله .
لأن العبارة عن الواحد بلفظ الجمع على جهة التعظيم ظاهر في العربية .
وكون علي عليه السلام فقيرا غير معلوم .
وإلقاؤه الخاتم في الصلاة من يسير العبث المباح فيها ، ولأن كثيره كان مباحا ، ولا طريق إلى العلم بتقدم فعله عليه السلام على النسخ من تأخره عنه ، ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدحه على فعله وتمدح هو عليه السلام به من غير منكر عليه ، وذلك يمنع من كونه مذموما .
ولأنا قد دللنا على اختصاص الآية به بما لا محيص عنه ، مع تضمنها تعظيم المذكور فاقتضى ذلك سقوط جميع ما قدحوا به .
ولأن مدح المذكور فيها عن فعل تقدم ووصفه فيه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة راكعا تعريف له وتمييز من غيره ، وهذا واضح والمنة لله .
ومنها : قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) ( 12 ) .
فأوجب سبحانه تعالى طاعة أولي الأمر على الوجه الذي أوجب طاعته تعالى وطاعة رسوله بمقتضى العطف الموجب لإلحاق حكم المعطوف بالمعطوف عليه ، وقد علمنا عموم طاعته سبحانه وطاعة رسوله في الأعيان والأزمان والأمور فيجب مثل ذلك لأولي الأمر بموجب الأمر ، وذلك يقتضي توجه الخطاب بأولي الأمر إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، لأن لا أحد قال بعموم طاعة أولي الأمر إلا خص بها عليا عليه السلام والأئمة من ذريته عليهم السلام .
وإذا عمت طاعته الأمة والأزمان والأمور ثبت كونه إماما ، لإجماع الأمة على إمامة من كان كذلك وعدم استحقاقه لغيره .
وليس لأحد أن يقول : إنا لم نعلم عموم طاعته سبحانه ورسوله بالآية ، وإنما علمناه بدليل آخر ، فدلوا على مشاركة أولي الأمر فيه بدليل غير الآية ليسلم لكم المراد .
لأن إطلاق لفظ الطاعة وتوجه الخطاب بها إلى المخاطبين كافة الحاضرين والمتجددين إلى يوم القيامة يفيد عمومها لجميعهم في كل حال وأمر ، وإن لم يكن هناك دليل على هذا العموم غير هذا الظاهر لأنه لو أراد تعالى خاصا من المخاطبين أو الأزمان أو الأمور لبينه ، فيجب الحكم بعموم ما قلناه ، ولا يجوز تخصيص شئ منه إلا بدليل .
وأيضا فحصول العلم بعموم طاعته تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير الظاهر لا يقدح في استدلالنا ، لأن الظاهر إذا دل على ما قلناه كان مطابقا لما تقدم العلم به من عموم طاعته تعالى ورسوله ، واستفاد المخاطب مشاركة أولي الأمر له تعالى ولرسوله في عموم الطاعة بمقتضى العطف ، سواء كان ذلك معلوما بالظاهر أو بغيره .
ولم يجز تخصيص طاعتهم بغير دليل ، وإن كان الأول معلوما من وجهين والثاني معلوما من وجه واحد ، ومجري ذلك مجرى حكيم قال لأصحابه تقدم لهم العلم بعموم طاعة بعض خواصه عليهم : أطيعوا فلانا – وأشار إليه – الطاعة التي تعدونها ، وفلانا ، وأشار إلى من لم يتقدم لهم العلم بحاله ، في وجوب مشاركة الثاني للأول في الطاعة وعمومها بغير إشكال .
ترتيب آخر : الأمة في أولي الأمر رجلان :
أحدهما يخص بها أمراء السرايا ، وهم أمراء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي .
والآخر يخص بها عليا وذريته عليهم السلام المذكورين وبحكم بها على إمامتهم .
وإذا بطل أحد القولين ثبت الآخر ، ولا يجوز توجهها إلى أمراء السرايا من وجوه :
أحدها : أن ظاهرها يفيد عموم الطاعة من كل وجه ، وطاعة أمراء السرايا مختصة بالمأمورين لهم وبزمان ولايتهم وبما كانوا ولاة فيه ، فطاعتهم على ما ترى خاصة من كل وجه ، وما تضمنه الآية عام من كل وجه .
ومنها : أنه سبحانه وصف أولي الأمر بصفة لم يدعها أحد لأمراء السرايا ، فقال : ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) ( 13 ) فحكم تعالى بكون أولي الأمر ممن يوجب خبره العلم بالمستنبط ، وحال أمراء السرايا بخلاف ذلك .
ومنها : أن صحة هذه الفتيا مبنية على صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان ، وفيما مضى لنا ويأتي من الأدلة ما يقتضي فساد إمامتهم ، ففسد لذلك ما صحته فرع صحتها .
ومنها : أنه تعالى أطلق طاعة أولي الأمر كطاعته تعالى ورسوله ولم يخصها بشئ ، وذلك يقتضي عصمتهم ، لأن تجويز القبيح على المأمور بطاعته على الإطلاق يقتضي الأمر بالقبيح أو إباحة ترك الواجب من طاعته ، وكلا الأمرين فاسد ، ولا أحد قطع بعصمة أمراء السرايا ، فبطل توجه الآية إليهم .
ترتيب آخر : إطلاق طاعة أولي الأمر يقتضي عصمتهم ، لقبح الأمر مطلقا بطاعة مواقع القبيح ، ولا أحد قال بعصمة أولي الأمر إلا خص بها عليا والطاهرين من ذريته عليهم السلام .
ومنها : قوله تعالى : ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ) ( 14 ) .
فنفى سبحانه أن ينال الإمامة ظالم ، وهذا يمنع من استحق سمة الظلم وقتا ما من الصلاح للإمامة ، لدخوله تحت الاسم المانع من استحقاقها .
وأيضا فإنه سبحانه أخبر بمعنى الأمر أن الظالم لا يستحقها ، وخبره متعلق بالمخبر على ما هو به ، فيجب فساد إمامة من يجوز كونه ظالما ، وذلك يقتضي وقوف صلاحها على المعصوم ، ويوجب فساد إمامة أبي بكر وعمر وعثمان والعباس ، لوقوع الظلم منهم ، ولعدم القطع على عصمتهم ، وإذا بطلت إمامة هؤلاء ثبتت إمامة علي عليه السلام ، لأنه لا قول لأحد من الأمة خارج عن ذلك .
وتبطل إمامتهم من الآية : بأن جوابه تعالى بنفي الإمامة عن الظالم خرج مطابقا لسؤال إبراهيم عليه السلام ، وذلك يقتضي اختصاصه لمن كان ظالما ثم تاب ، لقبح سؤال الإمامة للكافر في حال كفره ، ووقوع الكفر من هؤلاء معلوم ، فيجب دخولهم تحت النفي .
وليس لأحد أن يقدح في بعض ما مضى : بأن التائب من الظلم لا يكون ظالما .
لأن ظالما من أسماء الفاعلين في اللغة كقاتل وضارب ، وليس باسم شرعي ، والأسماء المشتقة من الأفعال ثابتة بعد التوبة كثبوتها قبلها ، يقولون :
هذا قاتل زيد وضارب عمرو وخاذل علي وإن تابوا مما اقترفوه ، ولو كان من أسماء الشرعية لقبح هذا الإطلاق بعد التوبة كفاسق وكافر .
ولأن العرب ما تصف فاعل الضرر الخالص بظالم كما تصفه الشريعة ، ولو كان منقلا يجري مجرى مصل ومزك ، لاختصاصه بعرف الشرع كذين الإسمين ، وإقرار الشريعة له على أصل الوضع يسقط الشبهة ، لأنها مبنية على قبح الوصف به بعد التوبة ، وما قررته الشريعة من الأسماء على أصله لا يجوز سلبه للتائب بلا خلاف بين العلماء بأحكام الخطاب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) النحل 16 : 43 ، الأنبياء 21 : 7 .
( 2 ) التوبة 9 : 119 .
( 3 ) النساء 4 : 83 .
( 4 ) النساء 4 : 41 .
( 5 ) النحل 16 : 89 .
( 6 ) البقرة 2 : 143 .
( 7 ) المائدة 5 : 55 .
( 8 ) طه 20 : 98 .
( 9 ) النمل 27 : 91 .
( 10 ) الرعد 13 : 7 .
( 11 ) الأحزاب 33 : 6 .
( 12 ) النساء 4 : 59 .
( 13) النساء 4 : 83 .
( 14 ) البقرة 2 : 124 .
المصدر: تقريب المعارف / الشيخ أبو صلاح الحلبي