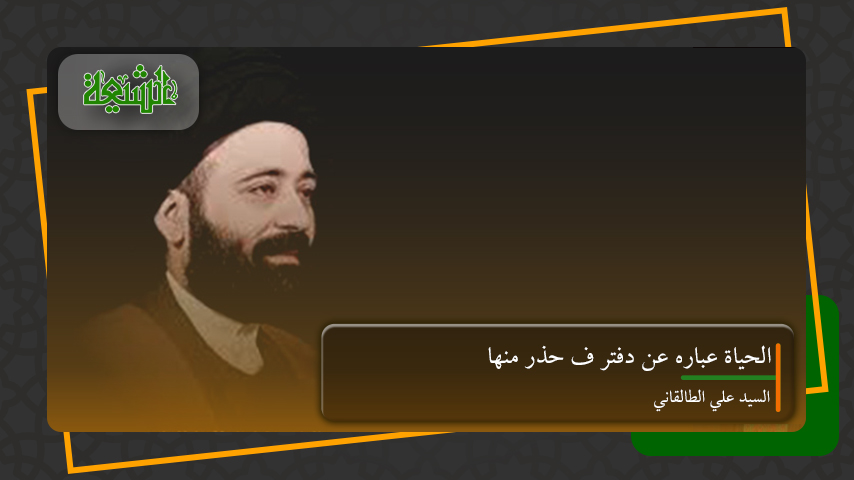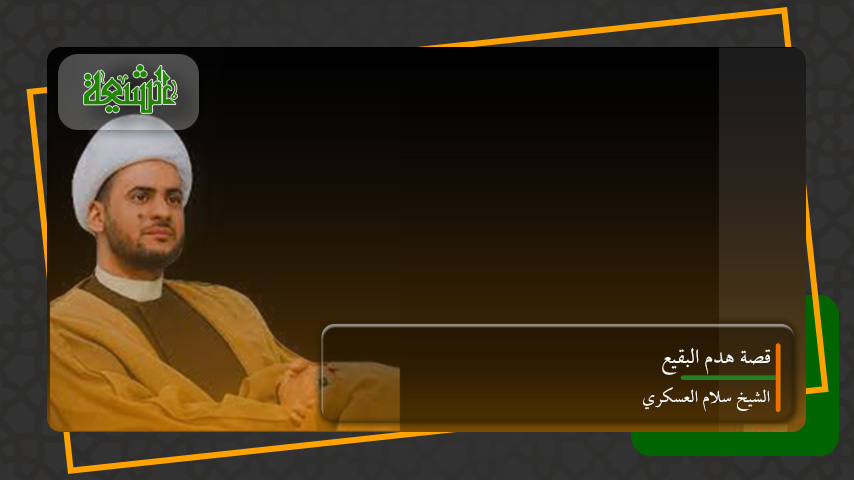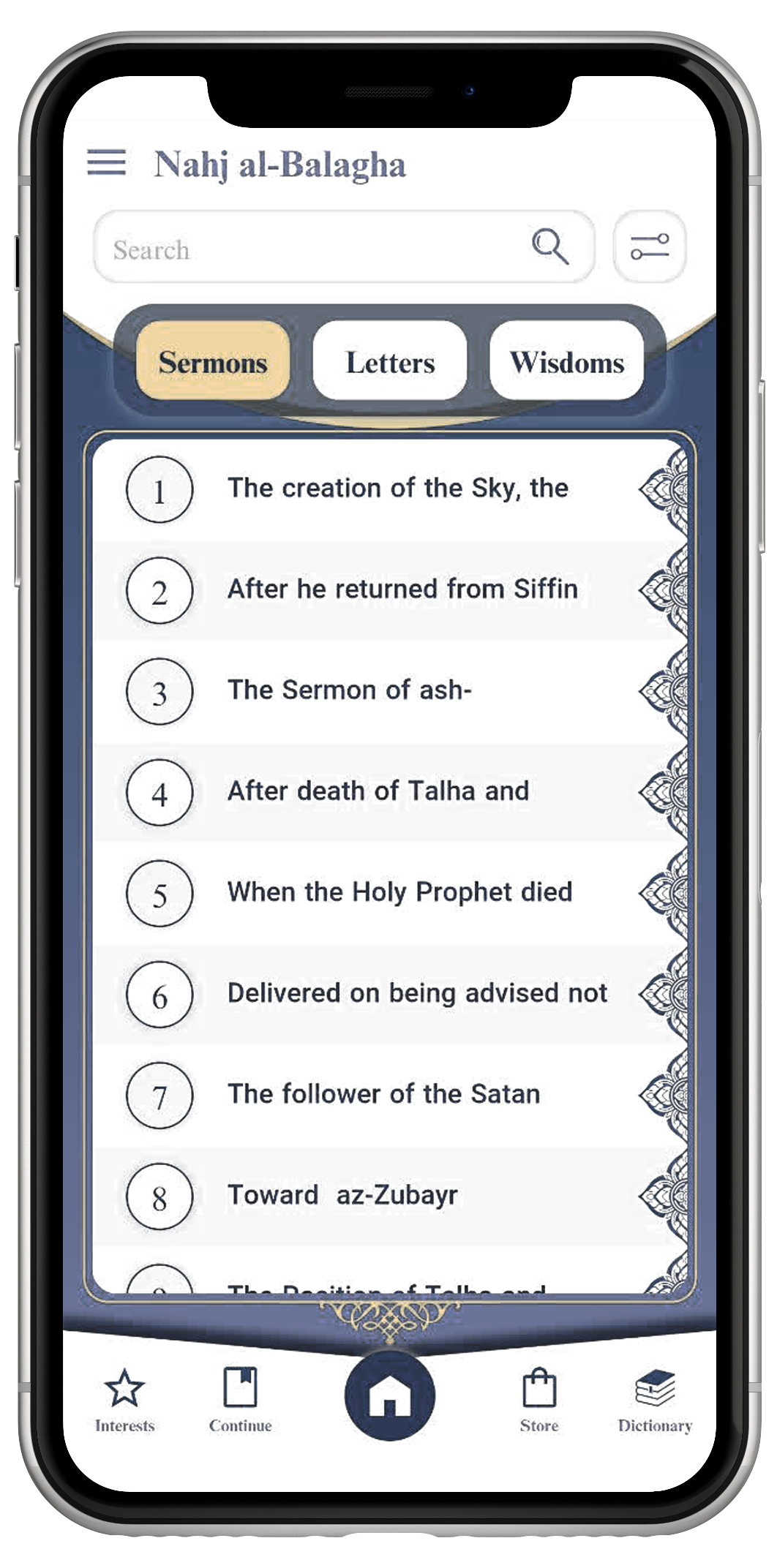وهذا الصدقُ عهدٌ منك وعليك، لأنه روح الجمال والحق، وإرادةُ الحياةِ القادرةِ الغلاّبة!
لعلَّ أبرز مظاهر العدالة الكونية في عالم الجماد وعالم الحياة، وفي كل ما يتَّصل بطبيعة الوجود وخصائص الموجودات، هو الصدق الخالص المطلق. فعلى الصدق مدارُ الأرض والفلك والليل والنهار. وبالصدق وحده تتلاحق الفصول الأربعة ويسقط المطر وتسطع شمس. وبه كذلك تفي الأرض بوعدها حين تُنبت ما عليها كلاٍّ في حينه لا تقديمَ ولا تأخير.
وبه تقوم نواميس الطبيعة وقوانين الحياة. والريح لا تجري إلا صادقة، والدماء لا تطوف العروقَ إلا بصدق، والأحياء لا يولدون إلا بقانون صادق أمين. هذا الصدق الخالص المطلق الذي تدور عليه قاعدة البقاء، هو الينبوع الأول والأكبر الذي تجري منه عدالة الكون وإليه تعود! ولمّا كان عليّ بن أبي طالب شديد الملاحظة لصدق الوجود، شديد التفاعُل معه، فقد جعل من همّه الأوّل في الناس تهذيبَ الناس استناداً إلى ما يعقل ويحسّ ويرى. والتهذيب في معناه الصحيح ومدلوله البعيد ليس إلاّ الإحساس العميق بقيمة الحياة وشخصيّة الوجود. ولمّا كان هذا المعنى هو المعنى الأوحد للتهذيب العظيم، كان الصدق مع الذات ومع كلّ موجود مادّيٍ أو معنويّ، هو المحور الذي يدور عليه التهذيب، كما رأيناه محور العدالة الكونية.
وبذلك ينتفي من التهذيب السليم كثيرٌ من القواعد التي تَوَاطأ عليها البشرُ دونما نظرٍ في نواميس الوجود الكبرى، وهم يحسبون أنّها قواعد تهذيبيّة لمجرّد اتّفاقهم عليها. وبذلك أيضاً ينتفي من التهذيب السليم كلُّ ما يخالف روحَ الحقّ وروحَ الخير وروحَ الجمال. والتهذيب على غير أصوله الكبرى تَواطؤٌ سطحيّ على الكذب القبيح. وهو على أصوله البعيدة إحساسٌ عميق بالصدق الجميل، ممّا يجعله اندماجاً خالصاً بثوريّة الحياة الجارية الفاتحة. لذلك كان مدار التهذيب عند ابن أبي طالب، حماية الإنسان من الكذب، أو قُلْ حمايته وهو حيٌّ من برودة الموت! وحماية الإنسان من الكذب تستوجب أولَ الأمر تعظيمَ الصدق نصّاً مباشراً في كلّ حال، وإبرازَه ضرورةً حياتيّةً لا مفرّ منها لكل حيِّ، وتوجيهَ الناس نحوه أفراداً يَخْلُون إلى أنفسهم أو يعيشون جماعات.
وفي هذا الباب يبرز عليّ بن أبي طالب عملاقاً يرى ما لا يراه الآخرون، ويشير إلى ما يجهلون، ويعمل ما لا يستطيعونه الآن ويريدهم أن يستطيعوه. يقول عليّ: (إيّاكم وتهزيعَ الأخلاق وتصريِفَها واجعلوا اللسانَ واحداً). وتهزيع الشيء تكسيره. وتصريفه قلْبُه من حال إلى حال. يريد بذلك تذكيرَ الصادق بالخطر الذي يتعرّض له صدقُه إنْ هو كذب ولو مرّةً واحدة. فالصادق إذا كذب مرةً انكسر صدقه كما ينكسر أيّ شيء وقع على الأرض مرةً واحدة. وكذلك النفاق والتلوّن فهما لونان من ألوان الكذب.
ويقول أيضاً: (وكونوا قوماً صادقين. واعملوا في غير رياء. وأعَزّ الصادقَ المحقّ وأذَلّ الكاذبَ المبطل. واصدُقوا الحديث وأدّوا الأمانة وأوفوا بالعهد. من طلب عزاً بباطل أورثه الله ذلاً بحق. إن كنت صادقاً كافيناك وإن كنت كاذباً عاقبناك. إنّ مَن عدمَ الصدق في منطقه فقد فُجع بأكرم أخلاقه. ما السيف الصارم في كفّ الشجاع بأعزّ له من الصدق). وما هذه الآيات في الصدق إلاّ نماذج من مئاتٍ أُخرَيات يؤلف ابنُ أبي طالب بها أساسَ دستوره الأخلاقي العظيم. ثم إليك هذه الآية التي يكثر في نسجها نصيبُ العقل النافذ الواعي. يقول: (الكذب يهدي إلى الفجور). ولسنا في حاجة إلى الإسهاب في إظهار ما تخفي هذه الكلمة من حقيقة تجرّ وراءها سلسلة لا تنتهي من الحقائق. كما أننا لسنا في حاجة إلى الإسهاب في تصوير ما تشير إليه من حقيقة نفسية لا تزيدها الأيام إلا رسوخاً.
ومثل هذه الآية آيات، منها: (لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ولا أنْ يَعِدَ أحدُكم صبيَّه ثم لا يفي له!) أما المعنى الذي يشير إليه الشق الأول من هذه الآية العلوية، فقد كان موضوع جدل كثير بين فلاسفة الأخلاق ولاسيما الأوروبيين منهم.
والواقع أن هؤلاء أجمعوا على أن الصدق حياة والكذب موت. غير أنهم اختلفوا في هل يجوز الكذب في حالة الضرورة أم لا؟ فمنهم الموافق ومنهم المخالف. ولكلٍّ من الفريقين حجته. أمّا عليّ بن أبي طالب، فيقف من هذا الموضوع الذي تثيره عبارته، موقفاً حاسماً ينسجم مع مذهبه العظيم في الأخلاق، هذا المذهب الذي نعود فنذكّر القارئ بأنه منبثقٌ عمّا أحسّه عليّ ووعاه من عدالة الكون الشاملة، فيقول غير متردّد: (علامة الإيمان أن تُؤْثر الصدقَ حيث يضرّك على الكذب حيث ينفعك، وأن لا يكون في حديثك فضلٌ عن عملك!) ومن الواضح أن ابن أبي طالب لا يرى أن في الكذب ما ينفع وأن في الصدق ما قد يضرّ، فيتحدث إلى الناس في نطاقٍ من مدى تصوُّرهم ليبلغ كلامُه منهم مبلغاً ذكياً. وتأكيداً لذلك يقول: (عليك بالصدق في جميع أمورك). ويقول أيضاً: (جانبوا الكذب فإن الصادق على شَفَا مَنْجاة وكرامة، والكاذب على شَفَا مَهْواةٍ وهلكة!).
أما المعنى الذي يذكره الشقّ الثاني من العبارة: (ولا أنْ يعد أحدُكم صبيّه ثم لا يفي له)، فالتفاتةٌ عظيمة إلى حقيقةٍ تربويّة تقرّرها الحياةُ نفسها، كما تقرّرها الأصولُ النفسية التي ينشأ عليها المرء ويتدرّج. ويكفيك منها هذه الإشارة إلى أن الطفل يتربَّى بالمثَل – القدوة – لا بالنصيحة. وهذا الرأي هو محور فلسفة جان جاك روسّو التربويّة! والصدق مع الحياة يستلزم البساطة وينفر من التعقيد، لأن كل حقيقة هي بسيطة بمقدار ما الشمس ساطعة والليل بهيم. ودلالةً على هذه البساطة الدافئة لأنها انبثاقٌ حيّ وعفوي عن الصدق، نقول إن ابن أبي طالب كرهَ التكبر لأنه ليس طبعاً صادقاً بل الكبْر هو الصدق، فإذا بالمتكبر في رأيه شخصٌ يتعالى على جبلته ذاتها. يقول: (لا تكونوا كالمتكبر على ابن أمه).
وهو في الوقت نفسه يكره التواضع إذا كان مقصوداً فإنه عند ذاك لا يكون طبعاً صادقاً بل الشعور بأن الإنسان مساوٍ لكل إنسان في كرامته هو الصدق. لذلك يخاطب مَن يقوده تواضعُه إلى أن يذلُ نفسه، قائلاً له: (إياك أن تتذلّل للناس). ثم يردف ذلك بقول أروع: (ولا تَصْحَبَنَّ في سفرٍ مَن لا يرى لك من الفضل عليه مثلَ ما ترى له من الفضل عليك!). وإني لا أعرف في مبادئ المحافظين على كرامة الإنسان كإنسان لا يتكبر ولا يتواضع بل يكون صادقاً وحسب، ما يفوق هذه الكلمة لابن أبي طالب أو ما يساويها قيمةً: (الإنسان مرآة الإنسان!). ومن أقواله الدالّة على ضرورة أخْذ الحياة أخذاً بسيطاً: (ما أقبح الخضوع عند الحاجة والجفاء عند الغنى. الثناء بأكثر من الاستحقاق مَلَقٌ والتقصير عن الاستحقاق عيّ أو حسد.
لا تقل ما لا تعلم. لا تعمل الخير رياءً ولا تتركه حياء. يا ابن آدم، ما كسبتَ فوق قوتك فأنت فيه خازنٌ لغيرك. لا ينصف للخير ليفخر به، ولا يتكلّم ليتجبّر على من سواه. مَن حمّل نفسه ما لا يُطيق عجز. لا خير في معينٍ مهين). وكأنّي بابن أبي طالب لا يترك جانباً ممّا وعاه فكرُه وشعورُه من أمور الحياة والإنسان إلاّ أطلق فيه رائعةً تختصر دستوراً كاملاً. وهذا ما فعله ساعة شاءَ أن يوجّه الناس إلى أخذ الحياة أخذاً صادقاً بسيطاً، فقال هذه الكلمة الدافئة بعفْويّة الحياة: (إذا طَرقَك إخوانك فلا تدّخر عنهم ما في البيت، ولا تتكلّف لهم ما وراء الباب!).
وإذ يفرغ عليّ من حديثه الكثير الدائر حول ضرورة الصدق مع الحياة بصورةٍ مباشرة، ثم حول البساطة التي لا يكون صدقٌ بدونها ولا تكون بغير صدق، يواصل طريقه في مفاهيم التهذيب التي تتلازم في مذهبه وتترابط حتى لكأنّها صورةٌ عن كلّ موجودات الكون، والتي يظلّ الصدقُ مدارَها الأوّلَ وإن تناولتْ وجوهاً أخرى من وجوه الأخلاق. فيوصي بأن يتغافل المرءُ عن زلاّت غيره فإنّ في ذلك رحمةً من المتغافل وتهذيباً للمسيء بالسيرة والمثَل أبلغَ من تهذيبه بالنصيحة أو بالبغضاء، يقول: (من أشرف أعمال الكريم غفلتُه عمّا يعلم). كما يوصي بالحلم والأناة لأنهما نتيجةٌ لعلوّ الهمّة ثمّ مَدْرَجَةٌ لكرَم النفس: (الحلم والأناة توأمان ينتجهما علوّ الهمّة). ويكره الغيبة لأنها مذهبٌ من النفاق والإساءة والشرّ جميعاً: (اجتنب الغيبة فإنّها إدام كلاب النار).
والخديعة مثل الغيبة وكلتاهما من خبث السرائر: (إيّاك والخديعة فإنّها من خلق اللئام). وكما رأى أنّ كذبةً واحدةً لا تجوز لأنّ الصدق ينكسر بها، يرى أن كل ذنبٍ مهما كان في زعم صاحبه خفيفاً قليل الشأن إنّما هو شديدٌ لأنه ذنبٌ، بل إنه أشدّ وقعاً على كرامة الإنسان إذا استخفّ به صاحبه، من ذنبٍ عظيمٍ عاد مقترفُه إلى الرجوع عنه في الحال: (أشدّ الذنوب ما استخفّ به صاحبه). وينهاك علي عن التسرّع في القول والعمل لأنه مدعاةٌ إلى السقوط وعلى الإنسان المهذّب ألاّ يُبيح نفسَه لأيّة سقطة: (أنهاك عن التسرّع في القول والعمل). وهو يريدك أن تعتذر لنفسك من كلِّ ذنب أذنبتَ إصلاحاً لخلقك، ولكنّه ينبّهك تنبيهاً عبقريَّ الملاحظة والبيان إلى أنّ الإنسان لا يعتذر من خير، فعليه إذن ألاّ يفعل ما يضطّره إلى الاعتذار: (إياك وما تعتذر منه فإنه لا يُعتَذَر من خير. ومنعاً للاشتغال بعيوب الناس وإغفال عيوب النفس، وفي ذلك ما يدعو إلى سوء الخلق والمسلك سلباً وإيجاباً، يقول علي: (أكبر العيب أن تعيب ما فيك مثله)، و(مَن نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره).
وإذا أتى القبيح من مصدر عليك أن تُنكره أوّلاً، فإن لم تستطع ذلك تحَتّم عليك ألاّ تستحسنه لئلاً تصبح شريكاً فيه: (مَن استحسن القبيح كان شريكاً فيه). وإذا كان التعاطف بين الناس ضرورةً أخلاقية لأنه ضرورةٌ وجودية على ما مرّ معنا في الفصل السابق، فإنّ منطق العقل والقلب يأمر بأن يكون عطفك على من أنطقك وأحسن إليك أكثرَ وأوسع. وفي ذلك يقول عليّ: (لا تجعلنّ ذربَ لسانك على من أنطقك وبلاغةَ قولك على من سدّدك). ثم يقول: (وليس جزاء من عظّم شأنك أن تضع من قدره، ولا جزاء مَن سرّك أن تسوءه).
ويهاجم الحرص والكبرياء والحسد لأنّها سبيلٌ إلى الانحدار الخلقي: (الحرص والكبر والحسد دواعٍ إلى التقحّم في الذنوب). وإذا كان الأخلاقيون القدماء يذمّون البخل فلأنه في نظرهم صفةٌ مذمومةٌ لذاتها. أمّا عند ابن أبي طالب الذي يرصد الأخلاق بنظرةٍ أشمل وفكرٍ أعمق، فالبخل ليس مذموماً لذاته قدر ما هو مذموم لجمعه العيوب كلّها، ولدفْعه صاحبَه إلى كل سوءة في الخلق والمسلك. فالبخيل منافق، معتدٍ، مغتاب، حاسد ذليل، مزوّر، جشع، أناني، غير عادل. يقول علي: (البخل جامع لمساوئ العيوب). ويطول بنا الحديث ويتّسع إذا نحن شئنا أن نورد تفاصيل مذهب ابن أبي طالب في الأخلاق وتهذيب النفس، فهي كثيرةٌ لم تترك حركةً من حركات الإنسان إلاّ صوّرتْها ووجّهتْها. وإذا قلتُ إن مثل هذا العمل طويلٌ واسعٌ شاقّ فإنّي أعني ما أقول.
وما على القارئ إلاّ أن يطّلع على الروائع التي أخذناها من أدب ابن أبي طالب في هذا الكتاب، حتى يثق بأنّ المجلّدات قد تضيق عن دراسة مذهبه في الأخلاق وتهذيب النفس، وعمّا تستوجبه هذه المختارات من شرحٍ وتعليق. ويكفي أن نشير إلى أنّ هذه الروائع العلويّة من أشرف ما في تراث الإنسان، ومن أعظمه اتّساعاً وعمقاً. على أنه لابد لنا الآن من التلميح إلى آية الآيات في التهذيب العظيم بوصْفه إحساساً عميقاً بقيمة الحياة وكرامة النفس وكمال الوجود.
وإنّ نفراً قليلاً من المتفوّقين كبوذا والمسيح وبتهوفن وأشباههم هم الذين أدركوا أنّ آية التهذيب إنّما تكون في الدرجة الأولى بين الإنسان ونفسه. ولا تكون بين الإنسان وما هو خارجٌ عنه إلاّ انبثاقاً بديهيّاً طبيعيّاً عن الحالة الأولى. وقد أدرك ابنُ أبي طالب هذه الحقيقة إدراكاً قويّاً واضحاً لا غموضَ فيه ولا إبهام. وعبّر عنها تعبيراً جامعاً. يقول عليّ في ضرورة احترام الإنسان نفسَه وأعماله دون أن يكون عليه رقيب: (اتَّقوا المعاصي في الخلوات). ويقول في المعنى ذاته: (إيّاك وكلّ عملٍ في السرّ يُستحى منه في العلانية. وإيّاك وكلّ عملٍ إذا ذُكر لصاحبه أنكره). وإليك ما يقوله في الرابطة بين السرّ والعلانية، أو بين ما أسميناه (آية التهذيب) وما أسميناه (انبثاقاً) عنها: (مَن أصلح سريرتَه أصلح الله علانيّته). ومن بدائع حكيم الصين كنفوشيوس في تهذيب النفس هذه الكلمة: (كلْ على مائدتك كأنك تأكل على مائدة ملك). وجليٌّ أنه يريد منك أن تحترم نفسك احتراماً مطلقاً غير مرهون بظرف أو مناسبة، حتى ليجدر بك أن تتصرف حين تخلو إلى نفسك كما تتصرف وأنت بين يدي ملك.
ومثل هذا المعنى يقوله علي بن أبي طالب على هيئة جديدة: (ليتزيّنْ أحدكم لأخيه كما يتزيّن للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة!). وهو يريدك في كلِّ حال أن تعظ أخاك لتعينه في الانتقال من حَسَنٍ إلى أحسن في الخلق والذوق والمسلك. ولكنّ روح التهذيب الأصيل يأبى عليك أن تجرحه أو تؤذيه بنُصحه علناً، بل إنّ هذا الروح يقضي عليك أن تكون ليّناً رفيقاً فلا تنصح إلاّ خفيةً ولا تعِظ إلاّ سراً. يقول علي: (مَن وعظ أخاه سرّاً فقد زانه، ومَن وعظَه علانيةً فقد شأنه). وأيّةً كانت حالك فعليك أن تصدق مع نفسك والحياة والناس.
فبهذا الصدق تحيى وبغيره تهلك. وبه تحفظ سلامةَ روحك وقلبك وجسدك. وبغيره تفقدها. وبالصدق تُحِبّ وتُحَبّ ويوثَق بك، وبغيره تجلب لنفسك المقْتَ والكراهية والسّيئاتِ جميعاً وير ذلك الناس تافهاً حقيراً. وهذا الصدق عهدٌ منك وعليك لأنه إرادة الحياة القادرة الغلاّبة وهي إرادةٌ تقضي عليك بأنّ تنظر في عهدك كلّ يوم. وابنُ أبي طالبٍ يقول: (على كلّ إنسان أن ينظر كلّ يومٍ في عهده!).