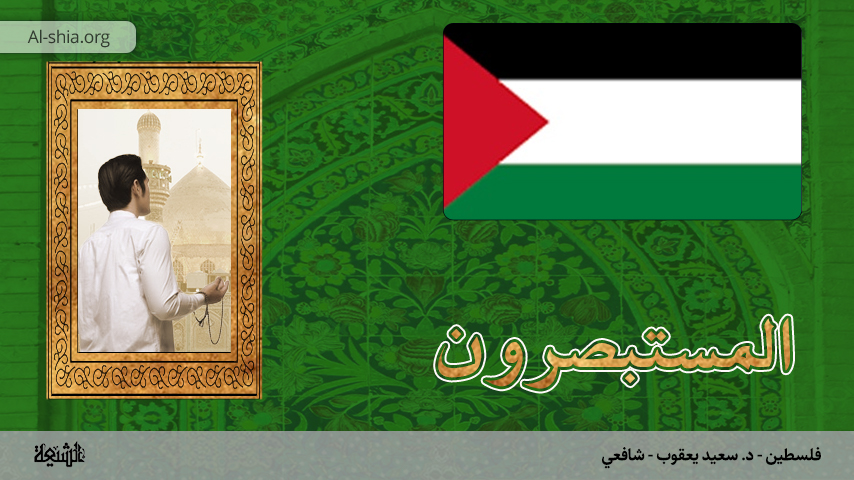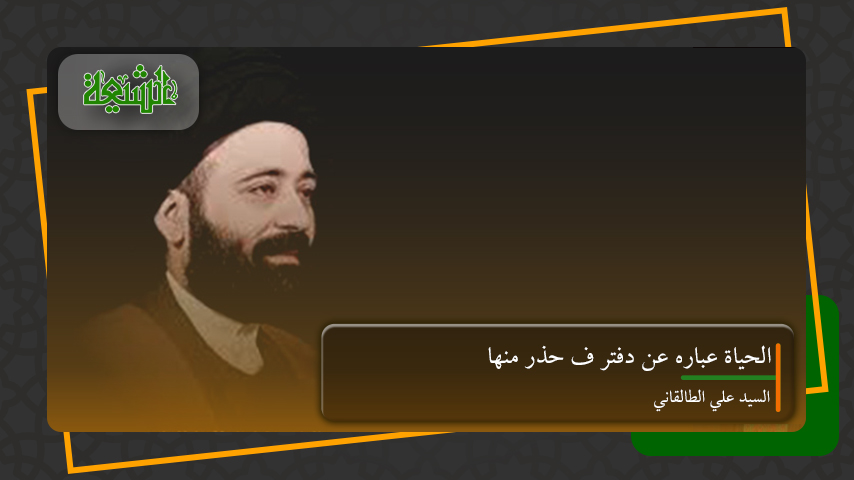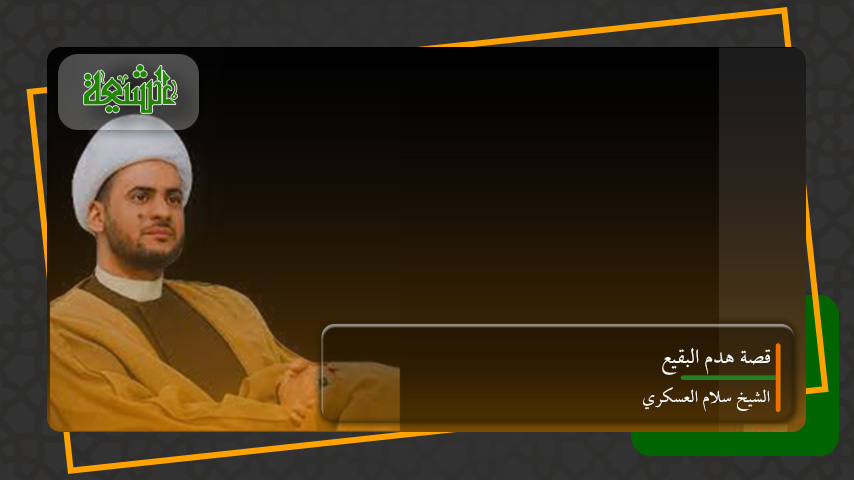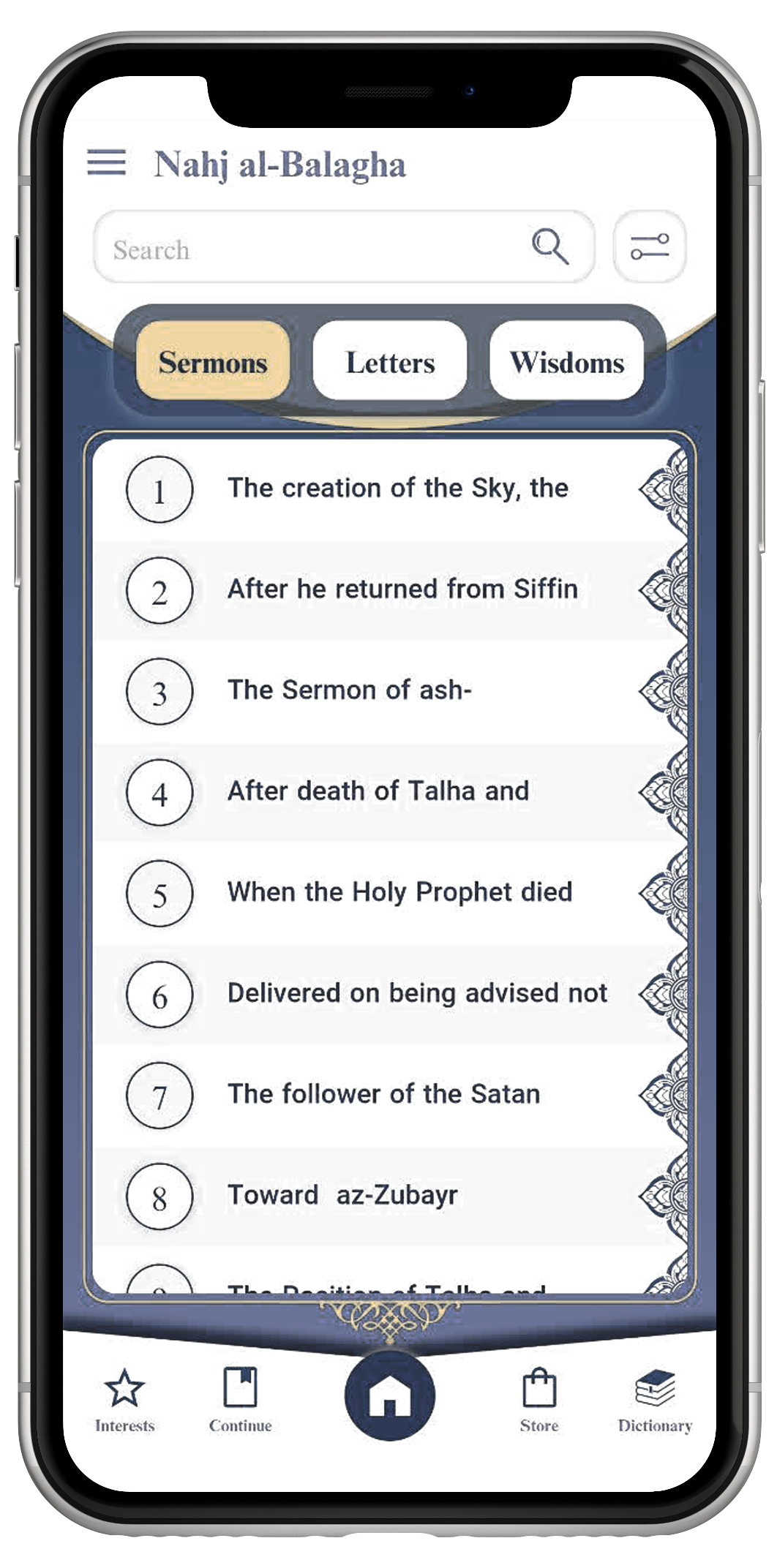المولد والنشأة
ولد عام ۱۹۴۷ في عكا بفلسطين من أسرة الحجازي التي هاجر جدّها عام ۱۸۹۹م من الحجاز، وهي أسرة تنسب إلى الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) ، ثمّ واصل الدكتور دراسته الأكاديمية حتى نال شهادة الدكتوراه في الفلسفة من امريكا، كما درس الطبّ أيضاً حتى اصبح طبيباً متخصصاً بالأمراض العصبية والنفسية.
وللدكتور سعيد يعقوب نشاطات أخرى منها أنّ له (۱۴) كتاباً مطبوعاً عدا المقالات، كما أنّه عضو في اتحاد الكتاب العرب وعضو في جمعية البحوث والدراسات وعضو مؤسس في اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين بدمشق.
نشأ في اسرة تعتنق المذهب السني فبقى على هذا الانتماء حتى أخذت الأدلة التي حصل عليها عبر البحث يده عام ۱۹۸۹م فادخلته في مذهب التشيع الامامي الاثني عشري.
منطلقاته في البحث:
يرى الدكتور سعيد يعقوب أنّ الفكر ينبغي أن يتمتّع بالحيوية، ويقصد بذلك أن يكون الجانب الجدلي فعّالا في بنية المعتقد الاسلامي وأن يكون الفكر متوثباً لا يركن إلى الجمود.
ويرى أيضاً أن من الخطأ أن يكون فكر الانسان محدداً بأطر لا يمكن تجاوزها أو الحيد عنها، لأنّ ذلك يؤدي إلى اقفال العقل، وهذا ما يمنع المرء من التقدّم العلمي والتقني في جميع الساحات.
ويرى الدكتور سعيد يعقوب أيضاً أن عقل كل انسان ينبغي أن يكون عقل مدقّق فاحص باحث عن المعرفة سائر إلى تطبيق مناهجه في كل زمان، وعلى كل أرض.
ومن هذا المنطق بدأ الدكتور سعيد يعقوب بحثه في جميع الأصعدة الدينية وغيرها، وبهذا المنهج سار في بحثه حتى بلغ المجال المذهبي ليحصل على العقائد المستندة إلى الأدلة والبراهين، فبحث في بطون الكتب وقارن بين أدلة المذاهب الاسلامية، وحاور ذوي الخبرة والاختصاص، ولم يفتر في بحثه قط، لأنّه رأى أنّ الخير كل الخير في استمرار المباحثات بين المسلمين، ورأى أنّ الخطأ كل الخطأ في اقفال بابها، والجام حوارها، لأن البحث معين يروى ظمأ المتعطش لمعرفة الحقيقة، وجنّة تورف بظلالها، وتكثر ثمارها وينبعث النفع منها كالريح الطيبة العطرة.
نبذة للتقليد الأعمى:
توجه الدكتور سعيد يعقوب إلى البحث، وهو يعتقد أنّ التقليد الأعمى وتلقي موروث الآباء والأجداد بلا تدقيق ولا تمحيص هو من أكبر العوائق التي تقطع طريق الباحث وتمنعه من التعرّف على الحقيقة، لأنّ الذين يصنع لهم آباؤهم منهجاً أو قيماً أو انظمة بلغت مراتب اعتقدوا أنّها هي الدين الذي لا ينبغي الحيد عنه، فإن هؤلاء لا يمتلكون القدرة على البحث، لأن هؤلاء قد تعوّدوا الاقتباس من الغير دون عناء الفحص والتدقيق، فلهذا تكون قدراتهم خاملة في مجال البحث.
فلهذا نبذ الدكتور سعيد يعقوب التقليد الأعمى لموروثاته العقائدية، وتجرّد عن كل عاطفة تربطه بالمعتقدات التي شبّ عليها، وتوجه إلى البحث بموضوعية تامة لترشده الأدلة والبراهين إلى الصواب.
اهتمامه بمبحث الإمامة:
إن مبحث الإمامة كان من أهم الأبحاث التي عنى بها الدكتور سعيد يعقوب، لأنه رأى أنّ الإمامة تشكّل دوراً اساسياً في حياة المسلمين، وأن البحث عنها في الواقع قد شغل مساحة كبرى في الفكر البشري عموماً ومنذ أقدم الأزمنة، وأنّ الامامة ضرورة انسانية نفسية وليست ضرورة مذهبية أو دينية مع ما يمثله الدين من ضرورات في حياة الناس.
ويقول الدكتور سعيد يعقوب في هذا المجال: إن الجدال في التراث الاسلامي حول هذا الموضوع قد أخذ بُعداً متميزاً، بحيث نجد من يعتبر الحديث في الامامة من غير المسموحات، وأن اخطر كل الخطر في الاقتراب منه!
انبهاره بشخصية الإمام عليّ (عليه السلام) :
لم يعبأ الدكتور سعيد يعقوب بالأقوال التي لا تستند إلى دليل أو برهان، بل سار في بحثه حتى وصل إلى سيرة الإمام علي (عليه السلام) باعتباره المثل الأعلى للإمامة عند كافة المسلمين، لما حفل به من قدسية، بحيث لو ذكرت كلمة الامام ككلمة مفردة لتبادر إلى الذهن فوراً الإمام علي (عليه السلام) ، ولما تمتّع به من صفات الانسان الكامل.
ولم تمض فترة من دراسة الدكتور لشخصية الإمام علي (عليه السلام) إلاّ وانبهر الدكتور بشخصية هذا الرجل العظيم تبيّن له أن الطريق إلى علي (عليه السلام) هو الطريق إلى الله عزّوجلّ وأن من استرشد الطريق إلى علي (عليه السلام) ودخل مدينة علم رسول الله(صلى الله عليه وآله)من بابها، صار إلى فناء الرحمة المحمدية، حتى يبلغ مرتبة من كشف عنه الحجاب.
تفاعله مع مدرسة الامام علي (عليه السلام)
ومن هذا المنطلق تفاعل الدكتور سعيد يعقوب مع فكر مدرسة الامام علي (عليه السلام) واغترف من نبعها حتى وروى بذلك ظمأه وغدى من اتباعه وانصاره ومحبيه، لأنه وجد الحق عنده وأنه ممن يهدي إلى الحق وأنه خليفة رسول الله(صلى الله عليه وآله)بالحق وهو الذي نصّ عليه رسول الله(صلى الله عليه وآله) بالامامة من بعده في العديد من المواقف.
فلم يتريث الدكتور سعيد يعقوب بعدما انكشفت له الحقيقة كالشمس في رابعة النهار، فاعتنقها بكل ترحاب، وترك ما كان عليه فيما سبق واعتنق مذهب أهل البيت (عليهم السلام) .
مؤلفاته:
(۱) “معراج الهداية، دراسة حول الامام علي ومنهج الامامة”: مخطوط.
صدر عن مركز الأبحاث العقائدية، ضمن سلسلة الرحلة إلى الثقلين.
يدور البحث في هذا الكتاب حول ثلاثة محاور رئيسية وهي:
المحور الأول: اظهار ماهية الامامة من الناحية النفسية والاجتماعية.
المحور الثاني: انطباق هذه الماهية في النتيجة على شخصيات محدودة.
المحور الثالث: الكيفية التي مارسها الامام علي (عليه السلام) في ارساء دعائم خطاب الاسلام الانساني.
(۲) “آفاق النفس البشرية”.
(۳) “علم النفس والطب النفسي عند العرب”.
(۴) “السيرة التاريخية للحضارة العربية”.
(۵) “جدلية النفس والشعر عند العرب”.
(۶) “علم نفس الاطفال”.
(۷) “دراسة في آليات التلاؤم النفسي”.
وغيرها.
وقفة مع كتابه: “معراج الهداية”
وهو دراسة حول الإمام علي (عليه السلام) ومنهج الامامة، يتكلم الكاتب عن مسار البحث في كتابه هذا، فيقول:
وسيكون لنا في مسيرتنا البحثية مواطن متعددة نقف عليها واحداً تلو الآخر، وتدور البحوث هنا حول ثلاثة محاور رئيسية هي:
المحور الأول: يدور حول إظهار ماهية الإمامة، في تناول يعتني بالجانب النفسي والاجتماعي من حياة الإنسان، وهذا الجانب هو الذي قادنا إلى تفصيل معنى الإمامة من الناحية اللغوية ومن ناحية الاصطلاح.
ولهذا المحور اتجاه نحو فهم شامل للإمامة، لا على أنها قيادة سياسية أو زعامة اجتماعية، أو على أنها نهج متقدم في شؤون الحياة، وإنما بما هي مصداق للنزوع الإنساني نحو الغاية من الوجود، ونحو الملاذ الذي يحتمى بكنفه، ويسعى من أجل بلوغه.
المحور الثاني: يدور حول انطباق هذه الماهية في النتيجة على شخصيات محدودة، تمارس مع تتابع الأزمنة أدواراً رسالية من جهة، وتمثل مرتكزاً هو من أهم المرتكزات العقائدية لدى البشرية كلها.
وهنا سوف نتوسع في استعراض النصوص المقدسة التي تؤيد ما نذهب إليه، ونجلو بعد ذلك الصورة التي بلغناها في معرفة هذا الانطباق.
المحور الثالث: ويكون لنا فيه سياحة مع الكيفية التي مارسها الإمام عليّ (عليه السلام) في إرساء دعائم خطاب الإسلام الإنساني ـ هذا الخطاب الذي باشره النبيّ الكريم محمد(صلى الله عليه وآله)، وكانت البشرية جميعها هي المقصودة من ورائه، وليس فقط فئة من الناس، ولا أمة من الأمم ـ.
ويفصّل الكاتب ما أوجزه هنا بالقول:
والحقّ أنّ عملنا هنا ينصبّ بالدرجة الأُولى على مفهوم الإمامة، وليس على وظيفة الإمام، مع ما سيكون من فروع تتفرع عن هذا الفهم، لأنّ الانطلاق من المفهوم إلى المصداق هو الذي يعين على تلمّس معرفة أسباب الاختلاف الذي نشب بين الآراء التي بحثت موضوع الإمامة في الإسلام، ونحن نعلم المدى الذي شغله هذا الموضوع من الفكر الإسلامي، لكن الأمر أوسع من ذلك، فهو موضوع في الواقع يشغل مساحة كبرى من الفكر البشري عموماً ومنذ أقدم الأزمنة، بمعنى أنه ليس بدعة خاصة جاء بها الإسلام، لكن ووفق المنهج الذي اتبعناه، تبيّن لنا أنّها في عمق الحقيقة البشرية وعمق النفس الإنسانية، أيّ أنّ الإمام ضرورة إنسانية نفسية وليس ضرورة مذهبية أو دينية مع ما يمثله الدين من ضرورات في حياة الناس.
ولمّا كان الجدال في التراث الإسلامي حول هذا الموضوع قد أخذ بعداً متميزاً، بحيث نجد من يعتبر الحديث في الإمامة من غير المسموحات، وأنّ الخطر كل الخطر في الاقتراب منه! ونجد أيضاً نقيض هذه الفكرة لدى أطراف أُخرى، كما نجد من وقف في المنطقة الوسطى بين هذين الأمرين، رأينا أنّ المجال يتّسع لحمل هذا الأمر محمل البحث الجديد لما فيه من خير وفائدة، مستعينين بالإضافة إلى العلوم المتبعة في هذا المجال بعلم النفس الذي يقدم لنا خدماته في هذا المجال، والذي هو مجال تخصصي ودراستي أصلا.
والجانب الآخر الذي رأينا أنه من الضرورات بحثه أيضاً، هو الجانب التطبيقي لما تصل إليه نظرية الإمامة.
ولمّا كان الإمام علي هو المثل الأعلى للإمامة عند كافة المسلمين لما حفل به من قدسية، بحيث لو ذكرت كلمة الإمام ككلمة مفردة لتبادر إلى الذهن فوراً الإمام عليّ، ولما تمتع به من صفات الإنسان الكامل، الذي قصدت مجمل الديانات السماوية والفلسفات الكبرى سبيل بناء الإنسان بناء يسير به نحو أن يحذو حذو هذا المثال، لذلك فقد اخترنا أن نتحرك داخل أجوائه، ونتعرف على حقيقة الهدف الإلهي من وراء جعله إماماً للناس كافة، وهذا قد لا يتحقق يقيناً بغير ما ينبغي أن يعرف أولاً عن مفهوم الإمامة، ثم بعد ذلك قد تنكشف الحجب وتظهر للمهتم الصورة العلوية المباركة.
وقد سعينا في الختام إلى ربط الإمامة تاريخياً بالبعد الإنساني عامّة، إدراكاً منا أنّها لم تنقطع يوماً من الأيام، ولم تنفصل عن مسيرته البشرية، ولم يتأت هذا الإدراك اعتباطاً، بل جاء متوافقاً مع نتائج علوم جمّة تناولت التاريخ الإنساني، بأبعاده الحضارية وما فيها من إرث يسجل تطلع الإنسان إلى هدف يسعى من أجل بلوغه، وإلى ملاذ يلجأ إليه، وإلى مثال يتطلع نحو كماله، ويعدّه الغاية النهائية لحقيقة سعيه.
الامامة ماهيتها ومعناها:
يستعرض الكاتب الآراء الموجودة في هذا المجال ثم يطرح وجهة نظره مدعماً لها بالنصوص فيقول:
يجد الباحث في معرض التساؤل عن ماهية الإمامة في التراث الإسلامي إجابات متعدّدة ومتنوّعة:
ـ منها من حملها على أنّها أمر يختص بالزعامة والقيادة أو الرئاسة.
ـ ومنها من تناولها على أنها فكرة وأدخلها حيّز التصورات التي تبحث لها عن تصديق.
ـ ومنها من سار بها نحو التأملات الفلسفية التي تحتمل في تحققها الخطأ مثلما تحتمل الصحة.
ـ ومنها من رآها شأناً إلهياً مثلما النبوّة، ليس للناس من قرار فيه.
ـ وهناك من نأى بها عن فنّ المعقولات وسار بها نحو الفقهيات، يريد بذلك إدخالها منطقة الاستنباط، وإخراجها عن دائرة الأُصول التي يبحر العقل وراء إدراك كنهها، ويرتفع بها عن مقام المعاملات، ليصير إلى فلسفة المعرفة.
ويتضح لي أنّ الإمامة مفهوم غير جميع ما تقدّم، وعلى هذا المفهوم تترتب النتائج التي تكون أكثر شمولية، وأشد تعبيراً من المناصب الإدارية، أو السياسية أو العسكرية أو الاجتماعية، لكن لبلوغ هذا المفهوم يحتاج الراغب لمزيد من العناء، ولا نقصد بالعناء هنا المشقة من أجل الوصول إليه، لأنّ الإمامة والإمام أمر لا ينبغي معه الغموض، مثلما لا يجب أن ينشب حوله خلاف من نوع ذاك الذي يقسم الناس إلى فرق وأحزاب، إنّما الواجب أو الضروري ـ بمعنى الحتمي ـ أن يكون الإمام هو الجامع والرابط بين الناس، الجاذب لهم والموطد لأواصر التقارب والتلاحم فيما بينهم، هذا هو الأمر الطبيعي والسليم، الذي يرسل الله الأنبياء عادة ويزودهم بالأوصياء من أجله.
أمّا مخالفته، فإنّها تدخل في باب مخالفة الفطرة التي فطر الله الناس عليها، الأمر الذي يلزم عنه بالضرورة شعور الإنسان بالضنك وقسوة العيش، لأنّ الإعراض عن الفطرة الإلهية والإعراض عن سبيل الله هو الذي يورث المشقّة، وهو الذي يجعل الإنسان يتخبط على غير هدى، وليس المقصود بضنك العيش هنا: الاحتياج والفقر، أو الشعور بالظلم وما شابه ذلك، إنّما المقصود هو اغتراب النفس وابتعادها عن راحتها وطمأنينتها بالدرجة الأولى! فكم من موسر، وكم من جبار، وكم وكم من أولئك الذين يتصور الناس أنهم بلغوا رتبة السعادة في الحياة الدنيا، تجدهم في حقيقة أمرهم يعانون من آلام القلق والاضطراب، وعدم الاستقرار والسكينة.
لذلك عند إطلاق تسمية (الإمام) على الرجل الذي يتزعّم أو يقود نجدها لا تصلح لأن تبلغ مفهوماً! بمعنى أن الأمر هنا هو انطباق المصطلح على من يقوم بتنفيذ أمر ما، وهذا لا يقود نحو تجريد الاسم وبلوغه المعنى الذي يتيح التعمق وبلوغ الحقيقة التي هي شي غير القيام بالفعل، وسوف نجد مثالا على هذا في قول ابن حزم مثلا “إن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله(صلى الله عليه وآله)”(۱).
وينبغي علينا أن نفرق تماماً بين القائم بالعمل على أنّ هذا العمل أمر موكل إليه من قبل الناس، لبراعته فيه وتمكنه وفق مؤهلات تملّكها، أو سلطان خوله القيام عليه، وبين الإمام بالمفهوم العميق الذي أورده الإمام الرضا (عليه السلام) عند وصفه للإمام، فهو لا يزجي إليه مهمة تكون ضمن إمكانات العاديين من الناس، وإنْ اشتمل بالعرض عليها، وإنّما هو يتعمق إلى جوهر الإمامة، فيقول (عليه السلام) : “الإمام عالمٌ لا يجهل، وراع لا ينكل، معدن القدس والطهارة، والنسك والزهادة، والعلم والعبادة… نامي العلم، كامل الحلم، مضطلع بالإمامة، عالم بالسياسة، مفروض الطاعة، قائم بأمر الله عزّ وجلّ، ناصح لعباد الله…”(۲).
بعد النظر إلى وجهة ابن حزم، التي يمكن أن تعبّر عن معظم من تحدث حول الإمامة ووظائفها من الخارج، والتأمّل في توصيف الإمام الرضا (عليه السلام) وما يتفرّع عنه من آفاق تقود نحو الكشف عن حقيقة الإمامة ومعناها وجوهرها، نجد لزاماً قبل الاستغراق في متابعة هذين المنحيين في التناول، أن ننظر في الجذر اللغوي لكلمة (إمام)، الأمر الذي يساعدنا على تخطّي لكثير من صعوبات البحث.
الإمام في اللغة:
جاء في الصحاح: “هو الذي يقتدى به”(۳)، وكما هو واضح هنا فهي تفيد التعميم، ولا تختص بتفصيل يقود إلى معنى دقيق وحقيقي، فالذي يقتدى به يمكن أن يكون شخصاً يتمتع بالفطنة والذكاء، ويمكن أن لا يكون كذلك، ويمكن أن يكون آلة، ويمكن أن يكون معلماً من معالم المنفعة، بالطبع نحن نعلم أنّ المقصود هنا إجمالي، لكن حديثنا يجب أن يعطف على الفور على رغبتنا في إظهار المفهوم، لذا تقتضي الدقة أن يحاط بجميع أطراف التعريف، حتى يصار إلى انتزاع المفهوم الذي يتيح التعمق كما سبق.
وجاء في لسان العرب: “أم القوم وأم بهم: تقدمهم، وهي الإمامة، والإمام: كل من أئتم به”، ويفصل ابن منظور هنا فيقول: “يكون الإمام رئيساً كقولك إمام المسلمين، ويكون الإمام الطريق الواضح، ويكون الدليل، ويُؤِمُ: يُقصد”(۴).
وأورد من محيط المحيط في إظهار معنى الإمام من الناحية اللغوية قوله: “فالإمام هو قيم الأمر، والمصلح له”(۵).
قوة الفطرة في معرفة الإمام:
يقول الكتاب عنها:
“إنّ هذه القوّة الموجودة في الأعماق والتي يشترك فيها أفراد هذا الجنس، هي قوة ذات بعد فطري، ولعل هذا البعد هو الذي يعوِّل عليه عندما يشتد البحث عن الهدف الذي تبحث عنه أو تنزع نحوه الميول والحاجات الدفينة في أعماق الناس.
انّنا سوف نثير هنا في القارئ الكريم رغبة أو شهوة معرفة ما تؤول إليه حقيقته، أياً كان الدين الذي يعتنقه، أو المذهب أو التيار، لأن الواقع الذي تجري وراءه هذه الفكرة، هو مجال الإنسانية وليس مجالات الفئوية أو الفردية.
ونحن سوف نعتمد على هذه القوة في اشتداد السؤال عن (ما هو الإمام).
وبداية نقول أن هذه القوة مزودة بالقدرة على المعرفة التي تجتاز ظواهر الأشياء والنفاذ إلى ماهيتها، فيما لو تشكلت غير آبهة بالشوائب، وبمعنى آخر: فيما لو أمكن إزاحة ما يعلق فيها من تراكمات تسدل عليها طبقات من الحجب، يصعب معها تحديد الغاية الحقيقية التي تهفو إليها.
وهذا البعد في الجوهر يساوي العقل الذي يصل من خلال الخبرات إلى تلك المقدرة على الحكم، والفصل بين ما هو نافع وما هو ضار في الحقيقة، فبوسع العقل وحده أن يتخطّى حدود التجربة، فينفذ إلى جواهر الأشياء ويقف عليها كما هي موجودة في الحقيقة بصورة مستقلة عنا، فإن مهمة العقل الوصول بالمعرفة إلى الوحدة المطلقة النهائية(۶).
لكن أليس العقل هو ميزة الإنسان! أليس جميع الأسوياء يمتلكون هذه القوة! إذن فيما التفاوت بين الناس في بلوغ هذه المعرفة، وفيما يختلف الكل، كل من وجهته؟
وإذا كان عند “هيغل” يقف العقل على الوحدة الداخلية العميقة للجوانب المتضادة، ويتيح بذلك إمكانية معرفة الموضوعات في عيانيتها وكليتها(۷). فما هي الموانع من بلوغ الهدف؟
لم تحن الإجابة عن هذا السؤال بعد، لكن نود أن نشير إلى أنّ الخطاب الإلهي في كل الأحوال، يتّجه نحو الجوهر الإنساني السليم، أو الأكثر سلامة، ذاك الذي يعي ويدرك ويمتلك خاصة سبر ومعرفة أغوار الأشياء، ويمكن أن نجمله هنا بمصطلح (النفس) الذي يرسل إليها الخطاب القرآني، ومجمل أنواع المخاطبات الإنسانية، أي تلك القوة العاقلة التي تتمتع بالفهم والفكر والمشاعر، وهذه القوة لا مجال لمعرفتها أو التعرف عليها عبر الأدوات التي تختبر بها القوانين والأنظمة، كالكيمياء والطاقة والتشريح وما إلى ذلك، لا لأنّها ليست حقيقة ملموسة، بل على العكس يمكن أن تكون هي الحقيقة الأشد نصاعة بين جملة أشياء هذا الكون، لقدرتها على التأمل والخلق وترتيب المقدمات التي توصل إلى نتائج، من اللا شي أحياناً.
يقول عالم الأحياء “أدلوف بورتمان”: “ما من كمية من البحث على النسق الفيزيائي أو الكيميائي، يمكنها أن تقدم لنا صورة كاملة للعمليات النفسية والروحية والفكرية”(۸).
من خلال ما تقدم تبين لنا، أن هذا الجوهر الإنساني لا يخضع في حركته الفكرية لأية سلطة، أو لا توجد هنالك من سلطة تمنعه من البحث الدائم، الذي لا ينفك محاولاً الإحاطة بكل تفاصيل الوجود، عاملاً على إخضاعها لمتطلباته، أو باحثاً عن فك رموزها.
هذا ما يؤكده عمل الإنسان المبكر على إنشاء علائق تقوم ما بينه وبين الموجودات الشاخصة أمامه، بل تحرك أعمق من ذلك وذهب نحو الماهيات، يجرد الأشياء من الأطراف الزوائد التي تلحق بها ليصل إلى اللب، أو يبحث عن الخالد، ولا يعبأ كثيراً بالآيل إلى الزوال.
والذي يدفعه نحو هذا المنهج، هو شغف أزلي يسوقه نحو معرفة بدايته ونهايته، ويُجري أعماله على خلق ظروف ومناخات تلائم المراحل التي يقطعها ما بين هذه البداية التي يحياها، وتلك النهاية التي ينحصر ختام تجربته فوق التراب بها، بجميع ما يشوبها من الغموض، وما ينتظره فيها من المجهول.
وبمناسبة هذا المجهول، فإننا نعطف هنا على أن التعلق والحنين والبحث عن المجهول بالنسبة للنوع الإنساني، هو أمر له علاقة ذات حدّين:
الحدّ الأوّل: هو الذي يخضع للتساؤلات عن المنشأ والولادة والبداية.
الحدّ الثاني: هو الذي تجري عليه جميع اختبارات عمره في طريق بلوغه النهاية التي حتمت عليه، وهو يعرفها لكنّه يغض عنها الطرف.
وإن كان الوازع والهاتف الداخلي الذي يحفزه على المعرفة يرتبط بشكل وثيق بالحدّ الثاني، حدّ معرفة مجهول النهاية، لما يتعلق به في مسيرته الحياتية من آمال تجعله لا يرغب بانقضائها، على علمه يقيناً بهذا الانقضاء، وفيه كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) موصياً برفض هذه الدنيا: “وإن لم تحبوا تركها، والمبلية لأجسامكم، وإن كنتم تحبون تجديدها، فإنّما مثلكم ومثلها كسفر سلكوا سبيلا فكأنهم قد قطعوه، وأمّوا عَلَماً فكأنهم قد بلغوه، وكم عسى المجري إلى الغاية أن يجري إليها حتى يبلغها، وما عسى أن يكون بقاء من له يومٌ لا يعدوه، وطالب حثيث يحدوه في الدنيا حتى يفارقها”(۹).
نتيجة:
الواقع أنّ ثمة اتصال يربط ما بين هذه الحياة الخارجية، وبين حياة أخرى يُسعى لا محالة لبلوغها، وهي حياة أزلية محكوم بها الإنسان، ومحتاج للتعرف عليها واكتشافها، لكنّه يثبت دائماً أنه بمفرده لا يتمكن ـ مع ما يمتلكه من شعور عميق ـ من الوصول إليها، وكذلك يندفع به هذا الشعور نحوها، غير أن هذا الشعور يتدخل في تحديد مدى صفائه وخلوصه من الشوائب.
لكن قد يتمكن الفرد من الوصول إلى المواءمة بين ما يتلقاه من العالم الخارجي، وبين ما يتدفق من أعماقه، وهو هنا عند هذه المرحلة من التمكن سوف يستطيع يقيناً أن يلتقط إشارات دقيقة التأثير، تصل به إلى معرفة مرضية بالمعنى الحقيقي لوجوده والغاية من هذا الوجود، وبذات المنطقة من المعرفة هذه سوف ينجذب باتجاه ملاذه الذي يدرك بالفطرة المصفاة أنه هو القادر على حمايته من أي سقوط، مثلما يحميه من مغبة الغفلة عن هذا الذي بلغه من المعرفة، وهذا الانجذاب مسربل بعناية إلهية، وهي في هذه الهنيهة بالذات معنية بهدايته، وإنما تكون هذه الهداية في النتيجة هي انكشافه على إمامه الذي يحمي كليته في هذه الحياة.
هذا ما يمكن أن نسميه الوصول الفطري إلى معرفة الإمام!
الطريق إلى الإمام علي (عليه السلام) :
علينا أن لا نستغرب من هذا العنوان، لأنّه وضع بعد ذلك التمهيد الذي اعتمد منهج التحليل والاستنتاج، من أجل وضع لبنة جديدة في بنيان مفهوم الإمامة عسى ينظر إليها بعين التأنّي، وتؤخذ مع من يتوسع بها إلى ما هو أكثر إفادة ونفع.
نبدأ أولاً بالنظر إلى انطباق مفهوم الإمامة الذي أجريناه في بحوثنا على علي (عليه السلام) ، ويفيدنا في هذا المجال أن تقسم هذه البداية إلى عدّة أقسام.
القسم الأول: في تسلم راية الإمامة
ونود أن نذكر بأنّنا وصلنا في الفرق بين الإمامة وأنواع الزعامة التي تنضوي تحت ظلها، ولا تطاولها بحال، ونرغب أن يستمر القارئ معنا في التمسك بالطريقة القرآنية التي تجعل من القلب وطناً للتعقّل.
لقد سمح لنا التحرك في أرجاء المفهوم أن نغادر المعنى الظاهري لكي نتعمق في معرف الإمام في عيانيتها، وتراءى لنا أنّ الفرق بين النور والظلمة يساوي الفرق بين الإبصار والعمى، ونلاحظ أوّلا أنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) في كلماته يتناوب كلمة (ضياء) كلّما ورد ذكر محمد(صلى الله عليه وآله) أو ذكر القرآن الكريم، أو ذكر أهل البيت النبوي (عليهم السلام) ، كذلك نرى أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) عندما يشير في كلامه إلى أهل بيته (عليهم السلام) ، فإنّه يصفهم بأداة النجاة من الغرق، والتي تشبه إلى حدّ بعيد مفهوم الخلاص من الهلاك، والذي يمكن أن يحمل على أن النور هو الخلاص، والظلمة هي الهلاك، فكيف يستدل على هذا النور؟
بالدرجة الأولى ينبغي أن تنقطع نهاية هذا الأمر إلى الله سبحانه فهو الذي يحيله إليه، يقول سبحانه: (اللَّهُ وَلِىُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّـلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) (البقرة: ۲۵۷)، لكن هذا الإخراج كما لاحظنا مشروط وفق القانون الإلهي بالإيمان والإيمان، كما بيناه في بحث الفطرة لا يأتي من غير دين، وإذا كنا قد بلغنا في متابعتنا لمسيرة النفس الإنسانية وما تحمله من قابليات، وتبيّن لدينا أنّ الإنسان بطبعه منصّت إلى نداء داخلي يتعلق به من قبيل الاعتقاد، وسقنا على ذلك شواهده العلمية، نصل بعد ذلك إلى حتمية أوردها الإمام علي (عليه السلام) في كلماته، المفتاح الذي يفتح قفل هذا الأمر، وهو كلامه الآتي يقول: “أول الدين معرفته ـ أي الله ـ “(۱۰).
واللافت يقيناً أن هذا القول لا ينحصر بالإسلام، وإن كان لا يرى فوق أو غير الإسلام ديناً، إنّما هذا يلفت إلى الأديان كلّها باعتباره يصرّح بالأوليات التي تبنى عليها فيما بعد النتائج، وهو يسلسل هذه النتائج معتمداً هذه النقطة الأولية على أنّها مفتاح البداية (أوّل الدين معرفة الله)، والذي يقودنا إلى هذا، هو أن الله سبحانه خلق الخلائق وهداها إلى نوره، فمنذ البدء ثمّة هذه الأولية، منذ تكوين الناس وإعمارهم للحياة، وهو الذي فطرت عليه الإنسانية، وهنا نملك أن نقول: إنّ المعرفة بالضرورة توصل إلى الإيمان.
وهذا إيمان الذي تشكّل من جرائها ترتبت عليه درجات الكمال التي يشير إليها (عليه السلام) في متابعة كلامه، بقوله: “وكمال معرفته التصديق به”، يقول “الطباطبائي” في معرض شرحه لهذه الجملة: “والتصديق هذا هو الذي يوجب خضوع الإنسان له في عبوديته، وبهذا التصديق يرسخ الاعتقاد ويثبت، لذلك كان هذا التصديق كمال المعرفة”(۱۱)، عند هذا المقام سوف تنطبق الآية الكريمة على أنّ الله سبحانه يتولّى إخراج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور، ولكن هذا لا يكون قبل الخضوع للعبودية بحسب الطباطبائي.
القسم الثاني: الطريق إلى علي القرآن والنبي
والذي يجعل أمر الهداة منقطعاً إلى الله سبحانه، إضافة إلى ما أوردناه جميعاً، هو بالمقام الأول ما حدّث به رسول الله وأمر به، والذي لا تنبغي المواربة فيه أو المحاكمة، هو أن كلامه صفو التنزيل، أي أن كل تقرير أو أمر أمر النبي(صلى الله عليه وآله)الناس أن يأخذوه عنه هو فرض مثلما باقي العبادات، وعلّة هذا قول الله سبحانه: (وَمَآ ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ) (الحشر: ۷)، فلا جدال في أنّ مصدر أوامر وتعليمات الرسول(صلى الله عليه وآله) هي من عند الله، والقرآن الكريم مليء بتوكيد هذا ولا حاجة بنا لأن نسرد الكلمات الإلهية التي ترفع شأن رسول الله(صلى الله عليه وآله)، وتجعل من كلماته وحياً يوحى، حتى نحتاج إلى تثبيت أن كلامه هو محض نور، وأن مخالفته هي ليست فقط معصية، وإنما إبطال للأعمال أيضاً إن كان هذا المخالف ينظر إلى نفسه على أنه ممن يتقربون إلى الله بعمل أو عبادة، وعلة هذا قول الله سبحانه (أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِـلُواْ أَعْمَالَكُمْ) (محمد: ۳۳).
في الربط الناجز بين طاعة الله سبحانه، وبين طاعة رسوله عليه وعلى آله أطيب الصلوات، يمكن للمتأمل أن يلتقي مع عليّ ابتداءً قبل أن ينطلق إلى التفصيلات، وعند هذا الالتقاء سوف يجري النظر إلى متابعة الحاجة إليه، بعد أن يغادر النبيّ الأكرم(صلى الله عليه وآله)إلى دار مقرّه، وفيه (عليه السلام) سوف يعرف متابعة طريق الله ممّا وراءه، أولئك الهداة الذين سوف يجسّدون نور الله من بعد محمد(صلى الله عليه وآله) وعليّ (عليه السلام) ، لأنّ الطريق إلى الله بعد ذلك سوف لن تكون في مأمن بالنسبة للسالك عندما يولي وجهه قبلة سواها، أي سوى التي قال رسول الله فيها أنّها سفينة النجاة من ركبها نجى ومن تركها غرق(۱۲).
وقد فرغنا من أن النور والظلمة هما عنوانا البصيرة والعماء، ووقفنا على أن الإنسان غير الداخل في نور الله مارق عن راية حقه، وأن لهذه الراية حملة، وأنّ هؤلاء الحملة هم أفرع شجرة النبوة، ومصابيح هذا النور، أئمة الناس وملاذهم ومنجاهم من أي سوء، وإذا بُنيت مقاييس دخول الجنة وقبول الطاعة عند الله سبحانه على طاعته وطاعة رسوله، فإن كل مخالفة إيلاج في الظلمة، مفاد قوله سبحانه: (وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَه فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـلاً مُّبِيناً ) (الأحزاب: ۳۶).
فإذا لجأنا إلى أوامر الله في طاعة نبيه الهادي الأعظم للبشرية جمعاء، ثم نظرنا إلى وصايا رسول الله سبحانه في أئمة الهدى من ورائه، نكون قد وضعنا نصب أعيننا هنا السؤال التالي: ما معنى (وَمَآ أتَاكُمُ الرَّسُولُ) (الحشر: ۷)؟
وقبل الإجابة نقول: إنّ شرط الطاعة العمل، أي لا يكفي أن يقر المرء بقلبه بأنه موافق لما يقوله هاديه، نبيّه وإمامه، وإنّما ينبغي تأدية العمل بهذه المعرفة، فالعلم بالشيء بغير القيام به، يبقى في حيز القصور ولا يكون له مجال تصديق ما لم يبادر إلى العمل به.
وعدم طاعة الله ورسوله نتيجتها بحسب القوانين القرآنية، هي ما ينحصر في كلامه عزّ وجلّ في هذه الآية: (وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً) (الأحزاب: ۳۶)، يوازيها القبول والطاعة والعمل بحسب هذا القانون القرآني إثر قوله جلّ جلاله: (وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيماً) (الأحزاب: ۷۱).
فالله سبحانه الذي اختار أنبياءه ورسله، اختار أئمة الناس إليه معهم وفي آثارهم، وكلف كل نبيّ ورسول أبلغ عن رسالته أنه يشير إلى الذين يمثلون امتداد هذه الرسالة، وليس من سبيل إلى ذلك بغير تولية سبحانه هذا الأمر. فالمعروف أن الناس تصارع على الفوز بالذي تراه يقدم لها النفع الآني والمستقبلي ويرغبون بالمناصب والشهرة، وقد زينت الدنيا لهم ببهارجها ومفاتنها وقد عسر على الإنسان الانصياع للسوي، ما لم يقم عليه الحجة التي تجعله يصدع لهذا الانصياع. ولا نقصد بالانصياع هنا، هو التسليم دونما رغبة أو إرادة، لكن المعروف أن شؤون العقائد، هي شؤون في غاية التعقيد، وإن استبدال عقيدة بغيرها بالنسبة لبني البشر ـ خاصة فيما يميل باتجاه الدين ـ مسألة يسفح من أجلها المزيد من الدماء قبل أن تنتصب على أقدامها، لذلك كان الله اللطيف بعباده سبحانه، قد ترك الناس على فطرة تسوقهم إلى الهداية، رغم صراعهم الذي لا يهدأ معها، إلا أنّ العديد من آياته عزّ وجلّ تشير إلى أنّ الرسل والدعاة المجتبين لهم وظيفة التذكير والتبشير وإنذار الناس بعدهم، أي بعد أن يستيقظ فيهم ملمح الاستجابة للنداء الداخلي الفطري الذي يكشف لهم حجب الظلمات، ويريهم مثالهم ورجاءهم، لا ينبغي لهم أن يغفلوا بعد ذلك عنه، فهم إن غفلوا بعد ذلك، فالوعيد والإنذار موجود بوفرة في القرآن الكريم.
وعن التذكير الذي تلهج به آيات الله سبحانه، يطيب لنا ذكر نفحة هنا، تكون في مقام الاعتراف بفضله سبحانه على الأمم، وبالشكر له لما تفضل بإرسال رحمته التي وسعت كل شي ببعث محمد(صلى الله عليه وآله): (وَ مَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) (الأنبياء: ۱۰۷).
القسم الثالث: الطريق إلى علي بعلي
في القسمين الذين أُنجزا بحثنا عن معرفته (عليه السلام) من خلال الاستنتاج والاستدلال، ومن خلال كلام الله سبحانه وكلام رسوله(صلى الله عليه وآله)، وصلنا إلى أنّ الله سبحانه قد أجرى في الناس سنته، وليس لأحد أن ينازع الله سنته، وقضاء رسوله قضاءهما، فما لمؤمن أو مؤمنة أن يختار.
وبذلك تبيّن لنا أن الرعاية الإلهية قد حفت أمّة محمد(صلى الله عليه وآله) بإعلان إمامة عليّ (عليه السلام) في الناس، استمرار لهدى الله وإبقاء لنوره، وأن من عمل على إطفاء هذا النور خبا وذهب في مترديات الظلمة، ومن شرح الله صدره لهداه، أخذ بناصية فؤداه، وساقه من حيث يستقر الإيمان في قلبه، ويرد على حبيبه المصطفى يوم لا ينفع مال ولا بنون وقلبه مشتعل رغبة وحبّاً وأمان، فهو على حوض المختار، يسقى مياه أهل الجنة، ويتراقص في نفسه النور فيجلب الخير لها، فقد انكشفت أساريره عن هدي محمد باعتناق الإسلام، وذاب قلبه ولعاً بالله ورسوله(صلى الله عليه وآله)، فآثر ولاية عليّ على خلائق الله في الأرض، فكانت راحة عليّ (عليه السلام) في ذاك المقام هي التي تفصل ما بينه وبين نار جهنم التي أعدّها الله للظالمي أنفسهم.
ونحن هنا سوف نقصد الطريق نحوه (عليه السلام) ، من خلال كلماته التي أرسلها منذ ذاك العهد في الناس، وما تزال تسري في دياجي الظلمات تكشفها، وتضي جنبات الكون، لكن الذي لم يمكنه الله بعد من إدراكها لم ينل حظه من العيش معه بعد، ونسأله جلّ جلاله، أن يقضي لجيمع أمّة محمد(صلى الله عليه وآله) وللبشرية أن تنفتح عيونها على هديه، وتستلهم خلاصها منه، فإنّه كما قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): “لا يُدخلها في باطل، ولا يُخرجها من حق”، بل أنّه فاتح آفاق الأنفس على كوامنها، ورافع نور الله فوق كلّ ظلمة بمنّ منه سبحانه، لا بسواه.
والذي يدعو إلى التأني والتأمل في استعراض كلامه، ليس البلاغة التي يتمتع بها كما يتصور البعض، فما كان ليدركه النقص (عليه السلام) ، وحتى يبحث عن الكمال، فالبلاغة ليست فضيلة أو إضافة إلى إمامته، بل إنها من مقتضياتها، بذلك نحن وإن راعنا جمال أسلوبه، وأخذ بلباب أفئدتنا حسن تناوله للمفردات، لكن هذه ليس بذاته الهدف من الاستدلال عليه بكلماته، وإنّما الهدف فوق ذلك، إنه استلهام نوره من أجل إزاحة ظلمات عَلَتْ الأفئدة، وكذلك استدراك طريق تراكمت فوقه غبار التزييف والتحريض، وانتضاء حق يشعل مصباحه إلتفاته.
بهذا نحن نقف قليلاً مع ما يذكره عن أهل البيت الذين يدور معهم في فلك محمد(صلى الله عليه وآله)وينسج معهم على منواله، فيأخذ منهم ويعطيهم، ويتبادل معهم سرائر الكون، ويكشف للناس خبايا مستقرهم ومستودعهم، وطرائق عيشهم وسعادة أوقاتهم، مثلما يزجرهم ويردعهم عندما ينظر فيراهم على غير الجادة، لعمري كدفع الوالد ولده على اتيان حياض اللذة غير النافعة، وعدله إلى طرقات الفوز والخلود.
كيف ينظر علي (عليه السلام) إلى نفسه:
ونبدأ القسم الأوّل بالكيفية الذي ينظر فيها عليّ (عليه السلام) إلى نفسه، وكيف ينقل لنا وسائل التعرف عليه، والتماس هداه.
وسنلج في كلماته التي حملتها إلينا الأسفار عبر التاريخ، ومنها سوف نلحظ مشهد الحق ونعاينه، ونطرق باب النور، فينفرج ما بين قلوبنا وبينه ما يجعلنا تطمئن بذكر الله، وتخشع رغبة في حنوه.
ننظر هنا إلى كلماته يخاطب فيها الناس، وهو قائم مقام رسول الله(صلى الله عليه وآله)يعلمهم ويعظهم ويميل إليهم بارتياد ثوب النجاة من الفتن، ولا يترك مطرحاً إلاّ وشغله بإلفاتهم إلى نور الله يقول: “والله ما أسمعكم الرسول شيئاً إلاّ وها أنا ذا اليوم مسمعكموه… ولا شقت لهم الأبصار، ولا جعلت لهم الأفئدة في ذلك الأوان، وقد أعطيتم مثلها في هذا الزمان”(۱۳).
لن يحتاج المتأمل في هذه الكلمات إلى مزيد تدبّر، كي تنكشف عليه حقيقة ما يؤديه فعليّ الذي ما أقسم بالله إلاّ صادقاً، يقول للناس: إنّ المسافة التي تفصلكم عن آبائكم الذين كانوا عندما بعث الله نبيّه(صلى الله عليه وآله) يغرقون في متاهات الضلال، ليست بمسافة بعيدة، “ما أنتم اليوم من يوم كنتم في أصلابهم ببعيد”(۱۴)، وأنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)قام فيهم، فأزاح عنهم ظلمة الضلال، وأضاء قلوبهم بنور ربّه وكلماته، وإنني الآن أقوم فيكم ذات المقام، وأودي رسالته، اسمعكم ما أسمع النبيّ آباءكم، وأكشف عن بصائركم.
والذي يجرؤ على قول كهذا، لا يكن أن يكون مدّعياً، وهو على رأس أمم من صحابة نبيّ الله(صلى الله عليه وآله)! كذلك لا يكون المدّعي أن ينفرد بإتيان الناس مذكّراً ما كان عليه آباؤهم من جاهلية، ومنفراً إلى الله ورسوله بمثل ما نقرأ عن عليّ.
لكن الإمام هنا، يؤكّد الإشارة إلى أنّه حامل راية الحق، التي تتوارثها الأنبياء والرسل وعند غيابهم تكون في يد الأئمة الهداة، وعليّ (عليه السلام) يعرف دائماً بأنّ آل محمد في زمن الإسلام هم حملة هذه الراية، يقول:
“لا يقاس بآل محمد (عليهم السلام) من هذه الأمة أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً، هم أساس الدين، وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي، وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حق الولاية، وفيهم الوصية والوراثة”(۱۵).
دعونا ننظر هنا في الكيفية التي يعرّف فيها عليّ (عليه السلام) بآل محمد، وبالطبع هو قطبهم، إنه يشير إلى إمامتهم للناس، ليس تلميحاً، بل مثلما قال فيهم رسول الله تصريحاً “لا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه”، الله سبحانه يتفضّل على الناس بأنه أنعم عليهم بمحمد(صلى الله عليه وآله)، ويجري فضله في آل رسول الله، أن الذي يتحدّث هو الإمام كاشفاً عن القلوب أغطيتها، يرسل كلامه في الناس، منذ تحدث إلى يوم يبعثون وقد حفظ الله كلامه هنا للناس، على الرغم من أنّ الأزمنة تدور على الدول، ولما لم تكن للإمام دولة، بل كانت روح الهداية، فقد انزاحت الدول وبقي نور الله يسري في فلوات الأزمنة.
وهنا مكمن الفرق، بين الإمامة وأصناف الزعامات التي تحدّثت عنها في أماكن مختلفة في أنحاء هذا الكتاب.
والذي يجاهر بإمامته للناس وفق هذا المفهوم، ليس أحد غير محمول عليه تخليصهم من فتن الدنيا، بل على كاهله حمل هذا، لأنّه هو المعبّر عياناً عن حقيقته.
ففي سياق تناوله للتعريف بنفسه، ونعتقد هنا أنه لا يقول هذا إمام جاهل به، إنما يتحدّث لما كان للحديث موجب، وهذا الموجب هو لكل من يأتي من بعد هؤلاء القوم الذين لا يجهلونه، إنما تقودهم عنه أمور الدنيا التي تحول بين المرء وربّه.
فلا يظن أحد أن عليّ (عليه السلام) يتحدّث في تينك الأزمنة، كي تقف الناس على ما هو، وإنّما يتحدّث كي تسير في الناس حقيقته، التي يريد أهل الضلال اطفاء نور الله بأفواههم، إذ عملوا على اخفائها، لكن الله سبحانه يأبى إلاّ أن يتم نوره، فينطق أثر ذلك (عليه السلام) ، دافعاً الشبهات مقيماً للحق، يقول:
“فاسألوني قبل أن تفقدوني، فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة، ولا عن فئة تهدي مائة وتضل مائة إلاّ أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها، ومناخ ركابها، ومحط رحالها، ومن يقتل من أهلها قتلا، ومن يموت منهم موتاً، ولو قد فقدتموني ونزلت بكم كرائه الأُمور، وحوازب الخطوب”(۱۶).
إن الذي يدعو الإنسان إلى التفكّر في كلام الإمام، ليس البحث عن أحقيته بالخلافة مثلما يظن، أو عند انزاله الزعيم في الناس، لكن الأمر مختلف، فالذي أنجزه محمد(صلى الله عليه وآله) من تركيز وترسيخ لمجمل رسالات الله، واجتماع الأديان كلها دائرة الدين الإسلامي، وإقامة البيّنة التي ختم الله فيها جميع الأديان، لهي التي تلفت نظر الإنسان إلى الذي يبوح به عليّ (عليه السلام) .
فهو العارف بكل شيء “علمني رسول الله ألف باب من العلم، يفتح لي من كل باب ألف باب”(۱۷) وهو الذي عرف خفايا الكرامات التي استودعها الله أهلها، فهو من رسول الله “كالصّنو من الصّنو، والذراع من العضد”(۱۸).
الطريق إلى عليّ (عليه السلام) الطريق إلى الله عزّوجلّ:
إذا كان فناء عليّ (عليه السلام) بحبّ محمد(صلى الله عليه وآله) بلغ منه كل هذا المبلغ، وراح يذرف نفسه على صغيراً ويحامي عنه يافعاً، ويقاسمه شؤون الدين، ويذب عن حياضه في كل قائمة وقاعدة، ويسوح في كل مصر لنصرته، فكيف بربّ محمد(صلى الله عليه وآله) وربّ جميع الوجود.
من استرشد الطريق إلى عليّ (عليه السلام) ، ودخل مدينة علم رسول الله(صلى الله عليه وآله) من بابها، صار إلى فناء الرحمة المحمدية، حتى بلغ مرتبة من كشف عنه الحجاب، لكن هذا لا يكون إلاّ ببصيرة راضها حبّ الله.
ربما كانت هذه الكلمات هنا أقرب إلى التذلل منها إلى روح البحث، ولو أن البحث في مقدس هو في هذا المقام، لا يجد له مناصاً من بلوغ عتبة التواضع التي هي شرفة كسب المعرفة.
كتب على مرّ التاريخ المئات من العلماء والفلاسفة حول بداية الوجود وأصله، وذهبت الأمم في هذا مذاهب شتى، منها من قارب الحقيقة، ومنها من زاغ بصره، ومنها من وقف في المنطقة الوسطى.
وثمة من لم يرّ مبرراً للتحرك نحو أشياء لا تدرك، لكن العمق النفسي الإنساني هو في تعريفات الكتاب هنا يساوي “الفطرة”، فالفطرة التي يتحرك فيها شعور البحث عن القوة التي تدير شؤون الحياة، ما زالت مستمرة بالدفع الذي هو من خاصيات الحركة، فهي ليست ساكنة في طبيعتها، ولم تستكن إلى اليوم.
وفي تناول هذه الظاهرة، يمكننا النظر إلى مجمل ما قاله الإمام عليّ (عليه السلام) في نهج البلاغة وسواه من الكتب التي نقلت ارشاداته للناس، والتي تدخل في معظم نواحيها في عوالم فلسفة المعرفة، فيضع على الأساس للبحث ضمن منطقة القدرة البشرية، ويحزم حقائب الذين يتناولون أو يحاولون تناول ذات الله بالدرس والتأمل، ويشرع لهم طريق الارتحال.
وهذه المدرسة بالذات هي مدرسة رسول الله(صلى الله عليه وآله)، وقد شقّ عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) بامداده الناس بمثل هذه المعارف الطريق الذي رسمت فيما بعده المدارس الكلامية مناهجها، وإن لم تكن في المجمل قد بلغت رغبته في تناقل العلم بين الناس، لكنها أثرت في تراث الإنسانية مخزوناً عظيماً من الكتب والبحوث العقائدية والفلسفية.
وقد يعلم من انكشفت له حقيقة إمامه أنّه قال: “لا يزيدني كثرة الناس حولي عزّة، ولا تفرّقهم عني وحشة”(۱۹)، فهو البالغ مبلغ اليقين من ربه، والسلامة من أداء أمانته، ويذهب مطمئناً إلى باريه.
ونختم هذا بوصيته (عليه السلام) التي منها: “واعلم ـ يا بني ـ أنك إنما خلقت للآخرة لا للدنيا، وللفناء لا للبقاء، وللموت لا للحياة، وأنّك في منزل قُلعة، ودار بلغة، وطريق إلى الآخرة… وإياك أن تغتر بماترى من أخلاد أهل الدنيا إليها، وتكالبهم عليها، فقد نبأك الله عنها… فإنّما أهلها كلاب عاوية، وسباع ضارية، يهرّ بعضها بعضاً، يأكل عزيزها ذليلها… سلكت بهم الدنيا طريق العمى، وأخذت بأبصارهم عن منار الهدى”(۲۰).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(۱) الفصل بين الملل والنحل: ۴ / ۸۷٫
(۲) انظر: الكافي للكليني: ۱ / ۲۰۲، كتاب الحجّة.
(۳) الصحاح للجوهري: ۵، مادة إمام.
(۴) لسان العرب لابن منظور مادة: أم.
(۵) محيط المحيط، بطرس البستاني، دار لبنان، ط ۱۹۷۷، ص۱۶۱٫
(۶) المعجم الفلسفي، م. س. ص۹۲٫
(۷) ن. م. ص۹۲٫
(۸) العلم من منظوره الجديد، روبرت اغروس، جورج ستانسيو، ت: كمال خلاليلي سلسلة عالم المعرفة، ع۱۳۴، ص۴۲ ـ ۴۳٫
(۹) انظر نهج البلاغة: الخطبة ۹۸٫
(۱۰) أنظر نهج البلاغة: الخطبة ۱٫
(۱۱) علي والفلسفة الإلهية: ۴۴٫
(۱۲) أنظر مستدرك الحاكم: ۳ / ۳۶۱ (۴۷۷۸)، المعجم الأوسط للطبراني: ۴ / ۱۰ (۵۵۳۶)، وغيرها.
(۱۳) نهج البلاغة: خطبة ۸۸٫
(۱۴) المصدر نفسه.
(۱۵) المصدر نفسه: خطبة ۲٫
(۱۶) المصدر نفسه: خطبة ۹۲٫
(۱۷) أنظر دلائل الإمامة لابن جرير الطبري: ۲۳۵، البحار للمجلسي: ۳۰ / ۶۷۲٫
(۱۸) نهج البلاغة: كتاب ۴۵٫
(۱۹) نهج البلاغة: كتاب ۳۶٫
(۲۰) نهج البلاغة: كتاب ۳۱٫
المصدر: مركز الأبحاث العقائدية