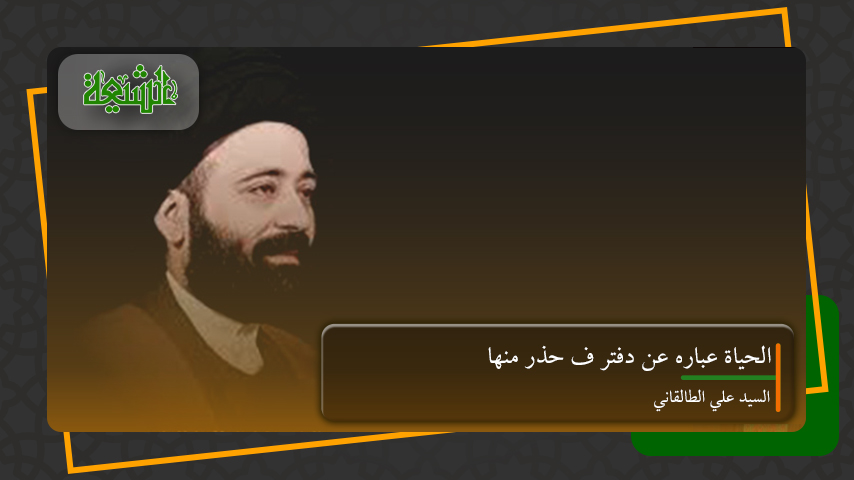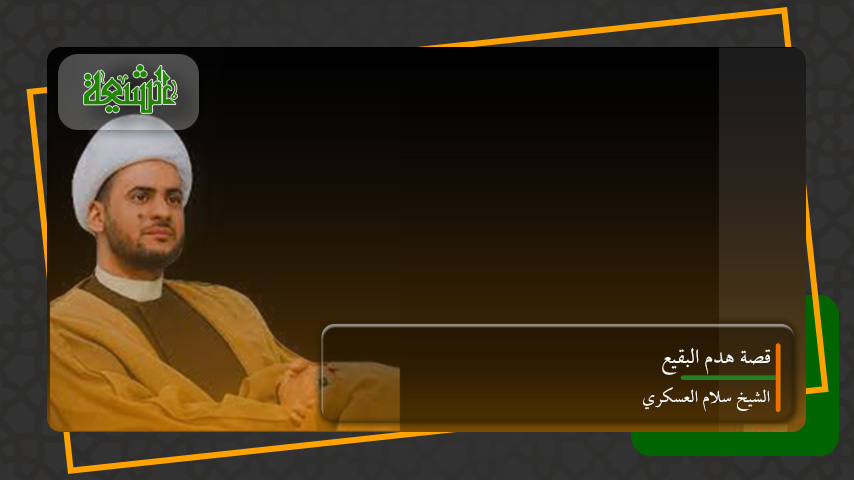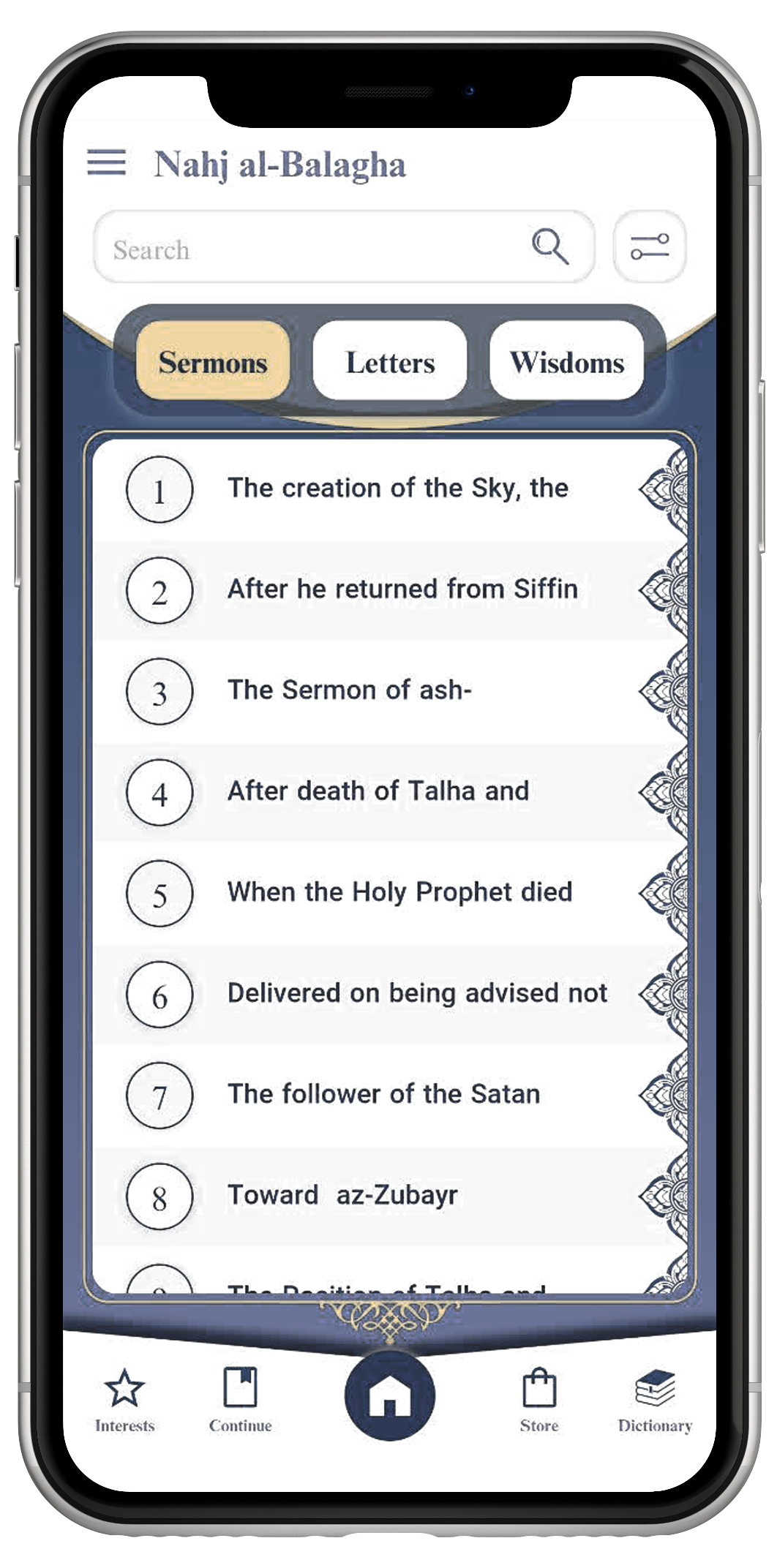تشهد البشرية صوراً من العدوان والصراع في ما بينها، في دوائر واسعة كالحروب العالمية، وفي دوائر محدودة كنهب أموال اليتامى والإرث من قبل الأقرباء والأوصياء، وكظلم الزوجة من قبل الزوج. وقد عالجت عدة آيات من سورة النساء في مبتدئها بعض صور العدوان والصراع في الدوائر المحدودة، ولعل الآية الأولى من السورة جاءت بمثابة التمهيد لتلك المعالجات من خلال القانون العام الذي تقدمه. قال تعالى: (يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)[النساء:1].
واقع الحياة يعكس وجود التنوع الإنساني من نواح عديدة، بما فيها التعدد الديني والقومي والعرقي واللساني.. فهل يراد لهذا التنوع أن يتحول إلى عنصر تأزيم وصراع واقتتال؟ التاريخ على مر العصور يؤكد على أن مقوّمات التنوع تتحول عند الناس إلى أسباب للتعصب وبالتالي تجر إلى وقوع الصراعات فيما بينهم. وهذا يخالف الإرادة الإلهية لهذا التنوع: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)[الحجرات:13].
التقوى والصراع:
في المنطق القرآني فإن السبيل الأفضل لكل الناس ـ وليس للمسلمين فحسب ـ لتجنب ذلك هو تقوى الله.. وهذا ما نلاحظه من خلال ربط الموضوع بالتقوى في الآيتين. مع العلم بأن إدراك ضرورة اعتماد التقوى كوسيلة لتجنب الصراعات وتحقيق (التعارف) بدلاً من (التقاتل) يمكن أن يصل إليه (الناس) من خلال العقل، وبالتالي فهو عنصر مشترك بين (الناس) جميعاً، وإن اختلفوا في أديانهم ومعتقداتهم وقومياتهم، ولا يخص المسلمين فحسب.. فلعنصر التقوى حضور عند النصارى واليهود وحتى عند الهندوس والبوذيين وغيرهم، وهي إن اختلفت في بعض تفاصيلها، ولكنها تشترك في بعض العناوين العامة. والأمر الآخر الذي يدل عليه العقل هو فرعية كل عناوين الاختلاف بين (الناس) في مقابل أصل انتمائهم إلى أب واحد (آدم) وأم واحدة (حواء).
لم التعصب؟
فإذا كان التعصب قائماً على القومية مثلاً، فبقليل من التفكير ستجد أن أصل كل القوميات شخص واحد.. فانتماء الناس إلى بعضهم البعض في الأصل متحقق. وإذا كان التعصب قائماً مثلاً على الانتماء الديني الباعث على التقاتل والتناحر، فإن الخالق واحد وإن اختلف الناس (رجالاً ونساءً وبتنوعهم) في أسمائه وتصورهم له وغير ذلك من الخصوصيات.. وهكذا بالنسبة إلى سائر العناوين التي تبعث الناس لإلغاء بعضهم البعض بالقوة.
آدم وحواء:
اختلف المفسرون في المراد من (وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا)، فبعضهم تماشى مع النص التوراتي وبعض مرويات المسلمين من أن المراد هو خلق حواء من ضلع آدم، ففي التوراة: (فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام. فأخذ واحدة من اضلاعه وملا مكانها لحما. وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي. هذه تدعى امرأة لأنها من امرء أخذت). وفي مرويات المسلمين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شئ في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء). والبعض أوّل الأحاديث ورفض الأخذ بظاهرها، والبعض طرح الأحاديث ورفضها.. أما الآية فلا دلالة واضحة فيها على هذا الأمر.
حقيقة واحدة:
ولربما كان المراد من الآية أن هناك حقيقة واحدة للنوع البشري، وآدم وحواء من نفس هذه الحقيقة. لاحظ أن الآية ما قالت: (خلق نفساً واحدة، وخلق منها زوجها، وخلقكم وبث منهما رجالا كثيراً ونساءً) لكي نفهم أن المراد هو تسلسل الوجود البشري في المسار التاريخي، كي نقول خلق آدم ثم خلق حواء من آدم (من الضلع أو من غيره) ثم خلق الامتداد منهما. بل قالت: (خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا) وكأن الآية تريد القول أن حقيقة الذكر والأنثى واحدة، ومن خلال هذا التنوع الجنسي تحقق الامتداد في الوجود البشري (وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً). وبالتالي فلربما كانت رسالة الآية هكذا: يا أيها الناس جميعاً باختلاف أجناسكم (ذكوراً وإناثاً) وباختلاف أعراقكم وقومياتكم وألسنتكم وأديانكم، كلكم بأعدادكم الضخمة وتنوعاتكم الكبيرة، كلكم يرجع إلى (نفس واحدة) أي حقيقة واحدة.. فلم هذا الصراع والإقصاء لبعضكم البعض وعدم التعايش؟
العلاقة الرحمية:
ثم تضيّق الآية دائرة الصراع، وهي الصراعات التي تدور بين الأرحام.. ألستم تُقسمون وتنشدون بعضكم البعض بالأرحام، كما تفعلون ذلك بالله؟ فإذا كانت الرحم بهذا المستوى من المكانة والأهمية عندكم، فلم العدوان على بعضكم البعض أيها الأرحام؟ إن المطلوب أولاً أن تتقوا الله، فتقوى الله يجب أن يكون العامل الأكثر فاعلية في البين، لأن الله هو العليم بكل شئ، والقادر على كل شئ، وسيحاسب على كل شئ. وإن أضفتم إلى ذلك حكم عقولكم، ستجدونها تلزمكم بحسن التعامل مع الآخر من الرحم الذي أنتم تُنشدون به بعضكم البعض وتتعصبون له.. أو أن المطلوب أن تتقوا الأرحام كما تتقون الله، وفق ما يراه بعض المفسرين.. والنتيجة ـ في نهاية المطاف ـ واحدة على التفسيرين.