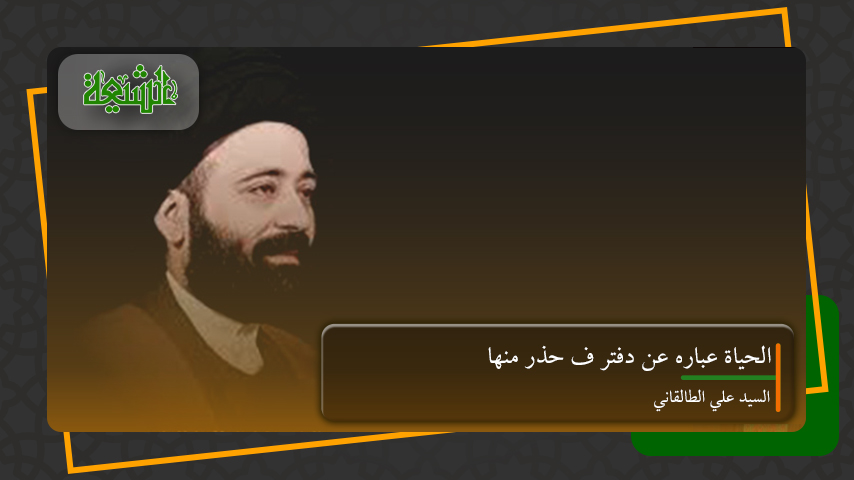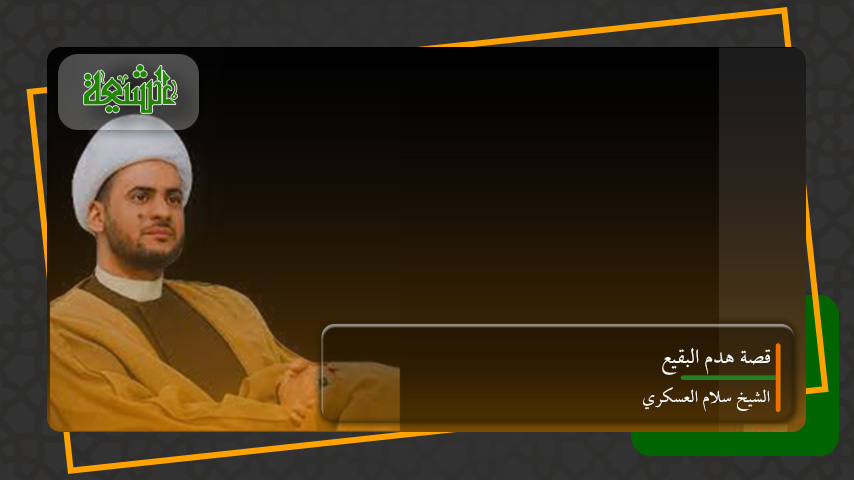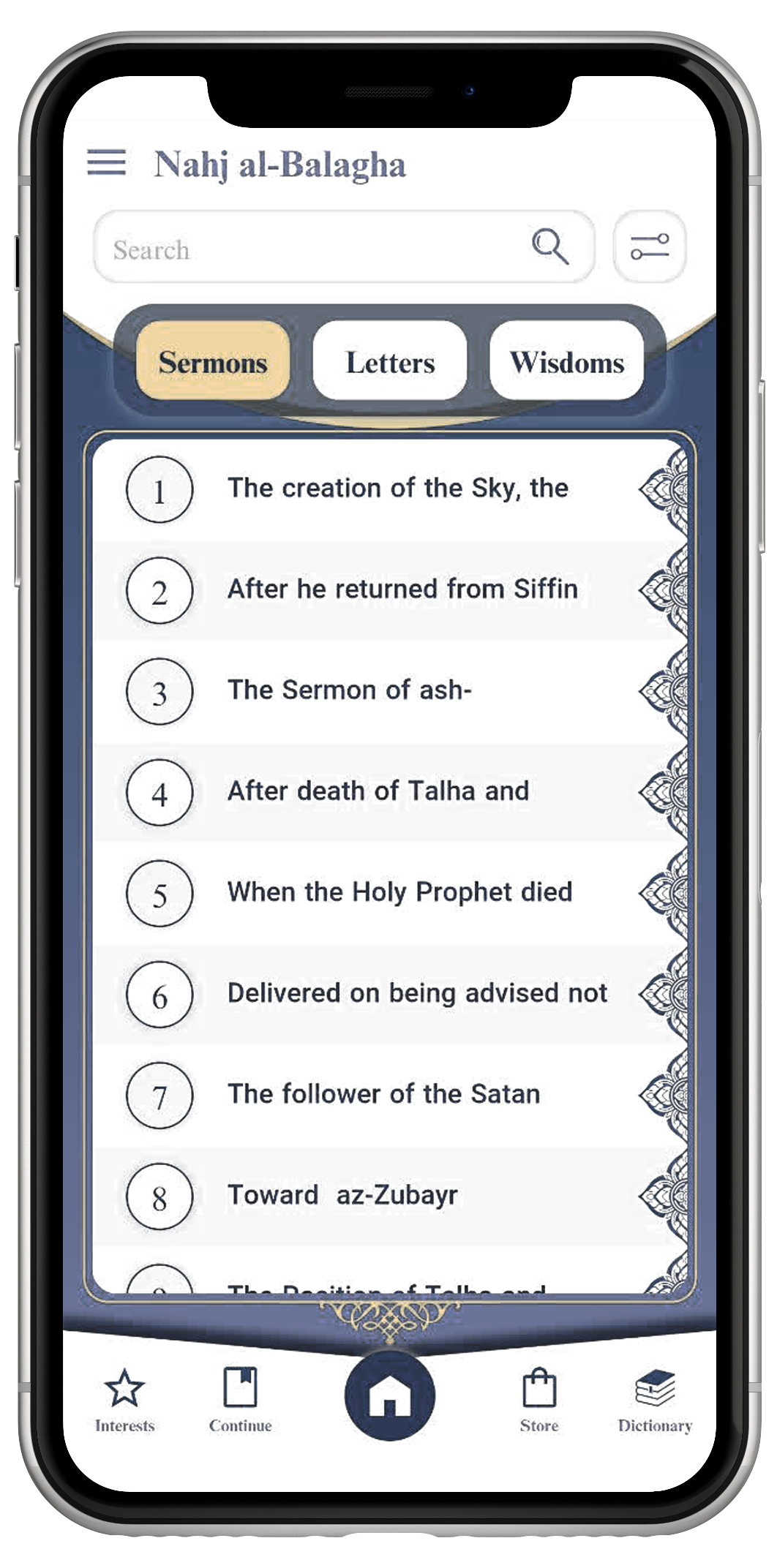الإسلام وشرائعه خير كلّه، ورحمة كلّه، ومصلحة كلّه، وفضل ونعمة مسداة كلّه، مَن دان به رشد، ومَن عمل به سعد، ومَن التزمه فاز ونجا، ومَن أعرض عنه أو انحرف زاغ وضلّ، وتاه وشذّ. وكلّ شيء في هذا الإسلام العظيم من عقيدة قائمة على التوحيد الخالص، والتنزيه المطلق لله.
وعبادة تصقل النفوس، وتهذب الطبائع، وتربي القلب، وتصحح الفكر، وتصلح الفرد والمجتمع. ومعاملة قائمة على الحقّ، والعدل والميزان، والاستقرار.
وأخلاق وفضائل تقوِّم الاعوجاج، وتلجم الأهواء والشهوات، وتنمي عواطف الحبّ والودّ والخير والسلام، وتحقق الاستقامة والرشد، وراحة النفس والضمير، وسلامة الأمة والجماعة… كل هذه العقائد والعبادات، والأخلاق والمعاملات، ذات غايات سامية ومقاصد عالية، هدفها تهذيب النفس الإنسانية، وتربية الإنسان تربية قويمة صحيحة، توفّر على العلماء والدولة والمعلمين ثروات كبرى، لا تحتاج إلا إلى شيء من التذكير والبيان، والتبسيط في تحديد الأهداف والسمات المميزة لها.
وهذا واضح كل الوضوح، ففي جانب العبادات المفروضة في الإسلام ـ من صلاة وزكاة وصيام وحجّ على سبيل المثال ـ حصر دقيق لغاياتها في القرآن، يدور حول التقويم والتهذيب والتربية والإصلاح، وأكتفي بإيراد آية كريمة في كلّ منها عدا الحجّ: ففي قوله تعالى عن الصّلاة: (إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)(۱) بيان الغاية التربوية منها.
وفي قوله سبحانه عن الزكاة: (خذ من أموالهم صدقةً تطهرهم وتزكيهم بها)(۲) إرشاد لجانب التطهير وتزكية النفوس وتخليصها من آفات البخل والشح، وإنقاذ المستضعفين من الفقراء والمساكين من ذلِّ الحاجة والضعف والعوز. وفي قوله ـ عزّ وجلّ ـ عن صيام شهر رمضان: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لعلكم تتقون)(۳) بيان صريح لثمرة الصوم وفائدته العظمى، وهي إعداد النفس لتقوى الله، بترك الشهوات المباحة والمحظورة، وتقويم النفس وتربيتها وتزكيتها، والالتزام بالمأمورات الإلهية، واجتناب المنهيات.
فهذه كلها غايات تربوية سامية تتحقق بممارسة العبادات، ومنها فريضة الحجّ بدءاً من رحلة المغادرة للوطن ثم العودة إليه، وهذه الرحلة تدريب عملي ميداني على آداب الإسلام وأخلاقه، وتجرد خالص للعبادة، وإظهار شامل للطاعة المطلقة، وتصفية الأعمال من شوائب المادة وآصار الدنيا ومغرياتها، وتعلقات الحياة الرغيدة ومفاتنها، وتجوال الفكر العميق في تقديس الله ـ تعالى ـ وجلاله وعظمته، وتحقيق ـ كغيره من العبادات ـ لمنافع الدين والدنيا والآخرة.
قال الله تعالى في كتابه الكريم: (وأذّن في الناس بالحجِّ يأتوك رجالا وعلى كلّ ضامر يأتين من كل فج عميق * ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير)(۴) فجاء الأمر الإلهي ـ في هاتين الآيتين ـ بفريضة الحجّ، مقروناً ببيان حكمة الحجّ، للفرد والجماعة والأمة، في نطاق العبادة والنفع الذاتي والاجتماعي والسياسي، فكانت منافعه وفوائده خاصة وعامة، لأنه بمثابة مؤتمر عام، يستفيد منه الحجّاج فوائد دينية بأداء الفريضة، وتربوية أخلاقية بالممارسة الفعلية للعلاقات الاجتماعية الحساسة والعادية، وسياسية إسلامية.
يتداول فيه المسلمون ـ بنحو جماعي ـ أوضاع بلادهم، وشؤون شعوبهم، بإخلاص وصراحة، وجدية وحرارة، ونقد بنّاء، ومذاكرة في هموم وآمال وآلام الأمة الإسلامية، يعودون بعدها لبلادهم، وهم مزوّدون بماينبغي فعله على الصعيدين: المحلي الخاص والدولي العام، واضعين نصب أعينهم وحدة الأمة الإسلامية ومصلحتها العليا، وأخوّة المؤمنين وما تتطلبه من تضحيات جسام وتعاون وتضامن فعّال، ووقوف بصرامة وجرأة أمام مخططات الأعداء ومؤامراتهم الخبيثة أو المشبوهة، ومحاولة التغلب عليها وإحباطها، حفاظاً على العزّة والكرامة الإسلامية، وحماية لوجود المسلمين، ورعاية لمصالحهم في الداخل والخارج، سواء في وقت السلم والاستقرار، أو في وقت المحنة والحرب والصراع المسلح، والمجابهة الاقتصادية والتحديات المختلفة.
والكلام عن الآية: (ليشهدوا منافع لهم) يحتاج لبيان معنى اللام في الفعل، ومعرفة سبب تنكير كلمة «منافع»، وتحديد أنواع المنافع. أمّا معنى لام «ليشهدوا» فهو ـ كما جاء في تفسير الميزان ـ للتعليل أو الغاية، والجار والمجرور في «لهم» متعلق بقوله: «يأتوك» والمعنى: يأتوك لشهادة منافع لهم، أو يأتوك فيشهدوا منافع لهم.
وجاء في أحكام القرآن لابن العربي: هذه لام المقصود والفائدة التي ينساق الحديث لها، وتنسَّق عليه، ـ أي أنها لام الغاية والصيرورة ـ وأجلّها قوله تعالى: (… لتعلموا أنّ الله على كل شيء قدير وأنّ الله قد أحاط بكل شيء علماً)(۵).
وقد تتصل هذه اللام بالفعل، كما تقدم، وتتصل بالحرف كقوله تعالى: (… لئلا يعلمَ أهلُ الكتاب…)(۶).
وأمّا تنكير كلمة «منافع» فهو كما قال الفخر الرازي: إنما نكّر المنافع ; لأنه أراد منافع مختصة بهذه العبادة، دينية ودنيوية، لا توجد في غيرها من العبادات. وقال الآلوسي: «منافع» أي عظيمة الخطر، كثيرة العدد، فتنكيرها ـ وإن لم يكن فيها تنوين ـ للتعظيم والتكثير، ويجوز أن يكون للتنويع، أي نوعاً من المنافع الدينية والدنيوية.
وأما المراد بكلمة «منافع» فيروى عن محمد الباقر (رضي الله عنه) تخصيص المنافع بالأخروية وهي العفو والمغفرة. وفي رواية عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ تخصيصها بالدنيوية. أي أنه حملها على منافع الدنيا، وهي أن يتجروا في أيام الحجّ، وتكون إذناً بالاتجار، كما جاء في آية أخرى: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم)(۷).
قال القرطبي: ولا خلاف في أن المراد بالآية: التجارة. والأولى عند جماهير المفسّرين حمل الكلمة على الأمرين، أي المنافع الدينية والدنيوية معاً، وروي ذلك عن ابن عباس، فقد أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال في الآية: منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة، فأما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من لحوم البُدْن (الإبل والبقر ونحوهما) في ذلك اليوم، والذبائح والتجارات. وخصّ مجاهد منافع الدنيا بالتجارة، فهي جائزة للحاج من غير كراهة، إذا لم تكن هي المقصودة من السفر. وهذا مستبعد ; لأن نداءهم ودعوتهم لذلك غير مقصود في العبادة، بحسب العادة التشريعية.
والتعميم يشمل أربعة أمور: هي شهود (أي حضور) المناسك، كعرفات والمشعر الحرام، والمغفرة، والتجارة، والأموال، والمعنى: ليحضروا منافع لهم، أي ما يرضي الله ـ تعالى ـ من أمر الدنيا والآخرة، فتتحقق بالحجّ منافع الدنيا والآخرة، وما أكثرها وأجداها لكل مؤمن. وأُرجح القول بالعموم ; عملا بالمعهود من كثرة أفضال الله وعوائده الحسنى على الناس; ولأن مقتضى الترغيب والتحريض على أداء الحجّ يناسب ذلك، ولا داعي للتضييق وتحجير الواسع، فإن سعة رحمة الله شملت كلّ شيء. قال ابن العربي: والدليل عليه عموم قوله: «منافع» فكل ذلك يشتمل عليه هذا القول. وهذا يعضده تفسير قوله ـ تعالى ـ: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) وذلك هو التجارة بإجماع من العلماء. فيكون القصد من المنافع ـ إذن ـ منافع الدنيا والآخرة:
المنافع الدنيوية:
هي التي تكون سبباً لتقدم الحياة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية والعادات كلها. فيكون الحجّ والعمرة مدرسة عملية تدريبية على تحقيق المساواة التامة بين الناس في مظهرهم وحقوقهم وواجباتهم، فلا يتميز غني بغناه، ولا يعرف فقير بفقره، ولا حاكم بعزّته وسلطانه، ولا متنفذ ذو جاه بنفوذه وجاهه، ولا متفوق في أي شيء بتفوقه وتميزه فكراً وعملا واختراعاً وتطبيقاً. الكل يضرعون إلى الله، ويتجهون إلى عزّته، والطمع بعفوه ومغفرته، والجميع يتساوون في أداء المناسك والشعائر في الوقوف بعرفات، والمشعر الحرام، ورمي الجمار، والطواف حول الكعبة المشرفة، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير.
وبعد أداء المناسك يتذاكر الحجاج الآراء في تبادل خيراتهم ومنتجاتهم وثرواتهم، فينتفع الكل فرداً وجماعة، ويعقدون الصفقات أو يصدرون الوعود، وتتم المكاتبات ومعرفة العناوين لإكمال ما تمت المفاوضة حوله. وفي أثناء ممارسة تلك الشعائر يتعاطف الناس، ويتعلمون كيفية التخلص من داء الشح والبخل، فتسخو الأيدي، ويكثر العطاء والبذل، ويزداد الإنفاق في سبيل الله، وتراق الدماء من الأضاحي والقربات، ويعم الخير الطوعي، ويستفيد الكل من هذا وذاك. وهذا يحقق تضامناً وتكافلا اجتماعياً وطيد الجذور بين الأسرة الإسلاميّة الكبرى، ويغتني الفقراء، وتظهر ثمرات نداء سيدنا إبراهيم (عليه السلام) فيما حكاه الله عنه: (ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرّم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون)(۸).
ويقوى الشعور بالانتماء الخالد للأمة الإسلاميّة، والغيرة على مصالحها، والإحساس بواجب المسلم وحقه على أخيه المسلم، وضرورة الإسهام في تفادي المشكلات، وتخطي المحن والأزمات والصعاب، وترسيخ جذور وحدة المسلمين، بالتعارف والتآلف، وتقييم الأحوال والأوضاع، والتخطيط لمستقبل باسم زاهر بعيد عن العثرات والمآسي والآلام. ويشعر الحجّاج بقوة الروابط التي تربطهم بإخوانهم في المشارق والمغارب، والتي أنعم الله بها عليهم، فأنشأها الإيمان، وحققها لهم الإسلام، وأحكم نسيجها بروابط الأخوة السامية المخلصة، والمحبة الصادقة، والودّ في الله ومن أجل الله، والإيثار والتضحية والفداء، والصدق في القول والعمل، والتأثر ببيئة وأحوال الصفا والطهر الذي كان الحجُّ مظلة لها، ومؤثراً في تكوينها، فيسهل اللقاء، وتتجرد النفوس عن الأطماع والمصالح الذاتية، والأهواء والشهوات الصارفة عن جادة الاستقامة. وتظهر في رحلة الحجّ أخلاق سامية ـ عدا ما ذكر ـ من الصبر والتجمل وتحمل الأذى والمشقة، والتخلص من العادات الذميمة والخصال السيئة، والترفع عن المعاصي والذنوب، وتحلي النفوس بعواطف المحبة وتنمية عوامل الخير وصنع المعروف، مما يجعل هذه الرحلة من أقوم السبل المؤدية إلى تهذيب الأنفس وتقويم الطباع، والشعور براحة النفس والأمن والاطمئنان، وغمرة الفرحة والسعادة بأداء الفريضة، وبذكر الله: (… ألا بذكر الله تطمئن القلوب)(۹).
وقد حذّر القرآن الكريم من التورط بما يتنافى مع إيجابيات الحجّ وآدابه المتعددة، فقال تعالى: (الحجُّ أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإنّ خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب)(۱۰). ويبشّر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الحجّاجَ المترفعين عن دنايا الأخلاق، المعتصمين بعفة اللسان وطهارة القلب، يبشرهم بالمغفرة الشاملة، فقال فيما يرويه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي عن أبي هريرة: «مَن حجّ، فلم يرفُثْ، ولم يفسُق، رجع من ذنوبه كيومَ ولدته أُمّه» والرفث كما قال الأزهري: كلمة جامعة لكل مايريده الرجل من المرأة. والفسق: المعصية، وقد جاء من حديث جابر مرفوعاً: «إن بِرَّ الحجّ: إطعام الطعام، وطيبُ الكلام، وإفشاء السلام». ويمكن تلخيص منافع الحجّ الدنيوية: بطهر النفس، ونقاء القلب، وعفة اللسان، وسلامة الجوارح (الأعضاء) من كل ما يشينها ويوقع في الأذى.
منافع الحج الأخروية:
هي وجوه التقرب إلى الله تعالى، بما يمثّل عبودية الإنسان من قول وفعل، وترك لذائذ الحياة وشواغل العيش، كما جاء في تفسير الميزان. وثمرته واضحة وهي محو الذنوب، وغفران السيئات، وتحقيق المساواة بين العباد، فلا تفاضل بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح، كما في قوله تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير)(۱۱). إن مناسك الحجّ ترشد إلى معان كثيرة، لا يصح لحاج تخطيها دون تأمل وإدراك، وإمعان النظر فيها ; لأن فهم الحكمة التشريعية منها تزيد النفس متعة، وتبعث لأداء التكاليف الشرعية والطاعات الإلهية، وتحقق مغزى الحجّ على النهج الرباني المقصود به خير الإنسان وإسعاده.
فالإحرام والتجرّد من لباس الرجال ـ ما عدا ستر العورات بملابس الإحرام المعروفة ـ يقمع شهوات النفس والأهواء، ويبعد الناس عن التفكير في الدنيا، ويوجه الإنسان إلى الخالق والتفكير بقدسيته وعظمته وجلاله، ويؤدي إلى سمو الروح، وترقي الوجدانات والضمائر، وإظهار الخضوع والتواضع لله تعالى، والبعد عن شوائب الكبرياء والغرور، وعلاج أمراض النفس من حبّ الاستعلاء ومزامنة الحقد والشحناء، وإخلاص العمل لله جلّ جلاله، وبغير الإخلاص لله الذي هو جوهر الدين لا قيمة لأي عمل، ولا فضل لأي مسلم في عبادة ومعاملة وخلق وغير ذلك. ومن أهم مقومات الإخلاص: التسامح مع المسلمين، وتطهير النفوس من البغضاء والأحقاد والخصومات لهم، سواء المعاصرون أم الغابرون، عملا بقول الله ـ تبارك وتعالى ـ: (والذين جاءُوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم)(۱۲).
ونشيد التلبية الذي يردّده الحجّاج، بدءاً من الإحرام حتى صباح يوم العيد برجم جمرة العقبة الكبرى شاهد حي، وواقع ملموس على صدق التوجه إلى الله تعالى، والترفع عن أوضار (أوساخ) الدنيا وشهواتها، والتذكير الدائم بطاعة الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. والحضور إلى بيت الله الحرام لزيارته يحقّق منافع الدنيا والآخرة ; لأن شهود الكعبة المشرفة إرواء لتعلق القلوب المتلهفة لها، والإنسان مجبول على حبّ النفع. والطواف حول البيت الحرام يؤكّد وحدة المسلمين العامة، ودليل على التشبه بملائكة الرحمن الحافين حول العرش، وتصعيد الروح نحو العلو الإلهي، وعروج إلى ملكوت الله بالقلب والفكر، وتذكير دائم بصاحب البيت وهو الله جلّ وعلا، وتجديد العهد مع الله على الإقرار بربوبيته ووحدانيته، بدءاً من نقطة الانطلاق في الطواف بالحجر الأسود أو الأسعد ; ليكون قرينة أو أمارة على وحدة العمل بين الناس، وطريقاً لإنفاذ عهد الله على الحقّ والعدل والخير والتوحيد والفضيلة. وهذا العهد الإلهي القديم أشار إليه القرآن المجيد في قوله تعالى: (وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذريَتهم وأشهدهم على أنفسهم، ألستُ بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين)(۱۳).
والسعي بين الصفا والمروة تردد في معالم الرحمة الإلهية، والتماس للمغفرة والرضا الرباني، وتلمس لأفضال الله وخيراته، وطلب عونه لتحمل مشاق الحياة، كما فعلت السيدة هاجر زوج إبراهيم الخليل (عليه السلام) حين أعوزها الماء، فقامت تسعى ضارعة إلى الله ـ تعالى ـ لإرواء ظمئها، وسدّ حاجة ابنها إسماعيل (عليه السلام)، قال الله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما ومَن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم)(۱۴). وقال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)فيما رواه أحمد في مسنده: «اِسعَوا فإن الله كتب عليكم السعي».
والوقوف بعرفة في ساحة الرضوان الإلهي، الساحة الواحدة الشاملة لجميع الحجّاج، إقبال خالص على الله عزّ وجلّ، واتصال روحاني مباشر مع الله، واحتماء بسلطان الله، وطلب فضله ورحمته، موقناً الحاج بإجابة دعائه. وأما الرمي أو رجم إبليس في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة: فهو رمز مادي لمقاومة وساوس الشيطان وأهوائه، والتخلص من نزعات الشر، ومحاربة الفساد والانحراف، فهو كما يقول المناطقة: «المحسوس يدل على المعقول» فيكون رمي الجمرات، واستلام الحجر الأسود، والطواف حول الكعبة، تمثيلا للحقائق بصور المحسوسات، ورمزاً لمعان عميقة بصور حركية مادية، تذكّر المؤمن بأهدافها وغاياتها، وتحمله على استدامة المقاومة لشرور النفس ونزعاتها.
هذا هو القصد من هذه الشعائر، وليس كما يتصور سخفاء العقول من المستشرقين، وضعفاء الإيمان، أن مناسك الحجّ دوران حول أحجار، وتعظيم للرموز المادية، وامتداد للوثنية. وقد تنتهي هذه الشعائر بذبح الأضاحي والنذور وجزاءت المخالفة للمناسك ; ليكون ذلك الوداع الأخير للرذيلة بإراقة الدم تعبيراً عن التخلص منها، والتزام فضيلة التضحية والفداء، كما قال الله تعالى: (لن ينالَ اللهَ لحومُها ولا دماؤها ولكن ينالُه التقوى منكم كذلك سخّرها لكم لِتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين)(۱۵).
وكلّ هذه الشعائر والمناسك ذات المنافع الأخروية، تدل دلالة قوية على الثقة بالله، وطلب أفضاله، وتشعر الإنسان في أعماق نفسه بعظمة الله وجلاله ; وحلاوة مناجاته وعبادته، وطلب رضاه وقربه، فيكثر البكاء، ويشتدّ النحيب، وتصفو النفوس، وتتكاثر حالات التوبة النصوح الخالصة لله والندم على الماضي. هذا فضلا عن تذكر أهل الإيمان بماضي الإسلام، وجهاد نبيّ الله وصحبه الكرام في نشر دعوة الله، وتحطيم معاقل الشرك، وهدم معالم الوثنية، وتهاوي الأصنام، وانتصار دعوة الحقّ والتوحيد. وما أجمل منافع الحجّ في حديث رواه البيهقي: «الحجاج والعمّار وفد الله، إن سألوا أُعطوا، وإن دعوا أُجيبوا، وإن أنفقوا أُخلف لهم» !.
ــــــــــــــ
(۱) العنكبوت: ۴۵٫
(۲) التوبة: ۱۰۳٫
(۳) البقرة: ۱۸۳٫
(۴) الحج: ۲۷ – ۲۸٫
(۵) الطلاق: ۱۲٫
(۶) الحديد: ۲۹٫
(۷) البقرة: ۱۹۸٫
(۸) ابراهيم: ۳۷٫
(۹) الرعد: ۲۸٫
(۱۰) البقرة: ۱۹۷٫
(۱۱) الحجرات: ۱۳٫
(۱۲) الحشر: ۱۰٫
(۱۳) الأعراف: ۱۷۲٫
(۱۴) البقرة: ۱۵۸٫
(۱۵) الحجّ: ۳۷٫
الكاتبة: وهبة الزحيلي