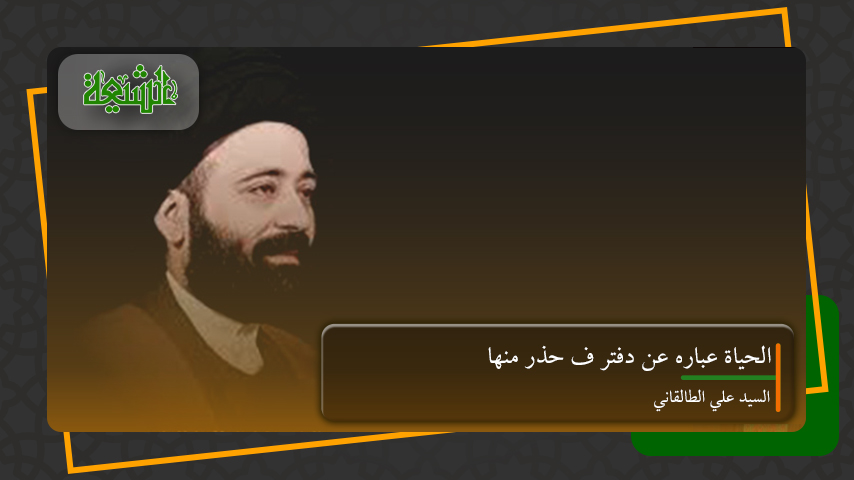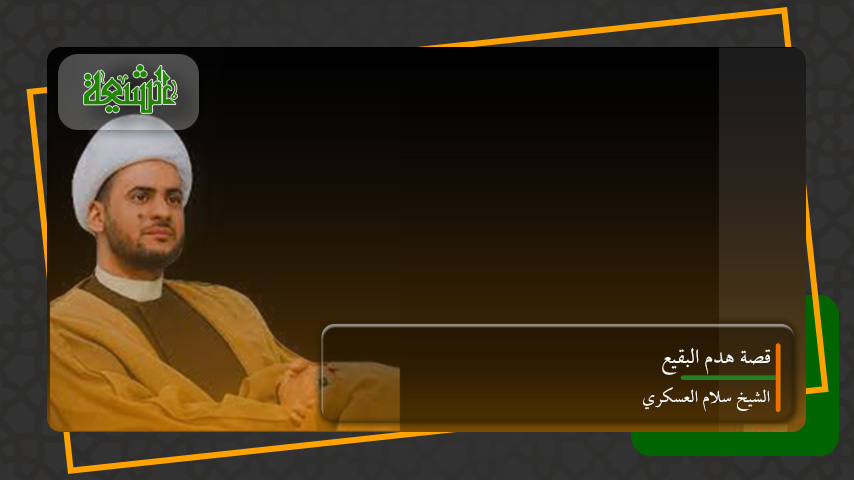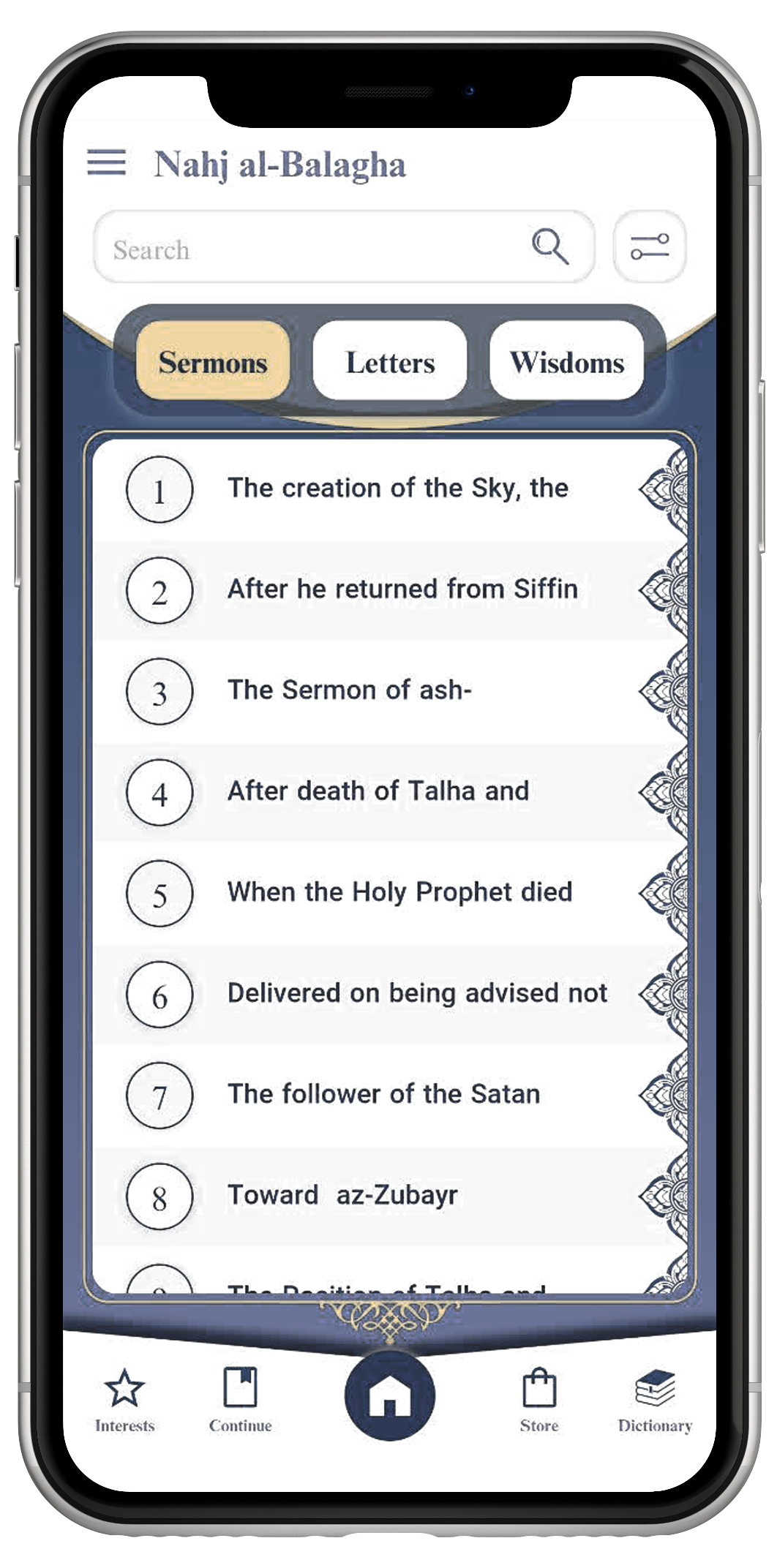التكليف حسن لكونه تعريضا لما لا يصل إليه إلا به ، ويشتمل على خمس مسائل :
أولها : ما التكليف ؟
وثانيها : ما يجب كون المكلف عليه من الصفات .
وثالثها : ما يجب كون المكلف تعالى عليه من الصفات .
ورابعها: بيان الغرض في التكليف .
وخامسها : بيان المكلف وصفاته التي يحسن معها التكليف .
فأما حقيقة التكليف ، فهي : إرادة الأعلى من الأدنى ما فيه مشقة على جهة الابتداء ، الدليل على صحة ذلك : أنه متى تكاملت هذه الشروط وصف المريد بأنه مكلف ، والإرادة بأنها تكليف ، والمراد منه بأنه مكلف ، ومتى اختل شرط لم يثبت شئ من هذا الوصف .
وأما ما يجب كون المكلف عليه من الصفات فيجب أن يكون المكلف بالحسن منعما بنعم يوجب طاعته على المكلف ، معلوما أو مظنونا من حاله أنه لا يريد قبيحا .
وأما ما يجب كونه تعالى عليه من الصفات في حق كونه مكلفا ما يشق فعلا وتركا تعريضا للثواب ، ويلزم المكلف عبادته كذلك ، فينقسم إلى صفات هو سبحانه تعالى عليها ، وصفات يتعلق بأفعاله .
فأما ما يخصته تعالى ، فكونه تعالى قادرا على كل ما يصح كونه مقدورا ، عالما بكل معلوم ، لا يجوز خروجه عن الصفتين ، ليقطع المكتف على وصوله إلى ما لا يحسن التكليف من دونه .
ومريدا ، لان اختصاص التكليف بوجه يفتقر إلى كون المكلف سبحانه مريدا له دون غيره .
وعلى الصفات التي لا تتم هذه الصفات من دونها ، أو هي مقتضاة عنها ، كموجود وحي وقديم .
وينفي عنه تعالى ما يقدح في ثبوتها : من التشبيه ، والادراك بالحواس ، والحاجة ، والثاني .
وأما ما يتعلق بأفعاله ، فأن يكون حكيما لا يفعل قبيحا ، ولا يريده ، ولا يخل بواجب ، من حيث كان تجويز خلاف ذلك يرفع الثقة بما لا يحسن ح ؤ التكليف إلا معه ، ويعلم ما يقتضي ذلك من المسائل وفساد ما يقدح فيه .
وأن تكون له نعم يستحق بها العبادة ، بأن تكون مستقلة بأنفسها لا تفتقر إلى غيره .
وأن تكون أصولا للنعم ، فلا تقدر نعمة منفصلة عنها ، ولا يحصل من دونها .
وأن يبلغ في الغاية في العظم إلى حد لا يساويها نعمة .
وإنما قلنا ذلك ، لأن العبادة المستحقة له تعالى غاية في الشكر ، فلا بد من اختصاصها بغاية من العظم ، وافتقار كل نعمة إليها من حيث اختص شكرها بالغاية التي لا يبلغها شكر ، وهو كونه عبادة .
وقد علمنا ما هو عليه تعالى من الصفات ، وكونه حكيما بما تقدم ، وعلمنا ثبوت الشروط التي اعتبرناها في نعمه : من الايجاد والحياة والإقدار وفعل الشهوة والمشتهى ، وكون ذلك أصلا لكل نعمة ، وافتقار كل نعمة إليها ، وتعذر انفصالها منها ، وبلوغها الغاية في العظم ، وانغمار جميع نعم المحدثين في جنب بعضها .
فيجب كونه تعالى مستحقا للعبادة دون كل منعم .
في الغرض من التكليف
ويجب أن يكون له تعالى غرض في التكليف يحسن لمثله ، لأن خلوه من غرض أو ثبوت غرض لا يحسن لمثله لا يجوز عليه سبحانه .
ويجب كونه تعالى مزيحا لعلة المكلف بالتمكين والاستصلاح والبيان ، لأن تكليفه من دون ذلك قبيح على ما بينته.
وأما الوجه في ابتداء الخلق وتكليف العقلاء منهم ، فالخلق جنسان : حيوان ، وجماد .
فالغرض في إيجاد الحي منه لينفع المكلف بالتفضل والثواب ، ويجوز العوض ، ويجوز أن يكون في خلقه لطف غيره .
وغير المكلف فالتفضل والعوض ، ويجوز أن يكون في خلقه لطف للمكلف .
وغير الحي الغرض في خلقه نفع الحي .
وقلنا : إن الغرض في تكليف العاقل التعريض للثواب .
لأنه سبحانه لما خلقه وأكمل عقله وجعله ذا طباع يقبل إلى القبيح وينفر عن الواجب ، ولم يغنه بالحسن عن القبح ، ولم يجز أن يكون ذلك لغير غرض لكونه عبثا ، ولا لغرض هو الانتفاع به أو دفع الضرر لاستحالتهما عليه تعالى ، ولا للإضرار به لكونه ظلما ، ولا لدفع الضرر عنه لكونه قادرا على ذلك من دون التكليف فيصير عبثا .
علمنا أن الغرض هو التعريض للنفع .
وقلنا : إن التعريض للنفع حسن .
لعلمنا – وكل عاقل – بحسن تكلف المشاق في أنفسنا ، وتعريض غيرنا لها تعريضا للنفع ، واستحقاق المدح من عرض غيره لنفع ، كاستحقاقه على إيصاله إليه .
وقلنا : إن هذا النفع ثواب .
لأن ما عداه من ضروب المنافع يحسن منه تعالى الابتداء بها ، فلا يجوز أن يكلف المشاق لما يحسن الابتداء به ، لأن ذلك عبث لا يجوز عليه سبحانه .
وقلنا : إن الثواب مما يقبح الابتداء به .
لكونه نفعا واقعا على جهة الاعظام مقترنا بالمدح والتبجيل ، ومعلوم ضرورة قبح الابتداء بالمدح والتعظيم ، وإنما يحسن مستحقا على الأمور الشاقة الواقعة عن إيثار ، ولذلك اختصت منافع من ليس بعاقل من الأحياء بالتفضل والعوض دونه ، لتعذر استحقاقهم له .
ووجود الجماد لنفع الحي ظاهر في أكثره ، وما لا يعلم ذلك من حاله تفصيلا فمعلوم على الجملة ، من حيث كان خلاف ذلك يقتضي كون موجده سبحانه عابثا ، وذلك فاسد .
ولا يقدح في حسن تكليف العاقل للوجه الذي بيناه تكليف من علم من حاله أنه يكفر أو يعصي ، لأن الوجه الذي حسن تكليف من علم من حاله أنه يؤمن قائم فيه ، وهو التعريض للثواب ، وكونه سبحانه عالما من حاله أنه لا ينتفع بما عرض له لا ينقض الغرض المجري بالتكليف إليه ، لأن المعرض للنفع الممكن من الوصول إليه محسن إلى المعرض وإن علم أو ظن أنه لا ينتفع ، بل يستضر بسوء اختياره .
يوضح ذلك : حسن عرض الطعام على الجائع ، وإدلاء الحبل إلى الغريق لينجو وإن ظن أنهما لا يفعلان .
والقديم سبحانه وإن علم في من عرضه بتكليفه لنفع عظيم أنه لا يقبل ما يصل به إليه ، بل بسوء النظر لنفسه ، فيختار هلاكه على بصيرة من أمره وتمكن من صلاحه ، لا يخرجه سبحانه عن كونه محسنا إليه بالتعريض للنفع العظيم ، ولا يقتضي قبح فعل المكلف وسوء نظره لنفسه قبح فعله تعالى من التعريض .
فما اختاره العبد المسئ وعلمه سبحانه بأنه لا يؤمن ليس بوجه قبح ، كما أن علمنا بأن جميع الكفار لو جمعوا لنا ودعوناهم لم يؤمنوا ليس بمقتض لقبح دعوتنا لمم إلى الإيمان .
وآكد ما اعتمد عليه في هذا الباب : أنه سبحانه قد كلف من علم أنه يكفر أو يعصي مع علمنا بحكمته سبحانه ، وأنه لا يفعل قبيحا ولا يريده ، وقد كلف من علم أنه يكفر أو يعصي ، فيجب القطع على حسنه ، لكونه من فعله ، وهذا يغني عن تكلف كلام لإفساد كون هذا التكليف لشئ من وجوه القبح ، كالظلم والاستفساد وغيرهما .
وإذا كان الوجه في حسن التكليف كونه تعريضا ، فينبغي أن نبين ما التعريض المقتضي لحسن التكليف ، وهو مفتقر إلى شروط ثلاثة :
أولها : أن يكون المعرض متمكنا مما عرض له .
وثانيها : أن يكون المعرض مريدا لما عرض بفعله للثواب .
وثالثها : أن يكون المعرض عالما أو ظانا وصول المعرض إلى ما عرض له متى فعل ما هو وصله إليه .
والدلالة على الشرط الأول : قبح تعريض الأعمى لما لا يتم إلا بالرؤية ، والزمن لما لا يصل إليه إلا بالسعي ، بأوائل العقول .
والدلالة على الشرط الثاني : أن من مكن غيره بإعطائه المال من المنافع والمضار لا يكون معرضا له لأحدهما إلا بالإرادة .
وكون المكلف مريدا لما عرض لفعله النفع كاف عن كونه مريدا للنفع في حال التعريض ، لأن من عرض ولده للتعليم ليستحق المدح والتعظيم يكفي في حسن تعريضه كونه مريدا التعليم ما أجري به إليه من المدح والتعظيم ، بل لا يحسن إرادتهما في حال التعريض ، لكونهما غير مستحقين في تلك الحال ، ولهذا قلنا : إنه سبحانه مريد للتكليف في حال الامر به أو إيجابه عقلا ، دون ما هو وصله إليه من الثواب ، لقبح إرادة ثواب التكليف في تلك الحال ، ولأن الثواب متأخر عن التكليف ، وكونه تعالى مريدا للشئ قبل حدوثه لا يصح ، لكون الإرادة الواقعة على هذا الوجه عزما يستحيل عليه تعالى .
وليس لأحد أن يقول : إن إعلام المكلف وجوب الواجب وقبح القبيح يغني عن كونه مريدا .
لأن ذلك يقتضي كونه معرضا لما أعلم وجوبه وإن كره فعله ، وذلك فاسد ، ولأن أحدنا قد يعلم غيره وجوب واجبات وقبح أشياء ولا يكون معرضا لأحدهما إلا بكونه مريدا .
والدلالة على الشرط الثالث : أن التعريض بسلوك طريق إلى مصر لا يوصل إليه منه على حال ليصل إليه قبيح .
وهذه الشروط أجمع ثابتة في تكليفه تعالى ، لأنه مريد لما كلفه حسب ما دللناه عليه ، والمكلف قادر على ما كلفه ، معلوم من حاله وصوله إلى ما عرض له من الثواب بامتثاله ما كلفه حسب ما دللنا عليه ، وذلك يقتضي حسن التكليف ، وإذا ثبت حسن التكليف وجب ، لأنه لا واسطة بين وجوبه وقبحه ، من حيث كان القديم سبحانه قادرا على أن يغني العاقل بالحسن عن القبيح ، فإذا لم يفعل وأحوجه إليه بالشهوات المخلوقة فيه وخلى بينه وبينه ، فلا بد أن يكلفه ، لأنه إن لم يكلفه الامتناع منه وإن شق تعريضا لعظيم النفع بالثواب كان مغريا له بالقبح ، وذلك لا يجوز ( عليه ) تعالى .
وأما بيان الأفعال التي تعلق بها التكليف وصفاتها ، فمن حق ما تعلق التكليف بفعله أو تركه عقلا وسمعا صحة إيجاده ، لأن تكليف ما لا يصح إيجاده قبيح ، كالجواهر والحياة ، ولا يحسن تعلقه بما لا يستحق بفعله أو بأن لا يفعل الثواب ، لأن الغرض الذي له حسن كونه تعريضا للثواب ، فلا يحسن تكليف ما لا يوصل بفعله أو تركه إليه .
وهو ينقسم إلى ما يستحق بفعله الثواب ، وإلى ما يستحق بأن لا يفعل العقاب وهو الواجب ، وإلى ما لا حكم لتركه وهو الندب والاحسان ، وإلى ما يستحق بأن لا يفعل الثواب وهو القبيح ، ولا مدخل للمباح في التكليف ، حيث كان لاحظ لفعله ولا تركه في استحقاق الثواب ، وما لا يوصل إلى الثواب لا يحسن تكليفه .
ولا بد لما كلف إليه تعالى فعله أو تركه من وجه اقتض ذلك فيه ، لأنه لولا وجه اقتضاه لم يكن ما وجب أولى بذلك من الندب أو القبيح من الوجوب والندب .
والتكليف على ضربين : ضروري ، ومكتسب .
والضروري على ضربين : واجب ، وندب .
والواجبات على ضربين : أفعال ، وتروك .
والأفعال : العدل ، والصدق ، وشكر النعمة ، وأمثال ذلك .
والتروك : الظلم ، والكذب ، والخطر ، وتكليف ما لا يطاق ، وأمثال ذلك .
وجهة وجوب الأفعال وقبح التروك كونها عدلا وصدقا وظلما وكذبا ، لأن كل من علمها كذلك علم وجوب ذلك وقبح هذه .
والمندوبات على ضربين : أفعال ، وتروك .
والأفعال : الإحسان ، والحلم ، والجود ، وقبول الاعتذار والعفو وأشباه ذلك .
والتروك : خلاف ذلك .
وجهة كون هذه مندوبا إليها كونها كذلك ، لأن كل من علمها علمها مندوبا إليها .
والمكتسب على ضربين : عقلي وسمعي .
والعقلي : العلم بحدوث العالم وإثبات محدثه ، وما يجب كونه تعالى عليه من الصفات وإحكام أفعاله وما يتعلق بها ، والحكم لجميعها بالحسن ، ولا تعلق لشئ منه بأفعال الجوارح ولا ترك فيه ، وجهة وجوب هذا التكليف كونه شرطا في العلم بالثواب والعقاب الذي هو اللطف في التكليف الضروري ، ولكونه شرطا في شكر النعمة ، وقد سلف برهان ذلك .
والسمعي على ضربين : أفعال ، وتروك .
والأفعال : مفروض ، ومسنون .
وجهة وجوب الفرائض : كونها لطفا في فعل الواجب العقلي وترك القبيح ، وقبح تركها لأنه ترك لواجب .
وجهة الترغيب في المسنون : كونه لطفا في المندوب العقلي ، ولم يقبح تركه كما لم يقبح ترك ما هو لطف فيه .
والتروك : الزنا ، والربا ، وشرب الخمر ، وسائر القبائح الشرعية ، وجهة قبحها : كون فعلها مفسدة في القبح العقلي ، ووجب تركها لأنه ترك لقبح .
والواجب في هذا التكليف العلم دون الظن ، وطريقه الكتاب والإجماع والسنة المأثورة عن الصادقين عليهم السلام ، والعمل به لوجوهه المخصوصة ، وقد دللنا على صحة هذه الفتيا وفصلنا ما أجملناه هاهنا في مقدمتي كتابي العمدة والتلخيص في الفروع .
ومن شرط الحسن في تكليف هذه الأفعال والتروك تقوية دواعي مكلفها إلى ما يختار عنده أفعالها ، وصوارفه عن تروكها ، أو يكون إلى ذلك أقرب ، دون ما يقتضي الإلجاء المنافي للتكليف ، لأن ذلك جار مجرى التمكين .
فمتى علم سبحانه في شئ كونه لطفا في التكليف على أحد الوجهين وكان مختصا بمقدوره سبحانه فلا بد أن يفعله ، وإن كان من مقدورات المكلف فلا بد من بيانه له وإيجابه عليه ، وإن كان اللطف لا يتم إلا بفعله تعالى وفعل المكلف وجب عليه سبحانه فعل ما يختص به وبيان ما يختص المكلف وإيجابه ، وإن كان من فعل غير المكلف فعلم سبحانه أن ذلك الغير يفعل هذا اللطف حسن تكليف هذا ، وإن علم أنه لا يختاره وفي أفعاله تعالى أو أفعال المكلف بدل منه فعل ما يختصه وبين ما يختص المكلف ، وإن لا يكن له بدل أسقط تكليف ما ذلك اللطف لطف فيه ، لأن تكليفه والحال هذه قبيح على ما بينته ، وتكليف غيره ما لا مصلحة له فيه قبيح أيضا ، وإن كان لطفه يتعلق بفعل قبيح أو بما لا يصح إيجاده فلا بد من إسقاط تكليفه ، لتعلقه بما لا يصح إيجاده أو يقبح فعله.
وقلنا بوجوب ما ذكرناه .
لأنه لا فرق في قبح المنع بينه وبين قبح المنع من التمكين .
يوضح ذلك : أن من صنع طعاما لقوم يريد حضورهم نفعا لهم وعادته جارية في استدعائهم برسول ، فلم يفعل الارسال مع كونه مريدا لحضورهم يستحق الذم ، كما لو أغلق الباب دونهم ، ولا شبهة في وجوب ما يستحق الذم بتركه .
وإذا صح هذا وكان القديم سبحانه مريدا لتكليفه ، فلا بد أن يفعل له ما يعلم أنه يختار التكليف عنده أو يكون أقرب إليه ، أو يبتنه له إن كان من فعله ، وسقط تكليفه إن كان معلقا بما لا يصح إيجاده أو يقبح أو مختصا بفعل غيره مع العلم بأنه لا يفعله ولا بدل له ، لكونه تعالى عادلا لا يخل بواجب في حكمته سبحانه .
وما هو من فعله تعالى لا بد أن يكون معلوما للملطوف له به أو مظنونا أو معتقدا لكونه داعيا ، وما لا يعلم ولا يظن ولا يعتقد لا يكون داعيا ، وسواء كان ما هو من فعله تعالى لطفا في واجب أو مندوب إليه أو ترك قبيح ، فإنه يجب في حكمته سبحانه فعله ، لكونه مريدا للجميع ، وبيان ما هو لطف من فعل المكلف في التكاليف الثلاثة .
فأما ما يختص المكلف ، فالواجب عليه فعل ما هو لطف في واجب وترك قبيح ، وترك ما هو مفسدة فيهما ، وهو في لطف المندوب بالخيار ولا فرق في إعلامه ما هو لطف له في تكليفه وإزاحة علته بين أن ينص له على كونه كذلك وبين أن يوجب عليه فعلا بدليل عقلي أو سمعي ، فيعلم بذلك كونه لطفا في واجب ، أو يوجب عليه تركه فيعلم بذلك كون فعله مفسدة ، أو يرغبه في فعل أو ترك فيعلم كونه لطفا في مندوب ، بحسن تكليفه ما هذا اللطف لطف فيه وإن جهله كذلك إذا كان متمكنا من العلم به ، لكون علته مزاحمة بالتمكين وإن فرط فيما يجب عليه .
ومن شرط اللطف أن يتأخر عن التكليف ولو بزمان واحد لكونه داعيا ، ولا يتقدر الدواعي إلى غير ثابت ، فإن علم سبحانه في فعل من الأفعال أنه إن صاحب التكليف دعا إلى اختياره فليس ذلك بلطف ، لكونه وجها وسببا لحصول التكليف.
فوصف هذا الجنس من الأفعال بأنه لطف اشتقاقا من التلطف للغير في إيصال المنافع إليه ، ويسمى صلاحا لتأثيره وقوع الصلاح أو تقريب المكلف إليه ، ويسمى استصلاحا على هذا الوجه ، ويسمى منه توفيقا ما وافق وقوع الملطوف به فيه عنده .
ويسمى منه عصمة ما اختار عنده المكلف ترك القبيح على كل حال تشبيها بالمنع من الفعل ، وإن كان الفعل القبيح إنما ارتفع مع اللطف باختيار المكلف ومع المنع لأجله ، فساوى الحال في ارتفاع القبيح على كل وجه وإن اختلف جهتا الارتفاع ، فلذلك سمي الملطوف له بهذا الضرب من اللطف معصوما ، ويجوز أن يكون الوجه في التسمية بمعصوم من حيث كان مفعولا له ما امتنع معه من القبيح تشبيها بالممنوع على الوجه الذي بيناه .
ولا يلزم على هذا عصمة سائر المكلفين ، لأن ما له هذه الصفة من الألطاف موقوف على ما يعلمه سبحانه من كونه مؤثرا في اختيار المكلف ما كلف فعله أو تركه ، وما هذه حاله يجوز أن يختص ببعض المكلفين ، ولا يكون في المعلوم شئ يعلم من حال الباقين كونهم مختارين لما كلفوه عنده ، فيختص فعله إذ ذاك بمن علم من حاله كونه غير مختار عنده لشئ من القبائح ، دون من علم أنه لا يترك القبح عند شئ من الأفعال ، كما خبر عنهم سبحانه بقوله : ( ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شئ قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ) ( 1 ) ، يريد : أن يشاء إلجائهم ، وكقوله سبحانه : ( ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ) ( 2 ) ، وأمثال ذلك من الآيات الدالة على وجود مكلفين لا يختارون شيئا من الطاعات ، ولا يتركون شيئا من القبائح ، وإن فعل لمم كل آية .
يحسن تكليف من يعلم أنه لا لطف له وأنه يطيع أو يعصي على كل حال ، لأنه متمكن بجميع ضروب التمكين مما كلف ولم يمنع واجبا ، وليست هذه حال من لطفه في القبيح أو فيما لا نهاية له ، لأن هذا اللطف لم يفعل له ، فقبح تكليفه .
وأما الصلاح الدنيوي العري من وجوه القبح فغير واجب ، لأنه لا تعلق له بالتكليف ولا له في نفسه صفة وجوب كالصدق والإنصاف ، لأن وجوب ما هذه حاله معلوم ضرورة على جهة الجملة ومكتسبا على جهة التفصيل ، ولأنه لو كان له وجه يقتضي وجوبه لكان ذلك لكونه نفعا ، وذلك يوجب كل نفع لا ضرر فيه على الفاعل والمفعول له ، والمعلوم ضرورة خلاف ذلك ، لوجودنا سائر الأغنياء من العقلاء يمنعون غيرهم ماله هذه الصفة ولا يستحقون ( به ) الذم من أحد .
وتعلق القائلين بالأصلح في إثبات وجه لوجوبه : بذم مانع الاستظلال بظل حائطه ، والتقاط المتناثر من حب زرعه ، وتناول الماء من نهره .
ليس بصحيح ، لأنه لو كان الوجه فيه كونه نفعا خالصا لوجب كل نفع خالص ، لأن صفة الوجوب لا تختص بمثل دون مثل ، وقد علمنا ضرورة خلاف ذلك ، وإنما قبح المنع بحيث ذكروه لكونه عبثا لا غرض فيه ، ولهذا متى حصل فيه أدنى غرض حسن ، ولو كان الوجه في قبح منعه كونه نفعا خالصا لم يحسن ، لوجود غرض فيه كالظلم ، على أن مثالهم بخلاف الأصلح ، لقولهم بوجوب فعل ما فيه نفع خالص ، وقد علمنا أنه لا يجب بناء الحائط للاستظلال به ، ولا حفر النهر لتناول الماء منه ، ولا نثر الحب للالتقاط ، وإذا لم يجب فلا شاهد لهم .
ولا لهم أن يتعلقوا في إيجابه : بأن فاعله جواد ومانعه بخيل ، وصفة الجود مدح وهو جدير بها سبحانه ، وصفة البخل ذم لا يجوز عليه تعالى .
لأن ذلك تعلق بعبارة يجوز غلط مطلقها وصوابه ، ولا يجوز إثبات وجه الوجوب والقبح للموصوف ضرورة أو استدلالا ؟ ولا يجوز عند أحد من العلماء إثبات صفات الذوات بها ، على أن المعلوم اختصاص إطلاق الجود والبخل بغير من ذكروه ، لأنه لا أحد يصف من لم يمنع من الاستظلال والالتقاط الذي هو شاهد طم بأنه جواد ، وإنما يصفون بذلك من أكثر الإحسان كحاتم وإن كان عليه فيه ضرر ، بل لا يصفون بالجود من له إحسان ما ، ولو كان الجود اسما لمن ذكروه لوجب اختصاصه به ، أو إطلاقه ، والمعلوم خلاف ذلك .
وأما بخيل فليس بوصف لمن ليس بجواد ، يعلمنا بوجود أكثر العقلاء غير موصوفين بالجود ولا البخل ، ولو كان اسما لمن منع نفعا خالصا لوجب وصف كافة العقلاء به ، حتى الأنبياء والأوصياء والفضلاء ، لأنه لا أحد منهم إلا وهو مانع ماله هذه الصفة ، وإنما هو مختص بمانع الواجب عليه لغيره ، لكونه اسما للذم حسب ما نطق به القرآن ، وإطلاق العرب له ( على ) مانع القرى لاعتقادهم وجوبه عليهم ، ولهذا لا يصفون به من أخل بواجب يختصه ، ولا مانع التفضل على كل حال ، ويجوز أن يكون ذلك مجازا ، والمجاز لا يقاس عليه ولا يجعله أصلا يرجع إليه .
فسقط ما تعلقوا به معنى وعبارة ، والمنة لله .
وأيضا فإن المفعول منه في الوقت الواحد لا بد من انحصاره ، لوجوب انحصار ما يخرج إلى الوجود ، وما زاد عليه مما حكمه حكمه في النفع لا يخلو أن يكون مقدورا له تعالى أو غير مقدور ولا يصح كونه غير مقدور ، لكونه تعالى قادرا لنفسه ، ولكونه مقدورا لا يخلو أن يكون واجبا أو غير واجب ، وكونه واجبا يقتضي كونه تعالى غير منفك في حال من الاخلال بالواجب ، فلم يبق إلا أنه غير واجب .
وليس لأحد أن يقول : فأنتم تجيزون فعل الأصلح ، فيلزمكم في الجواز ما ألزمتموه في الوجوب .
لأن الاخلال بالواجب لا يجوز عليه تعالى ، والاخلال بالجائز جائز منه ، فافترقا بغير شبهة .
وليس له أيضا أن يقول : القدر الزائد إن كان صلاحا فلا بد أن يفعله ، وإن لم يكن كذلك فلا مسألة علينا .
لأنا فرضنا مساواة القدر الزائد المعدوم لما وجد منه في الصلاح ، فاقتضى سقوط وجوب الأصلح ، أو كونه تعالى غير منفك من الاخلال بالواجب ، فسؤالهم إذن خارج عن تقديرنا .
ولنا في هذا الدليل نظر لا يحتمله كتابنا هذا .
وأيضا فلو لم يكن في أفعاله تعالى ما له صفة الإحسان لا يجب شكره ، لاختصاص الشكر به دون سائر الأفعال ، فإذا لم يتعين شكره لم يستحق العبادة ، لكونها كيفية في الشكر وذلك ضلال .
وأيضا فإنا نعلم ضرورة أن من جملة الأفعال الواقعة منا ما يستحق به الشكر والمدح ، ولا يستحق به الذم ، كما نعلم أن من جملتها واجب ومباح ، فيجب أن يكون تعالى قادرا لنفسه على ما هذه حاله ، وذلك ينتقض قوله : إنه ليس في الشاهد ولا الغائب ما يخرج عن واجب في العدل أو واجب في الجود .
وأما المكلف ، فهو الجملة الحيث المشاهدة ، بدليل حصول العلم بوقوع الأفعال الدالة على كون من تعلقت به قادرا ، والمحكمة المترتبة الدالة على كون من تعلقت به عالما مريدا منها ، والقادر العالم المريد هو الحي المكلف .
وإذا كان المعلوم استناد ما دل على كونه كذلك إلى الجملة ، وجب وصفها به دون ما لا يعلم ولا يظن تعلق التأثيرات به ، إذ كان نفيها عن الجملة المعلوم ضرورة تعلقها بها وإضافتها إلى من لا يمكن إضافتها إليه إلا على هذا الوجه تجاهل ، ولا نعلم حصول الإدراك بأبعاضها ، والمدرك هو الحي ، فيجب أن يكون كل عضو حصل به الإدراك من جملتها .
ولأن الأفعال تقع بأطرافها ، ويبتدئ بها التأثيرات المحكمة ، ويخف باليدين ما يثقل باليد الواحدة ، ولا وجه لذلك إلا كون هذه الأعضاء محلا للقدر ، ومحل القدر هو القادر ، والقادر هو الحي .
وليس لأحد أن يقول : ما المانع من كون الحي غيرها ، وتقع أفعاله فيها مخترعة .
لأن الاختراع يتعذر بجنس القدر ولأنه لو صح منه أن يخترع فيها لصح في غيرها ، وذلك محال ، ولأنه لو صح منه الاختراع لجاز أن يخترع في الإصبع الواحدة من حمل الثقيل ما ينقل باليدين ، والمعلوم خلاف ذلك ، ولأنا نعلم انتفاء الحياة بانتقاض هذه البنية ، ولو كان الحي غيرها لكان لا فرق بين قطع الرأس والشر ، والمعلوم خلاف ذلك.
وببعض ما قدمناه يبطل كون الحي بعض الجملة ، لصحة الإدراك بجميع أبعاضها ، وبوقوع الأفعال في حالة واحدة بكثير من أعضائها ، مع تعذر الاختراع على ما بيناه .
وأما صفات المكلف ، فيجب أن يكون قادرا ليصح منه إيجاد ما كلف ، والقدرة مختصة بمقدوراته سبحانه ، فيجب عليه فعلها .
وإن كان التكليف يفتقر إلى آلة وجب في حكمته سبحانه فعل ما يختصه كاليد والرجل ” وتمكينه من تحصيل ما يختصه كالقلم والقوس ، لتعذر الفعل المفتقر إلى آلة من دونها ، لتعذره من دون القدرة .
وإن كان التكليف مما يفتقر العلم به والعمل إلى زمان وجب تبقية الزمان الذي يصحان في مثله ، لأن اخترامه من دونه قبيح .
ويجب أن يكون عالما بتكليفه ووجهه ، أو متمكنا من ذلك ، لأن الغرض المقصود من الثواب لا يثبت مع الجهل بوجوب الأفعال ، لاختصاص استحقاقه بإيقاع ما وجب أو ندب إليه واجتناب ما قبح للوجه الذي له حسنا وقبح هذا ، ولأن المكلف لا يأمن براءة ذمته مما وجب عليه فعلا وتركا من دون العلم بهما .
فما اقتضت الحكمة كونها من فعله تعالى ، فلا بد من فعله للمكلف ، كالعلم بالمشاهدات بأوائل العقول وسائر الضروريات ، وما اقتضت المصلحة كونه من فعل المكلف ، وجب إقداره عليه بإكمال عقله ونصب الأدلة وتخويفه من ترك النظر فيها ، ويكفي ذلك في حسن تكليف ما يجب علمه استدلالا ، وإن لم يكن معلوما في الحال ، ولا مما يعلم في الثاني ، لأن التكليف كاف ، والتقصير مختص بالمكلف .
والحال التي يصح معها تكليف العلم بالمعلوم ، هي كون الحي عاقلا مخوفا من ترك النظر في الأدلة .
والعقل : مجموع علوم من فعله تعالى ، وهي على ضروب :
منها : العلم بالمدركات مع ارتفاع اللبس .
ومنها : العلم بأن المعلوم لا بد أن يكون ثابتا أو منتفيا ، والثابت لا يخلو أن يكون لوجوده أول أو لا أول لوجوده .
ومنها : العلم بوجوب شكر المنعم ورد الوديعة والصدق والإنصاف ، وقبح الظلم والكذب والخطر ، واستحقاق فاعل تلك ومجتنب هذه المدح والذم على فعل هذه واجتناب تلك إذا وقع ذلك عن قصد .
ومنها : العلم بتعلق التأثيرات بالعبدة وفرق ما بين من تعلقت به وتعذرت ومنها : العلم بجهات الخوف والمضار ، وما يستندان إليه من العادات .
وقلنا : إن العقل مجموع هذه العلوم .
لأنها متى تكاملت لحي وصف بأنه عاقل ومتى اختل شئ منها لم يكن كذلك ، ولو كان العقل معنى سواها لجاز تكاملها بحي ولا يكون عاقلا ، بأن لا يفعل فيه ذلك المعنى ، أو يفعل في حي من دونها ، فيكون عاقلا ، والمعلوم خلاف ذلك .
وقلنا : إنها من فعله تعالى لحصولها على وجه الاضطرار في الحي لأنها لو كانت من فعل الحي منا لكانت تابعة لمقصوده .
وقلنا : إن كونه عاقلا شرط في تكليفه الضروري هو من جملتها ، والمكتسب لا يتم من دونها ، لافتقاره إلى النظر الذي يجب أن يتقدمه العلم بمجموعها ، ولأنه لا حكم للنظر من دونه .
ومما يجب كونه عليه التخلية بينه وبين مقدوره ، فإن علم سبحانه حصول منع من فعله تعالى أو فعل المكلف أو غيره قبح تكليفه لتعذر وقوعه ، وإن اختلفت أسباب التعذر .
ولا يحسن منه تعالى تكليفه بشرط زوال المنع ، لأنه عالم بالعواقب ، والاشتراط فيه لا يتقدر ، وإنما يحسن فيمن لا يعلم العواقب ، ولذلك متى علمنا أو ظننا حصول منع من فعل لم يحسن منا تكليفه .
ومما يجب كونه عليه : صحة الفعل ، وتركه ، لأن إلجائه ينقض الغرض المجري بالتكليف إليه من الثواب الموقوف على إيثار المشاق .
والالجاء يكون بشيئين :
أحدها : أن يعلم العاقل أو يظن في فعل أنه متى رامه منع منه لا محالة ، كعلم الضعيف أنه متى رام قتل الملك منع منه هو الملجأ إلى الترك ، وهذا الضرب من الالجاء لا يتغير .
والثاني : يكون بتقوية الدواعي إلى المنافع الكثيرة الخالصة أو الصوارف بالمضار الخالصة ، وهذا يجوز تغييره بأن يقابل الدواعي صوارف يزيد عليها ، والصوارف دواع يزيد عليها ، ولهذا استحال الالجاء على القديم سبحانه ، لاستحالة ما يستند إليه من المنع ورجاء النفع وخوف الضرر .
ومن صفاته : أن يكون مائلا إلى القبيح نافرا من الواجب محتاجا ، لاستحالة تقدير التكليف من دون ذلك ، من حيث كانت المشقة شرطا فيه ، ولا مشقة من دون الميل والنفور ، لأن ما يلتذ به الحي أو لا يلتذ به ولا تألم لا يشق عليه ، فعلا كان أو تركا ، ولأن الوجه في حسنه التعريض للنفع الملتذ به ، ومتى لم يكن الحي على صفة من يلتذ ببعض المدركات ويألم ببعض لم يدعه داع إلى تكلف مشقة لاجتلاب نفع أو دفع مضرة ، وكونه كذلك يقتضي كونه محتاجا إلى نيل النفع ودفع الضر ، فإن فرضنا غناه بالحسن عن القبيح ارتفعت المشقة التي لا يتقدر تكليف من دونها .
وليس من شرط التكليف أن يعلم المكلف أن له مكلفا ، لأن التكليف الضروري ثابت من دون العلم بمكلفه سبحانه ، ولأن المعرفة بالمكلف سبحانه لا وجه لوجوبها إلا تعلقها بالضروري ، فلو وقف حسن التكليف على العلم بالمكلف لتعذر ثبوت شئ من التكاليف .
وليس من شرطه أن يعلم المكلف أنه مكلف ، لأنا قد بينا قبح الاشتراط في تكليفه سبحانه ، وقبحه يوجب القطع على تبقيته المكلف الزمان الذي يصح منه فعل ما كلف على وجه ، فلو كان من شرطه أن يكون عالما بأنه مكلف لوجب أن يكون قاطعا على البقاء إلى أن يؤدي ما كلف أو يخرج وقته ، وذلك يقتضي كونه مغري بالقبح أو عصمته ، والاغراء لا يجوز عليه ، وعصمة كل مكلف معلوم ضرورة خلافه .
ولأنا نعلم من أنفسنا وغيرنا من المكلفين أنه لا أحد منا يقطع على بقائه وقتا واحدا ، بل يجوز اخترامه بعد دخول وقت التكليف وقبل تأديته العبادة وبعد ما دخل فيها ولم يحملها ، وإنما نعلم أنه مكلف ما يحتاج إلى زمان إذا فعله أو خرج وقته إن كان موقتا .
وليس لأحد أن يقول : فعلى هذا لا يلزم أحدا أن يفعل شيئا من الواجبات ، وإن فعلها فلغير وجه الوجوب .
لأنه لا يتعين له على ما ذكرتم إلا بعد الأداء أو خروج الوقت ، لأنه وإن لم يعلم كونه مكلفا ما خوطب به إلا بعد فعله أو خروج وقته ، فإنه يعلم وجوب الابتداء به ، وإذا علم ذلك وجب عليه الدخول فيه والعزم على فعله لوجهه.
ولأنه يجوز البقاء ، ويعلم أنه خرج وقته ولم يؤده استحق الضرر ، فيجب عليه التحرز من الضرر المخوف ويفعله لوجهه ، فكل ما مضى منه جزء علم كونه مكلفا له حتى يمضي جملته أو وقته ، وإن اخترم على بعضه في وقته فتكليفه مختص بما فعله دون ما لم يفعله .
إن قيل : فيلزم على هذا أن يفرد كل حكم واجب من جملة تكليف بقصد مخصوص .
قيل : إذا كان الحكم من جملة تكليف وجب عليه الابتداء به كفاه أن يبتديه بعزم على جملته وتفصيله لوجهه ، لاختصاص تكليفه بذلك ، وإن كان إفراد كل حكم من جملة تكليف بنية تخصه أفضل ، ونية الجملة كافية ، إذ لا فرق في تعلقها بالحكم بين مصاحبته أو تقدمها عليه في حال الابتداء بالعبادة التي هو من جملتها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) الأنعام 6 : 111 .
( 2 ) البقرة 2 : 145 .
المصدر: تقريب المعارف / الشيخ أبو صلاح الحلبي