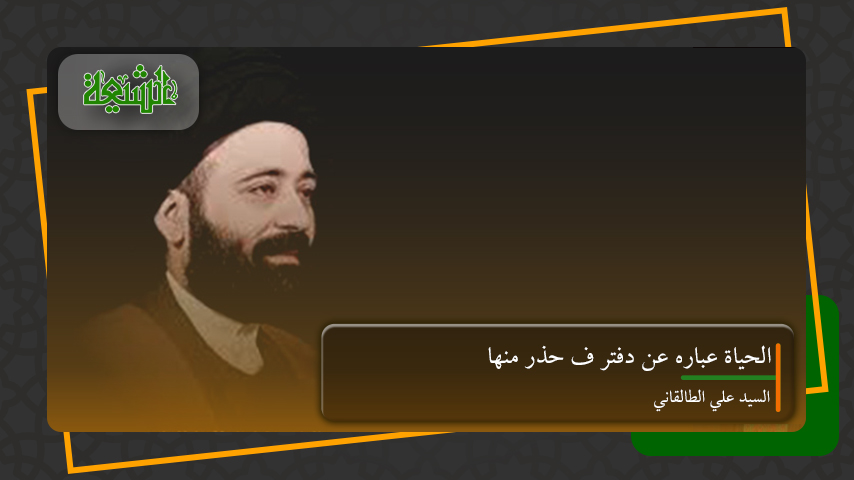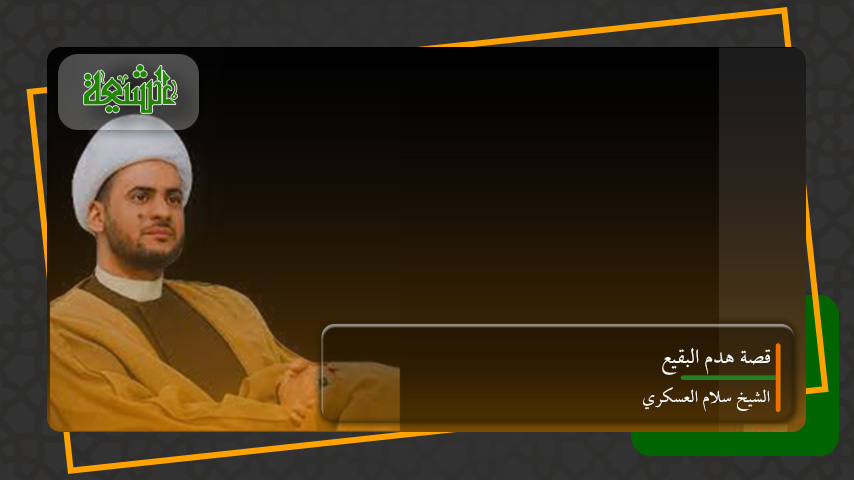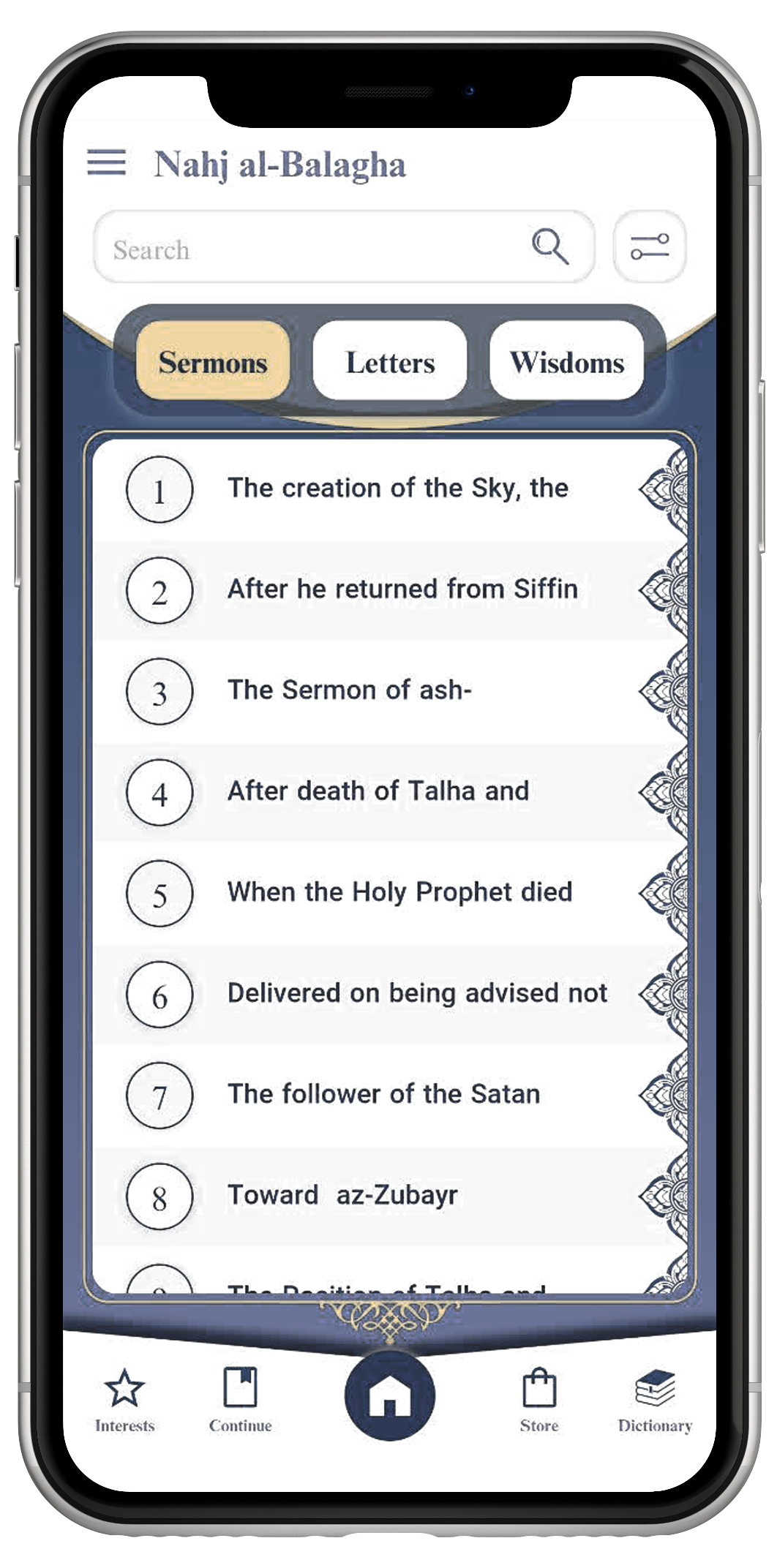الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ) الأعراف:۱۵۷٫
من أهداف إرسال الرسل ـ وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ـ فك القيود التي قيَّد الإنسان نفسه بها وحمل أثقالها فأرهقته، دون أن يكون لها أي مردود إيجابي يُذكر.. فكانت هذه قيود تكبّل حريته وتعيقها في حياته. وكان أمير المؤمنين علي عليه السلام ربيب مدرسة الرسالة المحمدية، فعمل على ترسيخ الحرية في أكثر من بعد.. لم يكن مفهوم الحرية في ذلك الزمان يحمل دلالات كما يحملها اليوم، ولربما الدلالة الأبرز ـ وقيل الوحيدة ـ التي كانت لها هي الحرية في مقابل الرِّقّية وعبودية الإنسان للإنسان.. أما عند علي عليه السلام فقد كانت لهذه المفردة دلالات أعمق جاوز بها الزمن قروناً طويلة في أصل طرحها، وفي إدراك عمقها، دلالات تجلّت في سلمه وحربه.. في حكومته وسياسته وإدارته.. في علاقاته الاجتماعية وفي سلوكياته الفردية.. في تربيته لأبنائه وأصحابه.
قيود العلاقات:
عندما تكون هناك عناوين اجتماعية أو امتدادات تاريخية تفرض على الإنسان أن يتخذ قررات تكون سبباً لإلحاق الضرر بالآخرين ـ ولذا فهي تخالف قناعاته ـ فهذا يكون من التقييد والإصر الذي يضاد الحرية التي آمن بها علي عليه السلام وعمل على ترسيخها. ولذا كان الإمام علي حاسماً في رفض طلبات من ناصروه وبايعوه بعد قتل الخليفة عثمان بن عفان حين استشف منهم أنهم إنما يريدون ثمن تلك النصرة، أو الاستفادة من العنوان الاجتماعي أو صلة القربى التي تربطهم به.. رفض ليكون حراً أمام أي عنوان من هذا القبيل، وفكَّ نفسَه من أي قيد يدفعه لفعل ما يخالف قناعاته ويضر بالآخرين.. وقدّم بذلك لكل الولاة والمسؤولين نموذجاً حياً للحرية في هذا الإطار: (والله لأن أبيت على حَسَك ـ شوك ـ السعدان مسهداً، وأجَر في الأغلال مصفَّداً، أحبّ إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العباد، وغاصباً لشئ من الحطام.
وكيف أظلم أحداً لنفس يسرع إلى البِلى قُفولها، ويطول في الثرى حلولها؟ والله لقد رأيت عقيلاً ـ أخاه ـ وقد أملق حتى استماحني من بُرِّكم صاعاً، ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما سُوِّدت وجوههم بالعِظلِم ـ صبغة سوداء ـ وعاودني مؤكداً وكرّر عليّ القول مردداً، فأصغيت إليه سمعي فظن أني أبيعُه ديني وأتبع قياده مفارقاً طريقي، فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها فضج ضجيج ذي دَنَف ـ مرض ـ من ألمها، وكاد أن يحترق من ميسمها. فقلت له ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانُها للعبه، وتجرّني إلى نار سجّرها جبارها لغضبه؟ أتئن من الأذى ولا أئن من لظى؟ وأعجب من ذلك طارقٌ طرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة، شنئتها ـ كرهتها ـ كأنما عُجنت بريق حية أو قيئها، فقلت أصلة أم زكاة أم صدقة؟ فذلك محرّم علينا أهل البيت. فقال: لا ذا ولا ذاك، ولكنها هدية. فقلت هبلتك الهبول، أعن دين الله أتيتني لتخدعني، أمختبط أنت أم ذو جِنّة أم تهجر؟).
قيود الرغبات:
(مَن ترك الشهوات كان حراً).. بهذه الحكمة حرَّر علي نفسه من شهواته والتعلق بالدنيا، فكان الزاهد الذي لا يرى في الدنيا قيمة إلا بما تمثّله من وسيلة لتحقيق العبودية لله سبحانه، وهي العبودية الوحيدة التي آمن بها علي، وبما تمثّله من مجال لخدمة الإنسان وعمارة الأرض بالخير، ولذا اعتبر أن الدنيا: (مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله. اكتسبوا فيها الرحمة، وربحوا فيها الجنة).. وكان الزاهد الذي لا يرى في المُلك قيمة إلا بما يمثله من موقع لإحقاق الحق وإقامة العدل: (والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت! وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها! ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى؟! نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل وبه نستعين).
وبالغ علي في تحرير نفسه حتى حرمها من مُتعٍ كان يمكنه أن ينالها بما هو مباح له، لأنه كان يرى أن موقعه يفرض عليه أن يواسي الطبقة الأشد فقراً في المجتمع: (ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفّى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخيّر الأطعمة. ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى وأكباد حرى؟ أو أكون كما قال القائل: وحسبك داءً أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحنّ إلى القد أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟).. تحرر علي من كل ذلك ليتفلّت من كل قيد يحول بينه وبين إقامة العدل على الصديق والعدو معاً. ولكنه في ذات الوقت أوصى ولاته بأن يوسّعوا على القضاة كي لا يضطروا إلى الرشوة مما يؤدي إلى ظلم الحق ومسايرة الباطل، وهو يعلم أن الآخرين لن يتحملوا ما يتحمله: (ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، ومن طُعمه بقرصيه. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد، وعفة وسداد).
تقوى الأحرار:
وحتى تقواه وعلاقته بربه بناها على أساس الحرية، فهناك تقوى مصطنعة يقيّد الإنسان بها نفسه مراعاةً لبيئته، أو رغبة في مكسب دنيوي يحققه.. وهناك تقوى نابعة من طمع مشروع في عطاء إلهي أخروي، أو هروبٍ من عقاب إلهي أخروي.. ولكن علياً تحرر من ذلك كله، فكانت تقواه نابعة من قناعته بأنها طريق الخير والحق، وأنها هي التي تحقق إنسانيته، وأنها هي التي فيها رضا الله، فكل عبودية ساقطة عند علي إلا العبودية لله، فهي التي ترفع الإنسان: (وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا) مريم:۵۷٫٫ (وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ) الشرح:۴٫
حرية العمل:
وكانت للحرية في دائرة الحقوق العامة حضورها الواضح في كلمات علي وفي أفعاله، فهو لم يستكره أحداً على مبايعته، بل تركهم على خطئهم، وهو واثق بأنهم على خطأ.. وحتى حين بلغه أن بعضهم يرحل من الحجاز والعراق التحاقاً بمعاوية، فما كان من علي ليصدّهم، ولا حاول استبقاءهم وإغراءهم، فهم في قناعته أحرار يعملون عن مدى تصوّرهم: (اللهم إني دللتهم على طريق الرحمة وحرصتُ على توفيقهم بالتنبيه والتذكرة، ليَثيب ـ يرجع ـ راجع ويتّعظ متذكّر، فلم يُطَعْ لي قول. اللهم إني أعيد عليهم القول).. وكأنه عليه السلام يعيد صياغة الآية بكلماته: (فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ، لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ) الغاشية:۲۱-۲۲٫
وحينما كتب إليه واليه على المدينة سهل بن حنيف يخبره بأن قوماً من أهلها لحقوا بمعاوية قال: (فلا تأسف على ما يفوتك من عددهم ويذهب عنك من مدَدهم، فإنما هم أهل دنيا مقبلون عليها ومسرعون إليها. وقد عرفوا العدل ورأوه وسمعوه ووعوه، وعلموا أن الناس عندنا في الحق أسوة، فهربوا إلى الأَثَرة، فبعداً لهم وسُحقاً، إنهم والله لم ينفروا من جور، ولم يلحقوا بعدل).
حرية القرار:
وحين أخبره الخرّيت بن راشد بأنه لن يأتم به، ولن يشهد معه الصلاة، ولن يأتمر بما يأمر ولن يكون له سلطان عليه فما كان من علي إلا أن أقرّه على ما ارتأى، وخلاّه حراً في ما شاء.. حتى إذا خرج الخرّيت من الكوفة مع جمع من أنصاره لم يستكرههم على البقاء، وبيده ذلك، فلما أساؤوا استغلال هذه الحرية فاعتدوا على الأبرياء ونهبوا وأفسدوا، أرسل إليهم من أنصف منهم للأرض وللناس.
وحتى في الحرب لم يستكره علي عليه السلام أحداً ليكون من أنصاره، لا بقهر مادي ولا بإجبار معنوي، إنما كان يتوجه إلى عقولهم بمنطق العقل والحجة، ويتوجه إلى قلوبهم بمنطق الضمير والدليل، فإن ثابوا إليه أثنى عليهم، وإن تمردوا عاد عليهم بأبلغ الوعظ وأتم النصيحة.. فهو يأبى أن يلحق به أحد عن غير بصيرة وإيمان.. وكتاب نهج البلاغة ملئ بخطب الإمام التي يقيم فيها الحجج على خصومه.. تماماً كما امتلأ القرآن الكريم بآيات الحجج والبراهين، والله غني عن الناس. لقد كانت الحرية بالنسبة إلى علي أصلاً من أصول الإنسانية.. حرية نابعة من العبودية لله سبحانه، فلا يتجاوز فيها طبيعة العلاقة التي تربط العبد بخالقه.. وحرية نابعة من إيمانه بالمسؤولية فلا يرضى لها أن تتحول إلى أداة تسئ لحرية الآخرين أو الإضرار بهم أو الإفساد في الأرض.