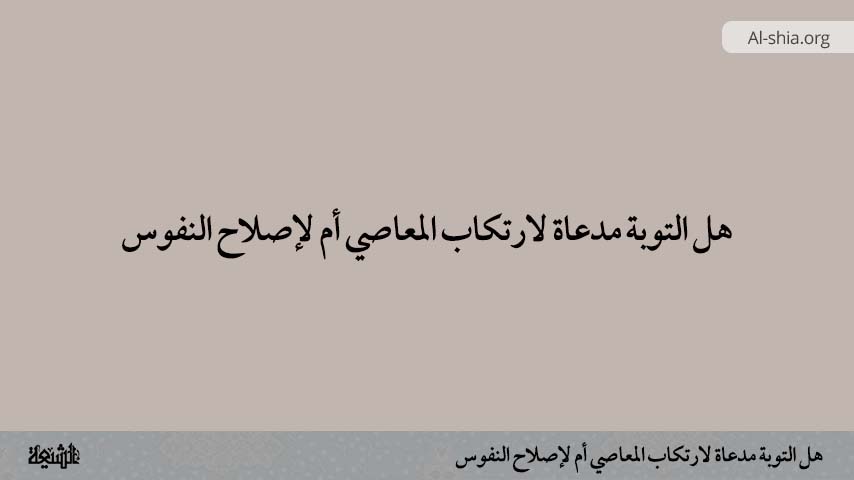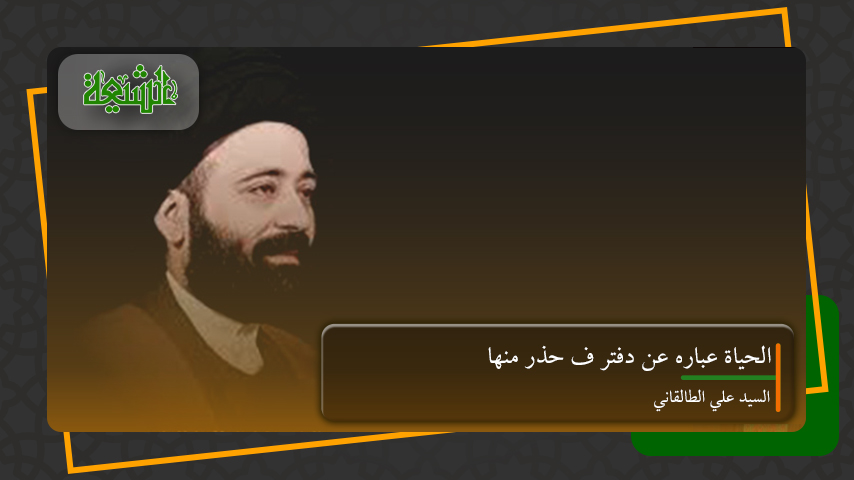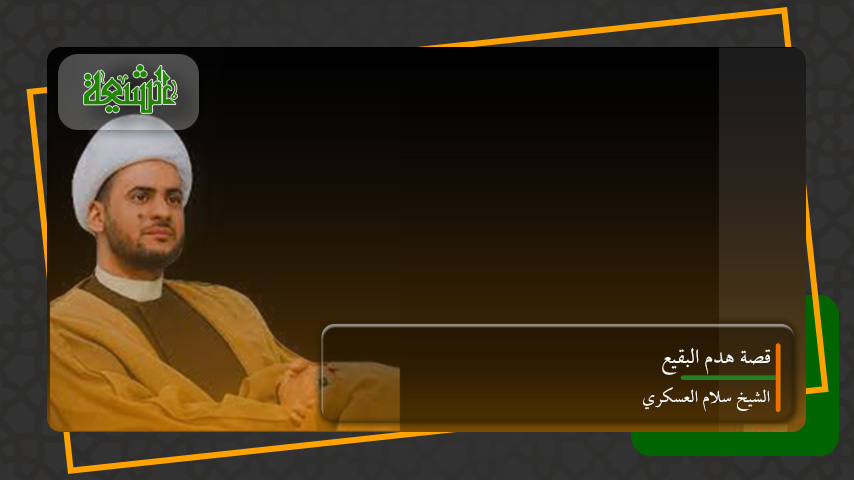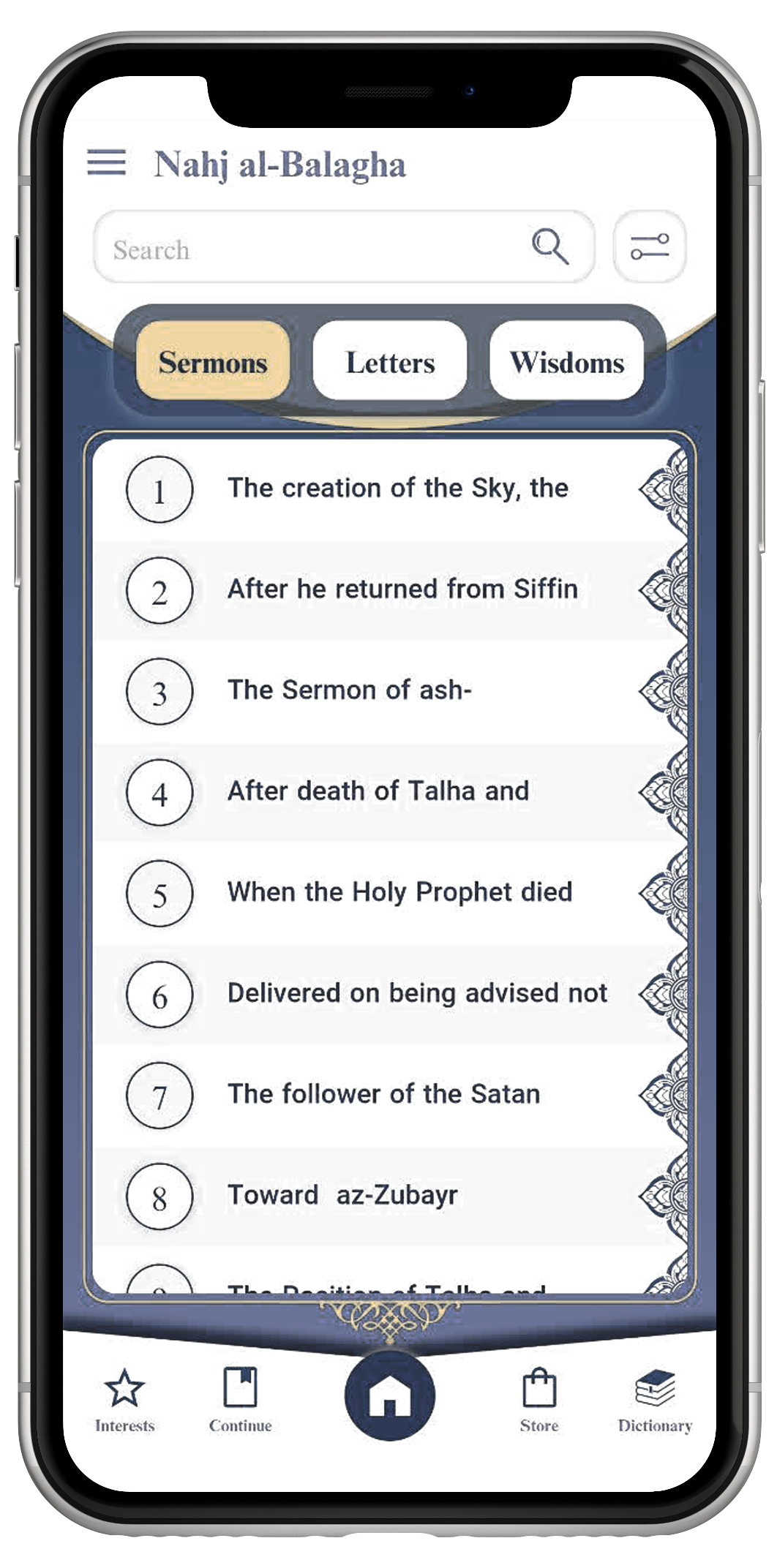قال رجل للنبي (ص): يا رسول الله إني أذنبت، فقال: استغفر الله، فقال: إني أتوب ثم أعود، فقال: كلما أذنبت استغفر الله، فقال إذن تكثر ذنوبي، فقال: عفو الله أكثر، فلا تزال تتوب حتى يكون الشيطان هو المدحور. (ارشاد القلوب للديلمي ج1 ص46).
هذا الصراع بين الانسان وشهواته، هو الذي يحدد مصيره إلى الحسنى والنجاة فيما إذا قرر التوبة والندامة على ما ارتكب من معاصي وآثام، أما اذا ما بقي في شراك النفس الأمارة بالسوء ووقع في مهاوي الشيطان إلى آخر حياته دون أن يتدارك نفسه بالتوبة والاستغفار كان مصيره الهلاك والخسران المبين.
ومن الحديث السابق يتصور بعض الناس أن تشريع التوبة والدعوة إليها إغراءً بارتكاب المعاصي، وتحريضاً على ترك الطاعة، ولكن هذا التوهم باطل، فإنه لو كان باب التوبة موصداً في وجه العصاة، واعتقد المجرم بأن العصيان لمرة واحدة يدخله في عذاب الله، فلا شك في أنه سيتمادى في اقتراف السيئات وارتكاب الذنوب، معتقداً بأنه لو غيّر حاله إلى الأحسن لما كان له تأثير في تغيير مصيره، فلأي وجه يترك لذات المحرمات فيما يأتي من أيام عمره؟ وهذا بخلاف ما لو اعتقد بأن الطريق مفتوح والمنافذ مُشرعة، وأنه لو تاب توبة نصوحاً ينقذ نفسه من عذابه سبحانه، فهذا
الاعتقاد يعطيه الأمل برحمة الله تعالى، ويترك العصيان في مستقبل أيامه، فكم وكم من الشباب عادوا إلى الصلاح بعد الفساد في ظل الاعتقاد بالتوبة، فإنهم لولا ذلك الاعتقاد لأمضوا لياليهم في المعاصي بدل الطاعات، فنرى مثلاً في التشريعات الجنائية الوضعية، قوانين للعفو عن السجناء المحكومين بالسجن المؤبد إذا ظهرت منهم الندامة والتوبة وتغيير السلوك، فتشريع هذا القانون سيكون موجباً لإصلاح السجناء، لا تقوية روح الطغيان فيهم، فالإنسان حيٌّ برجائه، ولو اكتنفه اليأس من عفو الله ورحمته لزاد في طغيانه ما بقي من عمره.
فالتوبة هي الرجوع من الذنب بالقلب واللسان والجوارح، وترك المعاصي في الحال، والعزم على عدم المعاودة في المستقبل، وتدارك ما يمكن تداركه.
والتوبة واجبة على الإنسان فوراً عقلاً وشرعاً، فالعقل يحكم بوجوب الاحتراز عن الذنوب التي تدخل العبد في المهالك، وتضيع عليه ثواب الآخرة، أما شرعاً فقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُون﴾. (الشورى: 25). التوبة هي الرجوع عن الذنب الذي يقع فيه الإنسان جراء تسويفات الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء، بعد أن يدرك أنه بفعل هذا الذنب قد أبعد نفسه عن رضوان الله تعالى، وحتى لا يصاب عباد الله تعالى باليأس، ويلاحقوا بعذاب الضمير إلى يوم القيامة، فتح الله برحمته باب التوبة ليعود من خلاله الإنسان إلى نعيم الرضوان الإلهي، بعد أن أخرج نفسه طوعا منه، وهنا تتجلى الرحمة الإلهية لأهل الدنيا: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم﴾. (الزمر: 53).
كم هذه الآية فيها من اللطف الإلهي حيال عباده، وكم هي تفصح عن رحمة ورأفة الله تعالى بعباده، وكم تفتح من أبواب الأمل أمام العباد المذنبين الذين أسرفوا في ذنوبهم وأثقلت تلك الذنوب كواهلهم، فجاءت الآية بلسما لجراحات ضمائرهم، وملائكة رحمة تخفف عنهم وطأ الذنوب والمعاصي وتفتح أمامهم أبواب الرحمة الإلهية التي تبقى مفتوحة أبدا تنادي بأصحاب الموبقات هل من نادم، وهل من تائب، وهل من راجع إلى فطرته وربه خاليا من تداعيات الذنوب ومخاطر الشرور؟! إنها الرحمة الإلهية قلما تجد لها نظيرا في العالم، بل إنها محصورة بذاته المقدسة، لأنه أرأف بالعباد من الأم بأطفالها، وهو الذي سبقت رحمته غضبه، لا يزال يهتف بالعبد أن مجال التوبة مفتوح لك ما دمت على قيد الحياة، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، وعليه فإنه لا يقنط ولا ييأس من رحمة الله إلا القوم الظالمين.
وقال رسول الله(صلى الله عليه وآله): “التائب حبيب الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له” وأما في وجوب التوبة على الفور فلا شك فيه، لأن ضرر الذنوب يجب دفعه على الفور فلا مجال للتسويف والتأخير، وعن أمير المؤمنين(عليه السلام) في أحد كتبه إلى بعض أصحابه: “فتدارك ما بقي من عمرك، ولا تقل غداً أو بعد غد، فإنما هلك من كان قبلك بإقامتهم على الأماني والتسويف، حتى أتاهم أمر الله بغتة وهم غافلون”.
وطالما أن سيوف الأجل مشرعة على الرقاب ولا مناص ولا خلاص منها طال الأمد أم قصر، ليجعل كل واحد منا شعار “لا للتسويف نعم للتوبة المبكرة” نصب عينيه، وليعمل جاهدا لتدارك الأمر وتصليح ما خرب من بنيان قبل فوات الأوان، حقا أن من يؤخر التوبة فإنه مغرور لا محالة، وهذا الغرور سيرميه في متاهات الحيرة والضياع، فأنه وكما جاء في الحديث الشريف” اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب” لعل الفرصة التي تمر عليك اليوم لا تمر عليك غدا، فالعاقل الحصيف هو من يستغل فرص الخير بأكمل وجه ويسخرها في خدمته وخدمة الانسانية، ليقطف الجميع منها منابت النعمة والبركة الوارفة الظلال والموفورة الحال والذليلة المنال، نعم أن طول التسويف هو من ايحاءات الشيطان الذي يلقي في اوساط أقرانه هذه الخصلة المدمرة معتبرا اياها نزهة ولكنها غصة وحيرة، توقع صاحبها في المهالك ولا طريق وقتئذ للرجوع إلى جادة الصواب وهو الهلاك بعينه، أما الذي يتدارك الأمر ويقف عند ذنبه موقفا صارما بمجرد صدوره منه، فأنه قد لبى نداء ربه في الإنابة والرجوع إليه كلما وقع في وعثاء طريق أو طمس في رمضاء سفر، ويكون حينئذ كمن ولدته أمه لا ذنب يثقل كاهله ولا تبعات تنغص عليه ولا هم يحزنون، بل هم التائبون المنعمون بنعمة ربهم وهم الوافدون على الجليل بدون زاد إلا من خصال رحمته وجليل كرمه وعفوه وصفحه عن المذنبين التائبين الأوابين.
لقد دعانا الله إلى التوبة جميعا من ذنوبنا، ووعدنا بأن يقبل توبتنا ـ مع تحقق شروطها ـ ووعدُ الله حق ولا يخلف الله ما وعد به عباده حيث قال: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾. (النور: 31 ) وكذلك حثنا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عليها كما روي عنه: “توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في كل يوم مئة مرة” (ميزان الحكمة، الحديث 2131) وهذا تعليم من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لنا أن نكون في حالة التوبة إلى الله دائما وحتى لو لم نرتكب الذنوب، فإن الإنسان مهما علا شأنه يظلّ مقصرا
أمام ربّه عن أداء شكر النعم التي أنعم بها عليه، فليستغفرِ الله عن التقصير في أداء شكرها راجيا منه العون والتوفيق.
فرق بين من يعمل السوء بجهالة وبين من يعمل السوء بترصد وسبق اصرار، كما هو الفرق بين قتل الخطأ وقتل العمد، إذ أن الأول يمكن تداركه بالدية والاسترضاء والثاني لا يمكن تداركه إلا بالقصاص والانتقام من الجاني للإصلاح والقضاء على بؤر الفساد في المجتمع لا للتشفي والانتقام، لذلك عبر القرآن الكريم بالقصاص أنه الحياة بعينها ولولاه لما استقام نظام ولا عرف للقسط والعدل والحق طعم ولا مذاق، وهكذا فإن الشهوات والنفس الأمارة بالسوء ووساوس الشيطان ربما تجر الإنسان إلى الخطيئة والذنب والهفوات، ولكنه سرعانما يتدارك نفسه وتتغلب جنبة التقوى فيه على جنبة الفجور، فيرجح ومن خلال التوبة كفة التقوى والايمان نادما على ما بدر منه من خطايا وذنوب سواء كانت بينه وبين ربه أو انتهاكات بينه وبين العباد، فيقرر مادام هو في الدنيا من تصفية حساباته مع ربه بالعبادة والاستغفار ومع الناس بإيفائهم حقوقهم المادية والمعنوية، فمن حكمة الله تعالى وجزيل كرمه ولطفه بالعباد أنه يتقبل التوبة من هكذا تائب نادم راجع إلى ربه من قريب، وهذا بخلاف من أمضى حياته بالهتك والمعاصي والتطاول على حقوق الآخرين والتمادي على الحرمات والتراخي إزاء العبادات والمعتقدات، فإنه وبأعماله المشينة تلك لا يؤمن بوجود الله تعالى وحتى إذا كان مؤمنا فإن إيمانه لا يعدو لقلقة لسان ليس إلا، إذ أن مظهره المتهتك يدل على مخبره المتمرد، ولو كان لديه شيء من الإيمان لبان إلى الوجود، والحال أنه خال الوفاض من مقومات الهداية والتوبة والانكسار، ومثل هكذا انسان الذي جرد نفسه من القيم والأخلاق كيف يرجو النجاة بأمور هو لا يعتقد بها أصلا إلا بعد أن تداهمه المنية؟! وهذا اعتقاد مصلحة وليس اعتقاد ضمير، وهو مرفوض من سائر الناس فضلا عن الخالق المتعال الذي هو أقرب للنوايا وما تبطن النفوس من حبل الوريد بالنسبة إلى الإنسان؟!.
والتوبة الحقيقية لا تقع من العبد عن الذنب بمجرد الاستغفار ولقلقة اللسان، وإلا فكل الناس تلجأ إلى المعاصي ليل نهار ثم تقول عقب كل ذنب أستغفر الله وأتوب إليه وتنتهي المسألة، وحينئذ تنعدم الفائدة من التشريع، ويصبح الإسلام نموذجاً فاشلاً عن تحقيق السعادة للإنسان، بل لا بد لقبول التوبة من شروط قد اختصرها الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حينما سمع رجلا يقول أستغفر الله فقال له: “ثكلتك أمك أو هكذا الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة العليين وهو اسم واقع على ستة معان:
أولها: الندم على ما مضى.
والثاني: العزم على ترك العود إليه أبداً.
والثالث: أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله سبحانه أملس ليس عليك تبعة.
الرابع: أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها.
الخامس: أن تعمد إلى اللحم الذي تنبّت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى يلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد.
السادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية”. (الكافي، ج2، ص431).
المعاني الستة المذكورة آنفا تنبأ عن أن المذنب قد ندم فعلا عما اقترفه من منكرات ومعاصي حيال الله تعالى والنفس والعباد والبلاد، وكما هو واضح أن الإنسان يأتي في هذه الدنيا وصحيفته بيضاء ناصعة تتلألأ بالعقل الباطني وما يحمله من فكر وتعقل وحكمة وهي واقعة تحت فيوضات ومصابيح الدجى من أنوار الهداية في العقل الظاهري المتمثلة بالكتاب العزيز والرسول الأعظم والعترة الطاهرة، بيد أن الكثير منا يلوث هذه الصحيفة بقاذورات الذنوب حتى يصيرها شيئا فشيئا سوداء كالحة، ولكي ترجع إلى بارئها لابد من غسلها وتطهيرها حتى تتسامى إلى سطوعها الأول، وهذه المعاني الست بمثابة الحمام الذي يجلي قلوب البشر الصائغة ويجعلها بأداء حقوق الله تعالى وحقوق الناس وحقوق النفس سائغة لامعة.
أليس الأجدر بالإنسان الحر الغيور أن يصفي حساباته بينه وبين نفسه وبينه وبين ربه وبينه وبين العباد في هذه الدنيا قبل أن تخرج روحه من جسده؟! أليس الأجدر بالإنسان العاقل الحكيم أن يجعل من الدنيا قنطرة للآخرة يعبر من خلالها بكل أمان وسلام واطمئنان؟! أليس الأجدى بالإنسان الناجح أن يأخذ من الدنيا بمقدار ما يعيش فيها ويأخذ من الآخرة بمقدار ما سيعيش فيها، وأن لا تلهيه الدنيا الفانية عن الآخرة الباقية؟! أليس الأفضل والأنجع أن يرتقي الإنسان سلم المجد في الدنيا إلى جنة عرضها السماوات والارض أعدت للمتقين؟! هذه الأسئلة وغيرها تبحث عن إجابة دقيقة ولا يمكن العثور عليها إلا في دهاليز التوبة والرجوع إلى الخالق الحنان المنان، الذي بحنانه يحتضن التائبون وبمنه وفضله وكرمه يستقبل الهائمون، ومن يستقبل المذنبون غيره تعالى؟! ومن للعاصين غير رحمته ورأفته وفضله وكرمه؟! قد يقول قائل إن هذه الشروط الستة التي ذكرها أمير المؤمنين عليه السلام ثقيلة على الانسان لا يقدر على أدائها؟! والحال أنها تتقاطع مع ميوله وشهواته وربما تطلعاته الدنيوية المتشعبة المنال والنوال! وطالما توعز له النفس الأمارة بالسوء بالتسويف وتزرع في مخيلته آمال وآمال.
ولكن الإرادة الصلبة التي بين جنبيه يمكن لها أن تقطع دابر التسويفات والأخذ بمبادرة العمل الجاد قبل فوات الأوان، وهذا القرار لا يمكن لأي أحد أن يأخذه إلا من امتحن الله قلبه بالإيمان فوجده عند الشدائد صابرا وعند المحن والبلاءات محتسبا وعند الملمات حاضرا، وقليل هم أولئك النفر من الناس الذين يكون عندهم تلك الجرأة والصراحة بالاعتراف بالذنب واستيفاء الحقوق المادية والمعنوية التي في ذمته حيال الله تعالى وسائر الناس، وهذه الوقفة مهما تكتنفها من صعوبات بيد أنها أهون عليه من أهوال وتبعات الذنوب في الآخرة، وطالما غفل معظم الناس عن هذه الحقيقة أن الدنيا وما يلفها من صعوبات ومتاعب لا شيء أمام أهوال يوم القيامة! وهذا ما أشار إليه الإمام الكاظم عليه السلام عندما وقف على قبر وقال: “إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن شيئا هذا أوله لحقيق أن يخاف من آخره”. (معاني الأخبار للشيخ الصدوق ص343).
والتوبة الرجوع الى الدوحة المباركة دوحة الطهارة والبركة والرحمة والمغفرة والرضوان الإلهي، يا لها من دوحة خضرة نضرة باصرة ناضرة، تصرخ فينا هل من مدلف إلى روابيها العطرة ومروجها العابقة ودهاليزها المزهوة أريجا وعطرا ونسيما عليلا، تسكن إليه النفس المثخنة بالجراح، جراح الماضي الأسيف الذي لف الإنسان على حين غفلة من أمره، ولكنها الرحمة الإلهية هي دوما بانتظار النادم المسكين الذي يجد فيها للأمل معنى خاصا وللإنابة طعما فريدا يرفل فيها مسرورا جذلا، تغمره رحمة لا يزال يتفيأ بنسائمها ويتضوع بأريجها ما دام هو في فلكها يسبح وفي أمصارها يدور وفي أرجائها يتجدد ويتمدد ويسود.
كيف لا وهو قد شد الرحال إلى بارئه ومصوره وخالقه، شد الرحال إلى من هو ألطف به من نفسه عليه، إنها فعلا رحلة جديرة بالاقتفاء، لأنها رحلة العمر البهية تمر مر السحاب، فعلى العاقل اقتناصها وإلا فإن الندم سيلفه لفا ولا يستطيع الخروج من شراكها، ووقتئذ لا ينفع معها ندم نادم ولا نصيحة ناصح ولا شماتة شامت، وبعد أن يحقق الإنسان التوبة بشروطها الآنفة الذكر، فإن الله تعالى سيقبلها منه وتترتب على ذلك الآثار التالية:
1- تطهير القلب.
2- نزول الرحمة الإلهية.
3- ستر الله على التائب.
4- تبديل السيئات حسنات.
5- محبة الله.
6ـ غفران الذنوب.
7ـ نزول الرحمة على التائب.
8ـ طهارة القلب.
مرة قال طبيب لمريض كلمة رائعة, قال له: معك مشكلة في القلب، إن تلافيتها فهي صغيرة، وإن أهملتها فهي كبيرة، كلام جميل، والذنب أحياناً: إن أردت أن تتوب منه, فالقضية سهلة جداً، وإن أهملته, فهذا الذنب قد ينقلب إلى عادة، ومن أصعب الأشياء: أن يتخلى الإنسان عن عاداته، أنت تتدرج فتبدأ بخاطرة، بفكرة، بهمٍّ، بإرادة، بفعل، بعادة، هذا الذي قاله الله عز وجل: ﴿فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾. (الحديد: 16).
من هنا: أدق معنى نحتاجه في هذا الدرس قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾. (النساء: 17). لا تجعل مسافة طويلة بين ارتكاب الذنب -لا سمح الله- وبين التوبة منه، هذه المسافة الطويلة تجعلك تألف الذنب، وهذه المسافة الطويلة تجعلك تظن أنه ليس بذنب، لأنك ألفته.
تراكم الذنوب يؤدي لا محالة إلى قسوة القلوب وهو بدوره يجر إلى ساحات الظلم والبغي والعدوان والفسق والفجور والعصيان، وهذا هو حال الظلمة والطواغيت والجبابرة، فإنهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الظلم والبغي والتعدي إنما بارتكاب الذنب واستسهاله والتطبع عليه وزادهم في ذلك خوف الناس عادة من الوقوف أمام الظالمين لتبيين مثالبهم وتزييف شرورهم وتعرية ما يقومون به من باطل، ولهذا السبب جاء في الحديث الشريف عن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله): “أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر” فالجهاد على أنواع منه: مقاتلة الأعداء في ساحات الوغى، طلب العلم والمعرفة، الكد على الأهل والعيال، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإتقان في العمل والاخلاص فيه، وكل ما يبذل فيه جهد وتعب ونصب في سبيل الحق والعدل، فهو جهاد في سبيل الله.
ولكن حسبما جاء في الحديث الشريف أعظم الجهاد هو قول كلمة كلا أمام الحاكم الظالم، كلا للظلم والاستبداد، كلا للقهر والكبت وسلب الحريات، كلا لنهب ثروات البلاد، كلا لانتشار الفسق والفجور والموبقات، كلا لمحاربة الدين وأهل الدين، لماذا هذه المواقف تعدو من أعظم أنواع الجهاد، لأنها تعرّض صاحبها إلى المخاطر وربما تودي به إلى السجن والتعذيب والموت صابرا محتسبا إلى الله تعالى من ظلم الظالمين وجور الفاسقين، وإنما حصل هذا المؤمن المعارض للظالم على هذا الوسام العظيم، لأنه لا يخاف في الله لومة لائم، ولا يخشى من أجهزة النظام القمعية، ولا يهاب من بطش وترهيب، ولا يطمع في إطراء وترغيب، بل إنه قد وضع الله تعالى نصب عينيه وتوكل عليه، وهو كله ثقة بأنه لو كبر الخالق في عينه لصغر ما دونه أمامه، فإيمانه يجره إلى تلك المواقف النبيلة والشجاعة، فيقوم بواجبه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير قيام.
وإذا ما حذي الآخرين حذوه من خطباء وعلماء وصحافة وفضائيات وانترنيت وصحف ومجلات لألّبوا الرأي العام ضد الطغاة، ما يؤدي إلى ردعهم عن ارتكاب الذنوب والمعاصي والشرور والانتهاكات، وهي رسالة إلى الحكام بأنهم إذا ما حادوا عن طريق الهدى والصواب كان المؤمنون لهم بالمرصاد، فيحجموا عن الظلم والعدوان خوفا من تأليب الرأي العام ضدهم، ومن هنا جاء أهمية ما يقوم به المؤمن المجاهد من الوقوف بوجه الظالم وردعه عن الظلم، وقد يكون سببا في توبته وإنابته وهدايته إلى الله تعالى، إذا ما قورن بالمؤمن المنكفئ على نفسه وهو يتعبد في صومعته، فإنه قد يكون سببا في تمادي الطغاة بطغيانهم وما يجره على الشعوب من محن وويلات ومظالم ومآثم، إذن فالجهاد بوجه الطغاة تبعاته حلوة وإن كانت مقدماته قاسية، والتقاعس حيالهم تبعاته مرة وإن كانت مقدماته مريحة، وشتان ما بين الموقفين؟!.
إن الله تعالى يمتحن كل عبد من عباده حينما تهجم عليه الذنوب والشهوات والرغبات، ولكن تبقى في داخل الانسان طاقات أقوى وأعظم من طاقات الشمس والذرة أو أية قوة كونية أخرى، يعني الانسان قادر على أن يقف بالضد من شهواته ونزواته وشيطانه إذا ما عزم وصمم على ذلك وباستطاعته أن ينتصر عليها في نهاية المطاف.
والحقيقة التي لا مناص منها إن إبليس ليس له سلطان قهري على الانسان، وعمله يكمن فقط في تزيين الذنوب والمعاصي، والانسان عنده طاقة الارادة، وإذا ما اراد فعل شيء فالبشرية اذا اجتمعت كلها ليست بقادرة على أن تثنيه عن ذلك العمل، وهذا الكلام يجري في الطاعة والمعصية على حد سواء.
بابان مفتوحان، باب الحق وباب الباطل، ومهما كانت المغريات فإن المعصية غير قادرة على أن تهزم ارادة الانسان المصمم على فعل الخير، كما الانسان يقف ازاء شهوات الاكل والشرب والجنس في نهار رمضان بمحض ارادته، استجابة لأمر الله تعالى، فإنه قادر أيضا على أن يكبح جماح وشرور نفسه في بقية أيام السنة، لماذا الامتناع عن المباحات في نهار رمضان؟ لأن الانسان قرر ذلك، ونحن دائما عندنا مشكلة في القرار، فإذا قرر الانسان، لا ابليس ولا الشهوات قادرة على أن تفرض عليه خلاف ما قرر، وأما ابليس فإنه يغوي الانسان المتردد في اتخاذ القرار، أعمل العمل الفلاني أم لا؟ أما اذا كان حازما منذ البداية على عدم الارتكاب، فإنه يوصد الباب أمام ابليس وغيره، لأن القوة التي اودعها الله تعالى داخل الانسان باستطاعتها التغلب على كل المؤثرات الخارجية، وفي الحديث الشريف: “المؤمن أقوى من الجبل، لأن الجبل يستقل منه والمؤمن لا يستقل من ايمانه شيء” فالتوبة هي نفسها تلك الارادة الصلدة والصلبة التي تخرج من اعماق الغافل الذي وقع في حبائل الشيطان في حين غفلة من أمره، وتقول بمليء فيها كلا للسفاسف نعم للكمالات.
وفي هذا المضمار يقول الفاضل النراقي في معراج السعادة: إن امرأة غير ملتزمة تمر مع مجموعة من امائها من بيت في زقاق يعلو منه بكاء ونحيب، تتعجب من هذا الأمر، فترسل واحدة من امائها لتحري الخبر ولكنها تبقى في ذلك البيت، وبعد استبطائها ترسل أمة ثانية لتقفي الخبر فإنها فعلت ما فعلت الأولى، وعندما ارسلت الثالثة أوصتها بالرجوع بسرعة واخبارها عما يحدث في البيت، الثالثة تذهب وتأتي اليها قائلة: سيدتي هذا المكان ليس مأتما للأموات وإنما مأتما لذوي الصحائف السود! ما حدى بتلك المرأة الدخول في البيت بنفسها واذا بها ترى الخطيب وهو على المنبر يقرأ قوله تعالى: (إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا). (الفرقان/12) تتأثر من كلمات الخطيب وعندما ينزل من على المنبر تلتفت اليه قائلة: انني واحدة من أصحاب الصحائف السود فهل لي من توبة؟! قال لها الشيخ نعم يتوب الله عليك وإن كانت ذنوبك مثل ذنوب “شعوانه”! وهي معروفة في ذلك البلد بارتكابها جميع أنواع المعاصي والفجور، فتقول له يا شيخ أنا “شعوانة”! هل لي من توبة؟! يقول لها الشيخ نعم إذا تبت وعملت بشرائط التوبة يتوب الله تعالى عليك، فتقرر التوبة على يد الشيخ، يقول الشيخ النراقي: إنها تحولت من امرأة فاسقة إلى ولية من أولياء الله.