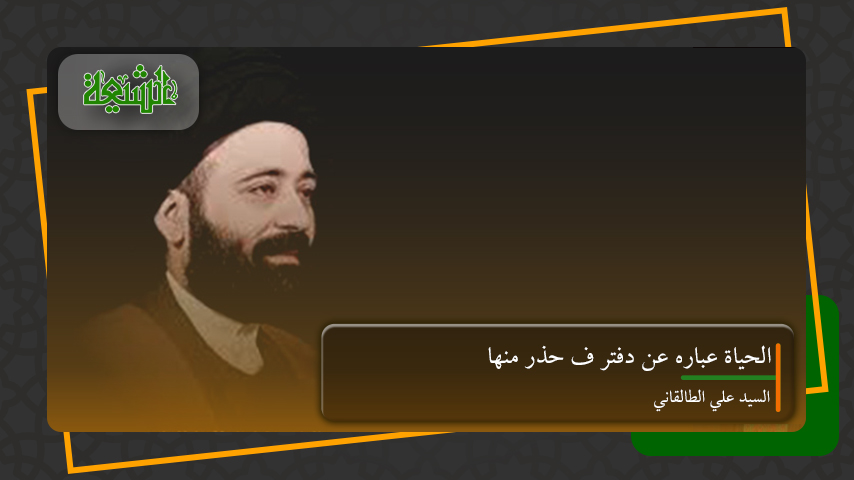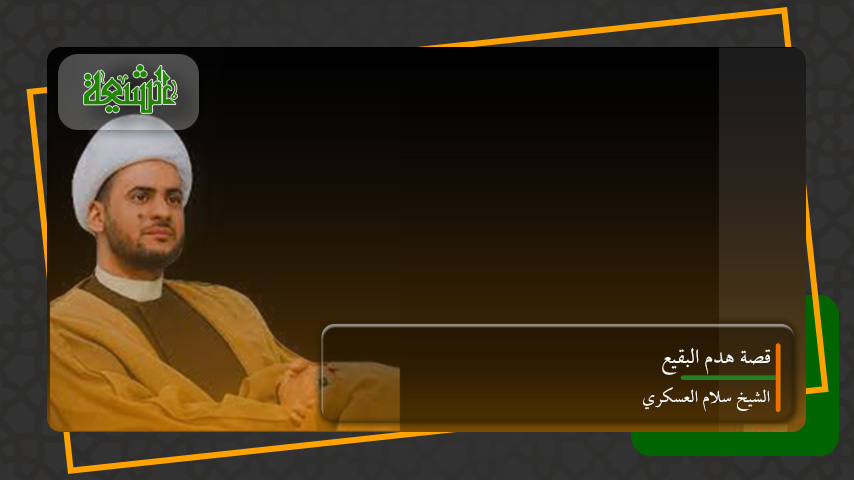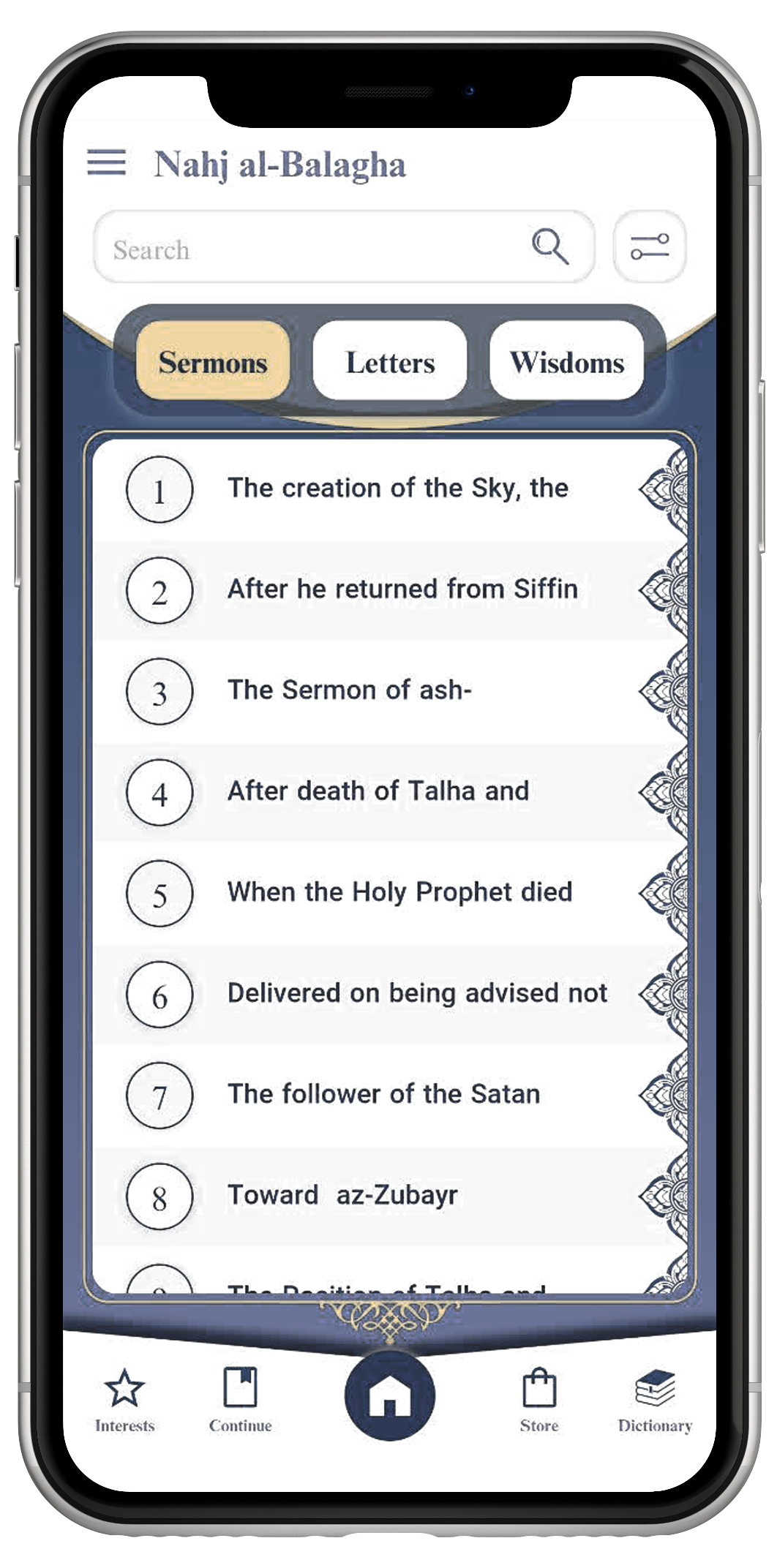ما هي الرؤية القرآنية المتعلقة بالحرب وأبعادها وزواياها المختلفة؟ وما هي المواضيع والمسائل المبنائية أو الأساسية التي لها دور رئيسي في فهم مسائل الحرب الأخرى وقضاياها؟ ولماذا توجد الحرب وينشب القتال؟ بحوث نتطرق إليها في هذا المقال.
1ـ البيان الفلسفي لاندلاع الحرب
لماذا تقع الحرب في العالم أساساً؟ لماذا خلق الله تعالى البشر على نحو يبادر إلى الحرب وسفك الدماء؟ ولماذا أصبح كل هذا القتل والفساد والدمار والخسائر التي تحيق بالإنسان وتلحق به؟ هل وقوع كل هذا الدمار وإراقة هذه الدماء الغزيرة بسبب تلك الحروب أمر مقصود في نظام الخلقة، ومطلوب ضمن الإرادة التكوينية لخالق العالم؟
الله تعالى هو الذي يرغب في أن يقتل الإنسان أخاه الإنسان؟ أم أنه غير راض عما يحصل، وأن المخلوقات هي التي يقتل بعضها بعضاً، وهي كائنات تعيش التمرد والخصام، وتثير الصراع والحرب؟
ماذا سيقول الإسلام عن هذه المسألة المعقدة؟
وفي ضوء تعاليمه كيف يرى الهدف الذي كان وراء خلق الإنسان وابتداعه؟ ولم خلق الله الإنسان مجرماً شريراً سفاكاً للدماء يسعى وراء الحرب والاقتتال؟
وكيف تكون كل المفاسد الإنسانية، وإراقة الدماء، وإثارة الحروب والصراعات من وجهة نظر الإسلام ضمن النظام الأحسن، والخلق الأصلح؟
حل هذا الموضوع إذاً، وفك عقدته مهم ورئيسي جداً للوصول إلى الأبعاد القانونية والحقوقية والقيمية للحرب والخوض فيها.
يقول الله تعالى في الإنسان الذي يهوى الحرب والمخلوق المتعطش لسفك الدماء: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ[1].
يتضح من خلال هذه الآية أن الملائكة حتى قبل خلق الإنسان كانوا يعلمون هويته وحقيقته وأنه سيقتل وسيسفك الدماء من هنا طرحوا سؤالاً مؤدباً معترضين فيه على جعل خليفة من هذا النوع، فقد سألوا الله تعالى: لماذا تجعل الإنسان المخلوق السفاك والمخرب خليفتك في الأرض رغم أننا بمنزلتنا هذه أرفع وأسمى منه؟
فأجابهم الله تعالى جواباً مجملاً: قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وهذه الجواب على إجماله فيه إشارة إلى هذه الحقيقة، وهي أن من بين هؤلاء البشر الذين عدهم الملائكة ظالمين عاصين من ستكون منزلته ومقامه أسمى وأرفع من الملائكة وهو أحق بالخلافة منهم في الأرض.
وعند النظر إلى هذه الآية يمكن القول ومن دون شك: إن القرآن الكريم يرى أن القتال وسفك الدماء إحدى اللوازم البينة لوجود الإنسان الأرضي، وهو أمر ضروري لا ينفك عن حياته الاجتماعية، وأن الله تعالى وملائكته كانوا يعلمون قبل خلق هذا الكائن المعقد بهذه الخصوصية الذاتية اللازمة له، وعليه لا يمكن القول إطلاقاً: إن الله تعالى لا يدرك حقيقة هذا المخلوق، ولا يجوز التفوه بأنه لا يعلم ظاهرة الحرب المغروسة فيه وسفكه للدماء، ولا يصح الحديث أساساً عن أنه لا يدري بأن هذا الأمر سيتفق وقوعه في حياته ومسيرته الاجتماعية، وبعد خلقته أدرك حقيقة الموقف فندم على تكوينه وإبداعه!
اتضح الآن أن الله سبحانه وتعالى والملائكة كانوا يعلمون بصفة الإفساد وإراقة الدم و خصوصيتهما لدى الإنسان، وهنا يطرح سؤال فلسفي مهم وهو: لماذا خلق الله تعالى الإنسان بهذه الصفات الذميمة، فجعله يحمل كل هذا الشر والدمار؟
وعلى صعيد أوسع وأعم لماذا خلق الله تبارك وتعالى العالم ليكون مسرحاً لكل هذا الفساد والفقر والسلب والنهب؟ ولماذا جعل كل هذه الكوارث تحيط بالإنسان؟ وما هي الغاية والقصد من جعل هذا الكون يشهد كل هذه الحوادث الطبيعية المرة والمؤلمة كالزلازل، والسيل، والقحط، والمرض؟
وقد أجاب الفلاسفة والمتكلمون عن هذه التساؤل كل بحسب منهجه ورؤيته، وينبغي البحث والتقصي عن الإجابة المفصلة بخصوص هذا الموضوع في مظانها.
وما يمكن ذكره هنا إجمالاً هو: أن وجود شرور كهذه، و مفاسد بشرية وطبيعية إنما هي في الواقع من لوازم وجود عالم الطبيعة وعالم الإمكان وضرورياتهما وتزاحم العالم المادي، وعلى أساس الحكمة الربانية خلق الله سبحانه عالم الطبيعة مرافقاً لمثل هذه الشرور والمفاسد شئنا أم أبينا، مثل مسائل الحرب والفقر والمرض والسيل والزلازل والطوفان ونحوها.
ولا يمكن وجود عالم الطبيعة والخلق المادي هذا من دون هذه الشرور والمفاسد، لذا إن ترك فطر هذا العالم وخلقه من قبله تعالى وهو صاحب الفيض المطلق لا ينسجم مع إرادته تعالى، فخلق الطبيعة على هذا النحو وهو يعلم عندما أراد ذلك – أنها ستحتوي على جملة من الشرور والمفاسد طوعاً أو كرهاً، والتصاق هذه الكوارث والشرور ومرافقتها لهذا العالم لا يمنع من تعلق الإرادة الإلهية الحكيمة بخلقته وإبداعه.
ذلك لأن – ورغم وجود هذه الشرور والمفاسد – هناك خيراً وجمالاً وحسناً يحتويه هذا العالم هو أكثر وأوسع بالتأكيد من تلك الشرور والمفاسد، هذا هو الجواب الإجمالي، وبالنتيجة يمكن تبرير الحرب وسفك الدماء والقتل زاد أو نقص، وعليه يمكن أن يتفق وقوع مثل ذلك في المجتمع الإنساني.
2ـ مسائل الحرب والإرادة التكوينية للباري تعالى
أن الآيات القرآنية تدل بوضوح على أن وقوع الحرب أمر معلوم، وبينه الله تعالى في نظام الخلق الرباني، ولم يكن خارجاً عن علمه وإرادته وتدبيره، ومن جملة الآيات التي يمكن أن تكون دليلاً على ذلك هي قول الله سبحانه وتعالى:
تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ البَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ القُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ البَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ[2].
وهذه الآية فيها دلالة على أن الله تعالى لو أراد فإنه يمكنه أن يخلق الإنسان ويجعل تفاصيل حياته بعيدة عن كل مسائل الحرب والقتال وسفك الدماء، ولكنه لم يرد أن يكون الإنسان مجبوراً على ترك القتال، ويكون مرغماً على أن يسود حياته الهدوء والراحة فقط.
إن الله تعالى لا يريد أن يسلك بنو آدم طريق الخير على سبيل الجبر والإكراه، فلو أراد ذلك سيكون الأمر كما قال الله سبحانه: لَّوْ يَشَاء اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا [3]، ولأصبحت الحياة الاجتماعية كما ذكر في آخر الآية التي نحن بصدد البحث فيها الآن أيضاً، وهي التي تتحدث عن القتال، إذ قال الله تعالى: وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُواْ [4].
هذه الآيات الكريمة تدل بوضوح على أن الله سبحانه خلق الإنسان أولاً وبالخصوص حراً كامل الإرادة، ولم يصده ويمنعه عن مسائل الحرب والصراع والإرهاب بنحو جبري وقهري، وسينجز أعماله أحياناً في ضوء الميول والرغبات المودعة فيه مع شيء من التضاد والتناقض والصدام.
بعبارة أوضح: إن الله تعالى خلق الإنسان حتى يكون خليفته في الأرض، وحيث إن خلافته سبحانه هي منزلة ومقام غاية في الرفعة والسمو، يلزم الوصول إليه وبلوغه كفاءة وجدارة عاليتين، ومقومات كثيرة يجب أن تتوافر في المرء بسعيه ونشاطه الحر وفعله الإرادي، ولكي يحصل الإنسان على هذه الفضائل والكمالات يجب أن يخلق مختاراً، مريداً، قاصداً لما يفعل، فلو لم تكن في أعماقه مجموعة من الميول والرغبات المتناقضة والمختلفة وبواعث متغايرة، وخلا باطنه من الميل والرغبة بالمعصية وفعل الشر، كان ما يفعله من أعمال حسنة وسلوك ممدوح دون قيمة أو فخر.
وعليه يكون الوصول إلى مرتبة الكمال الإنساني القصوى غير مقدور، فعلى الرغم من عدم ارتكاب الملائكة للمعصية ولم يخطر بخلدهم التفكير بالخطيئة والذنب حتى لم يكونوا جديرين إطلاقاً بمقام الخلافة ومنزلتها؛ ذلك لعلة واحدة فقط وهي أنهم لا يتمتعون بصفة الاختيار والإرادة والحرية.
من هنا إن منزلة أولياء الله ومقامهم أسمى وأعلى من درجة الملائكة ومقامهم، ولا تقاس طاعتهم وعبادتهم بأعمال الصلحاء الإلهيين وعبادتهم، فإن الرجال الذين صدقوا مع الله مختارون بخلاف الملائكة، ورغم وجود الباعث للمعصية والحافز للذنب لديهم لم يرتكبوا أي شيء منها، والتزموا بكل الأحكام الربانية ونفذوها.
ولو نال الإنسان مقام الخلافة الإلهية ودرجتهم سيكف نفسه عن المعصية، ويطهر جوارحه من الذنوب، ولا يقدم إلا على ما يرضي الله سبحانه من الأفعال، والإرادة الإلهية تعلقت أيضاً بذلك وهو أن الناس هم الذين يختارون طريقة حياتهم ونوعها بملء إرادتهم وحريتهم وليس أنهم مجبرون على لون من ألوان الحياة، وملزمون بحركات مفروضة في مسيرة تكوينية قد عينت وحددت من قبل.
ثم إن هذا الاختيار والحرية والإرادة تزيد الإنسان وتسمو به في مضمار التكامل والرقي المعنوي.
وعليه إن الحركة التكاملية للبشر رهن ذلك الاختيار بحيث يمكنه بحرية تامة أن يصنع ما يشاء.
من جهة أخرى أيضاً: إن حرية الإنسان في الوقت الذي تسير به في مضمار الكمال والمراتب المعنوية، فإنها يمكن أن تأخذه إلى الظلم وتجاوز العدل وسلب حقوق الآخرين أيضاً، لذا إن حرية الإنسان من جهة هي متعلق الإرادة التكوينية للحق تعالى ولازمها الكمال ومن جهة أخرى فهي تستلزم غياب العدل، وسيادة الظلم والجور، وسفك الدماء، وإشعال فتائل الحروب والقتل والقتال أيضاً.
هناك العديد من الحيوانات تعيش بعيدة عن كل ألوان الظلم والحرب والصراع، وتقضي أوقاتها هادئة مطمئنة، ولكن الأمر يختلف في ما يخص الإنسان؛ لأن الله لو خلقه على نحو يسلب منه قهراً القدرة على التجاوز والصراع والظلم، وهو بذلك – وهو على هذه الشاكلة – خال من قلق الحرب واضطرابها، وبعيد عن هوس القتال، وتكون حياته وقتئذ أكثر راحة وأوفر اطمئناناً، ولكن لا يمكنه أن يبلغ الكمال المطلوب ولا يصل إلى الدرجة المعنوية المطلوبة.
وينبغى الالتفات إلى أن مسائل الحرب والصراع ما دام موجباً لخير الإنسان وصلاحه فهو متعلق بالأصالة لإرادة الله تعالى، ولكن حينما يكون مستلزماً للشر والفساد فسيكون متعلقاً بالتبع لإرادته سبحانه، وعموماً إن الإرادة الإلهية الحكيمة في جميع قضايا الخلقة متعلقة أولاً وبالذات بالخير والكمال، ولكن لو توقفت بعض الخيرات والمصالح على ظهور بعض الشرور والمفاسد، ستكون الأخيرة متعلقة بالإرادة التكوينية لله بالتبع واللحوق، وقد بين هذا الموضوع بنحو مميز ولغة خاصة في الروايات الشريفة، مثلاً تجدنا نقرأ في بعض الأدعية الواردة: يا من سبقت رحمته غضبه[5].
من هذه العبارة يمكن أن نفهم أن هدف المولى تعالى ومراده ومقصده الأول قد تعلق ببلوغ الناس رحمته ووصولهم للخير والكمال، ولكن من أجل الوصول إلى ذلك الهدف تحتم الضرورة في بعض الأحيان ويقتضي الأمر أن يظهر الغضب الإلهي، ويبدو انتقام الله في الأرض.
واللغز في هذه القضية هو ما أشرنا إليه من أن الخير والكمال الإنساني يجب أن يرافق الجهد والسلوك الاختياري الحر للإنسان، ولازم الوصول إلى الكمال الإنساني هو أن يكون ابن آدم مختاراً، كامل الإرادة والتصرف، هذا من جهة ومن جهة أخرى إن الإنسان الحر أيضاً عندما يكون متعسفاً في اختياره وحريته ويجعل اختياره في غير موضعه فإن ذلك سيعقبه الغضب والعقاب الإلهي أيضاً.
وعليه إن حرية الإنسان واختياره عين كونها سبيلاً لرقيه وكماله فهي في الوقت نفسه يمكن أن تُسخّر الممارسة مجموعة من الشرور والجرائم، وكما أن لاختياره الدور الكبير في بلوغه منزلة الخلافة الربانية، فهو أيضاً يمكن أن يساعده على الهبوط إلى أسفل درجة من الانحطاط والخزي.
من جانب آخر إن عالم الطبيعة على العموم هو عالم التضاد والتزاحم، فإلى جانب النعم والخير الموجود فيه هناك أيضاً محن وآلام، ونقم ومشقة جمة، وكان لدى الله العلم الكامل بكل النتائج الفرعية والخصائص الجزئية عندما خلق ذلك العالم.
من هنا يمكن القول: إن الشرور والمفاسد أمر لازم لعالم الطبيعة وقد كانت مقصودة بالتبع واللحوق لخالق هذا العالم، وعلى العموم إن الخلق والعالم مقصود بالذات له تعالى، والهدف من الإرادة التبعية له سبحانه في ما يخص مسائل الحرب وكل الشرور الأخرى، هو أن وجود الخير الكثير والنعم الوفيرة في عالم الطبيعة والمادة اقتضى وجودها، فإن تحققها وإن كان شراً وبؤساً وعناء ولكنه لازم ولاحق لوجود ذلك الخير الأكثر والنعم الأكبر.
وخلاصة الأمر عند طرح السؤال الآتي: هل وقوع الحرب في نظام الخلق والتكوين مقصود له تعالى؟ وهل إرادته تعلقت بذلك أم لا؟ سنجيب بنعم، وهل يمكن أن تقع حادثة في الكون دون إرادة الله سبحانه وتعالى؟!
ولكن ينبغي الالتفات إلى أن الآثار والنتائج المفيدة للحرب وخيرها وبركتها مقصودة أولاً وأصالة، والشرور والفساد مطلوبة بالتبع لإرادته تعالى، وهذا الكلام يعني أن الله تعالى ومنذ الوقت الذي ابتدع فيه الخلق كان يعلم بطبيعة الإنسان المتعطشة للدماء ويدرك رغبته في الإفساد والدمار، وكان يعلم بأن هذه الحياة الاجتماعية لهذا الموجود ستكون مسرحاً للحرب والظلم والخراب.
ولكن بمقتضى الحكمة البالغة له تعالى اختاره لينال مقام الخلافة ومنزلة النيابة عنه في الأرض، فأعطاه الحرية المطلقة حتى يستطيع مع اختياره هذا السير في طريق الكمال ويعتلي الدرجات المعنوية السامية، وبذلك يكون أرقى وأسمى من منزلة الملائكة، أو يكون بفساده وظلمه وعصيانه أحقر وأكثر هبوطاً مرتبة من الحيوانات والدواب.
3ـ العوامل والشروط التي تدير مسائل الحرب
وهنا يطرح سؤال آخر ينبغي الإجابة عنه أيضاً، وهو سؤال يتعلق بحجم الحرية ومساحتها التي يتحرك بها الإنسان ومديات الاختيار التي يمارس فيها إراقة الدماء والفساد والحرب والدمار.
هل الله سبحانه يريد أن تستمر الحرب ويمضي الصراع الذي يقوده الإنسان إلى ما لا نهاية حتى لو أدى إلى نتائج مرة ونهايات كارثية توجب زوال الناس الصالحين أو توصل إلى انفراط عرى الحق واضمحلال العدل والقسط؟
ما هي النقطة التي تقف عندها حرية الإنسان وإرادته في الإفساد وسفك الدماء؟
وما هو الحد الذي تعجز فيه قدرة الإنسان عن ممارسة الظلم والبغي والخراب ولا يمكنه تجاوز ذلك؟
وهل تزول رغبته وشهوته في إراقة الدماء والفساد والحرب عندما يصل إلى ذلك الحد؟
ونجيب عن هذا السؤال بقولنا: علينا أولاً أن نقرأ آيات القرآن الكريم ونستنطقها، إذ أفادت أن الله سبحانه وتعالى إنما جعل الإنسان حراً من أجل أن يختار طريق حياته إما أن يتصاعد إلى الكمال والرقي أو يتسافل في السقوط والنزول، ولكن هذا الاختيار وهذه الحرية ليست مطلقة بحيث يمكنه أن يلغي أو يقضي عبر ذلك الاختيار على الهدف الأساسي والمقصود الأول من الخلق والإبداع.
لأن إعطاء الحرية التكوينية للإنسان أساساً إنما هو من أجل أن يتمكن من السير في طريق الكمال الإنساني، وضمن مسيرته هذه، فلو كانت حرية الإنسان واختياره سبباً ليسلك الناس جميعاً طريق الغواية والسقوط والحقارة والوضاعة، وأن يعتنق كل البشر الشرك والكفر، فهنا سينتقض الهدف من الخلق والإبداع وينتفي القصد منه.
من هنا إن الحكمة الإلهية لا تقتضي الحرية المطلقة والاختيار الدائم، الأمر الذي يفضي في نهاية الأمر إلى سيطرة المفسدين والظلمة على المجتمع البشري الربانية ويندثر الدين الإلهي، وبذلك لا يمكن لأي أحد السير على خطى الحق سيطرة تامة، على نحو تكون كل مفاصل الحياة وأحوالها وظروفها بأيديهم، فتنغلق سبل الخير وتسد منافذ العدل والصلاح، وفي النهاية ستضمحل التعاليم والعدل، بل سيقاد الناس عبر الطرق المظلمة والسبل الحالكة ويكون الظلم والجور هو سيد الموقف على المعمورة كلها.
إن الحكمة الإلهية اقتضت إلى هذا الوقت أن تكون الحرية نبراساً ينير طريق الحق لأتباعه ومريديه، من هنا كلما انتشر الفساد في المجتمع وضعفت قدرة المصلحين والمؤمنين فيه الأمر الذي يؤدي إلى تلاشى حضورهم واضمحلال وجودهم، فإن الله تعالى سوف يصد الطغاة ويمنعهم من خلال جنوده وأساليبه الربانية الخاصة فيقضي على سيطرة الكفر والشرك في المجتمع وهيمنة المفسدين العريضة على المحسنين، حتى لا تمتلأ الأرض والدهور بالظلم والجور ولا تعلو كلمة الأعداء والمفسدين والظلمة والعصاة.
أسئلة أساسية
وهنا تطرح أسئلة أساسية، وهي:
كيف أن الله تبارك تعالى يتحكم بمسائل الحرب والفساد؟ وكيف يحيط ويحتوي وقائع الدمار والخراب في الحدود التي ذكرت؟ وكيف يمكنه كبح جماح الفساد عند الحد والمقدار والحجم الذي تقدم؟
ونحن نقول في معرض إجابتنا عن هذا السؤال: أن الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك على ثلاثة وجوه وضمن ثلاث وسائل للحيلولة والحد من تفاقم حجم الدمار ونمو الفساد في الأوساط الاجتماعية والمجاميع البشرية في الأرض ومن ثم يسيطر على مسائل الحرب والخراب.
فمرة يسخر الأسباب والسبل فوق الطبيعية كغضب السماء وبعض بلائها، فيزيل قوماً أو حزباً من رقعة الوجود، وأخرى يستخدم العوامل الطبيعية، والأسلوب الثالث هو كبح الظلم والجور والبغي والطغيان عن طريق توظيف العامل الإنساني، فيسخر الله تعالى الناس المؤمنين ويدعمهم ويؤيد المحسنين وعباده الصالحين ويأمرهم بدحر الكافرين والمفسدين والمنافقين وقهرهم، فيحاربونهم ويمنعوا الحد والقدر الخطير الخارج عن الحد الطبيعي من ظلمهم وفسادهم.
ولكن على أية حال إن استعمال هذه الأساليب والطرق إنما يكون نهايته وعاقبته على نحو يتم فيها تأمين المصالح البشرية وتوفيرها، وعموماً تمضي وتدوم حياة الإنسان من خلال ذلك على أفضل وجه مع وفرة الخير والبركات.
إننا نظن في بعض الأحيان ونتوقع مثلاً أن الله تعالى لو نصر نبيه في حرب من الحروب مع الكفار والمشركين وخذل أعداءه وقهرهم، فستتحول الأرض إلى روضة من الزهور والرياحين وأن الكمال البشري سيسود العالم، مثل هذه التصورات نابعة من عدم الدقة والسذاجة في التفكير والبساطة في تمييز الأمور.
ففي هذه الحسابات نغفل عن حقيقة مهمة وهي أن وجود هؤلاء الناس الأشرار وبقاءهم قد يوفر آلاف التبعات والآثار الإيجابية، ويحصل جراء بقائهم وبسبب وجودهم فوائد جمة في الأقل، فإن هؤلاء يحملون في أصلابهم ذرية طيبة وسوف يلدون أشخاصاً حسني السيرة أيضاً، كذلك فإن الله تعالى يجعل من هؤلاء الكفار والمشركين أداةً ونقطة لاختبار المؤمنين والصالحين به.
وفي النهاية إن صبرهم وجلادتهم في مقابل المشقة والتعب والإرهاق الذي يحصل جراء مكافحة هؤلاء، والحد من انتشار رؤيتهم المضلة سيبلغهم الكمال، وسيتسامون في المراتب الإنسانية العالية ودرجات القرب الإلهي، وعليه لو لم يكن المفسدون الظالمون والمنكرون للحق ولم يقع الصراع والحرب لانتفى ميدان التمحيص ومسرح الاختبار ولم يحصل المؤمنون والصلحاء على تلك الكمالات والدرجات العليا، فلا ينبغي التعاطي مع هذه المسألة بنظرة فوقية أو قراءتها على أنها عديمة الأهمية.
مقتضى حكمة الله في الخلق
إن حكمة الخلق اقتضت أن الشرور والمفاسد ما زالت تحتوي على أشياء إيجابية نافعة، فستكون موجودة قلت أو كثرت، مادامت لم تغلق طريق الحق تماماً وتعطل العدل والقسط بنحو مطبق.
أجل عندما يستفحل الظلم والفساد على نحو يعجز طلاب الحق ومريدو الكمال من اكتشاف طريق حياتهم الصحيح ولم يتمكنوا من معرفة الحق بنحو جلي، هنا تتدخل القدرة الإلهية في دحض هؤلاء وتعيق قدمهم في نشر الظلم والفساد وتحد من شيوعه.
الاستنتاج
إن الآيات القرآنية توضح أن الله تعالى خلق الإنسان ومنحه حرية الإرادة، مما يمكّنه من اختيار طريق الحرب أو السلم دون إكراه، رغم أن الملائكة قد يرون بعض البشر ظالمين، إلا أن هؤلاء قد يصلون إلى منزلة أسمى من الملائكة ويكونون أحق بالخلافة في الأرض، مسائل الحرب ليست حدثاً عارضاً، بل جزء من نظام الخلق الرباني، حيث أراد الله للإنسان مواجهة التحديات، وحرية الاختيار تعزز من نمو الإنسان، لكنها قد تُستغل للشرور، لذا، فإن خيارات الإنسان تؤثر في مصيره، وتربط إرادة الله بوقوع الصراعات في هذا النظام.
الهوامش
[1] البقرة، ٣٠.
[2] البقرة، ٢٥٣.
[3] الرعد، ۳۱.
[4] البقرة، ٢٥٣.
[5] الطوسي، مصباح المتهجد، ص٦٩٦.
مصادر البحث
1ـ القرآن الكريم.
2ـ الطوسي، محمّد، مصباح المتهجّد، بيروت، مؤسّسة فقه الشيعة، الطبعة الأُولى، 1411 ه.
مصدر المقالة
مصباح اليزدي، محمّد تقي، الحرب والجهاد في القرآن الكريم، بغداد، مؤسّسة العرفان للثقافة الإسلامية، الطبعة الأُولى، 1436 ه، ص37 ـ ص51.