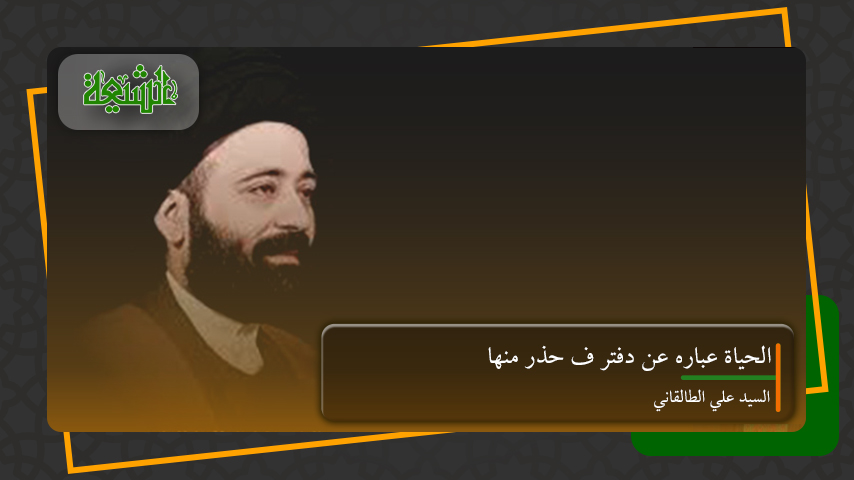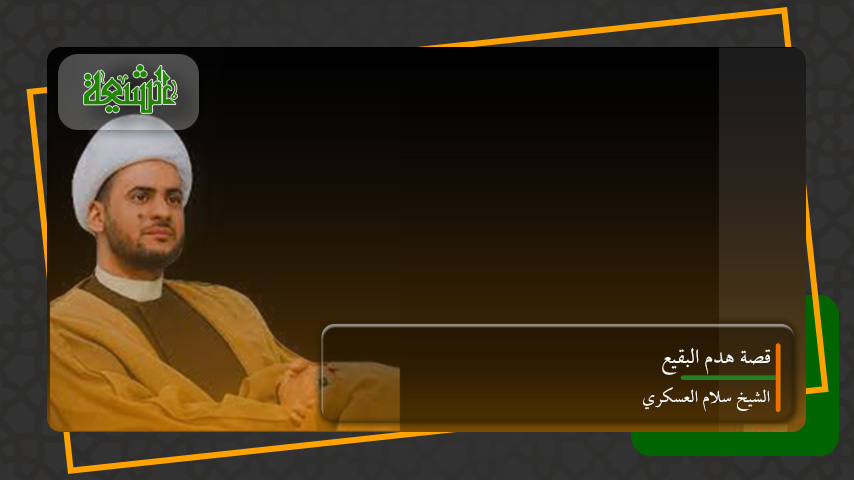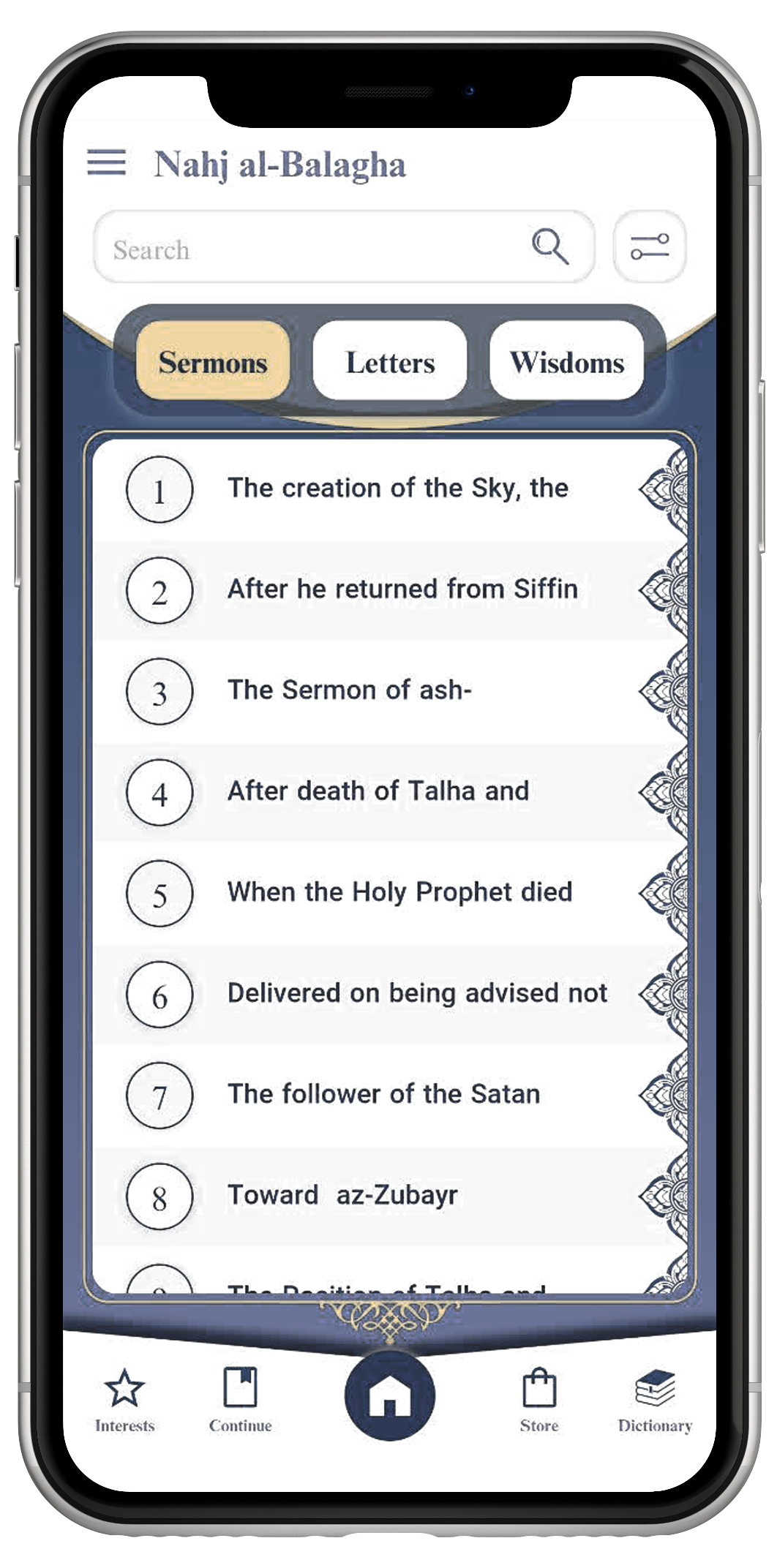ما هي أهم القوانين والنظم التشريعية الحاكمة على الحرب والقتال وبعبارة أخرى ما هي مكانة الحرب والقتال في النظام التشريعي وحجمه؟ ولكن قبل الدخول في أصل هذا الموضوع علينا أن نعرض بعض النكات والملحوظات المتعلقة بذلك.
أولاً: عرض بعض الملحوظات
من النكات والملحوظات المتعلقة بذلك:
1ـ إن كل أحكام الشريعة أعم من كونها فردية أو اجتماعية فهي تابعة ثبوتاً وفي الواقع إلى المتغيرات والتحولات الأخرى، وهذا الأمر المتغير عبارة عن المصالح والمفاسد المترتبة على كل حكم من الأحكام، فلو توفرت المصلحة والمنفعة في عمل، لما أمر الشارع المقدس بأدائه وإتيانه، ولو كان فيه مفسدة ومضرة لنهى المكلفين ومنعهم عن فعله والإتيان به.
وفي الأثناء هناك بعض الأفعال تضمنت فيها منافع ومصالح وفيها أيضاً مضار ومفاسد، ففي مثل هذه الموارد يحكم الشارع المقدس عليها بعد ملاحظة المفاسد والمصالح المترتبة عليها، فلو كانت مصالح ذلك العمل ومنافعه في الجملة أرجح من مفاسده ومضاره لأمر به، وإن كان العكس نهى عنه.
وهناك نكتة أخرى تذكر في هذا المجال؛ وهي إنه لو بلغت تلك المصلحة أو دفع تلك المفسدة حد اللزوم والإيجاب، يكون أمر الشارع المقدس ونهيه بنحو وجوبي والزامي (الوجوب والحرمة)، وإلا فيكون الأمر بصورة غير إلزامية (الاستحباب والكراهة).
وعليه إن كل فعل تعده الشريعة الإسلامية واجباً إنما هو فعل يشتمل على مصلحة فقط، أو فيه مفسدة ولكنها قليلة جداً مقابل المصلحة الكبيرة، عندها سيكون أداء ذلك العمل – في الجملة – واجباً، وفي المقابل إن كل فعل يعتبره الشرع المقدس حراماً، هو فعل الذي يحتوي على مفسدة، أو كانت مصلحته قليلة لا تذكر مقابل مفسدته العظيمة، ومع وجود تلك المصلحة الجزئية أيضاً سيكون ارتكاب ذلك الفعل حراماً أيضاً بسبب وجود المفسدة الأقوى فيه.
بجملة واحدة إن الأحكام والقوانين الإسلامية سواء كانت أحكاماً فردية أم اجتماعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية ونفس الأمرية، سواء علمنا بتلك المصالح والمفاسد الناشئة عن تلك الأحكام أم لم نعلم.
2ـ وهنا جاء دور السؤال الآتي وهو: ما السبيل لمتابعة المصالح والمفاسد المذكورة ومعرفتها؟ وكيف يمكن الاطلاع وتعرّف المصالح والمفاسد الكامنة وراء الأحكام الشرعية؟ وهل من سبيل لإدراك مناشئها ومصادرها؟
وحتى نجيب عن هذا السؤال يجب القول: إن كثيراً من مواطن هذه المصالح والمفاسد كُشِفَت لنا عن طريق الوحي والقرآن الكريم، أو عن طريق أقوال المعصومين وأحاديثهم، وهم المفسرون الحقيقيون للقرآن الكريم، كذلك، إن كثيراً من تلك المصالح والمفاسد وملاكات الأحكام يتم إماطة اللثام عنها بمساعدة العقل والتجربة، وهنا إذا كان كشف العقل هذا كشفاً قطعياً ويقينياً، عندها يمكن الاعتماد عليه في الكشف عن الحكم الشرعي أيضاً.
ولكن في كثير من الموارد أيضاً يمكن أن تكون المصالح والمفاسد الواقعية للأحكام الشرعية مجهولة وتبقى غير معروفة، ولا يمكننا وبأي طريق الكشف عنها والوصول إليها، أي لا عن طريق الآيات ولا الروايات ولا يمكننا الكشف والتعرف عليها بمساعدة العقل أيضاً.
إذا المصالح والمفاسد التي تسنى لنا العلم بها والتعرف عليها إنما يمكن أن تكون في الحقيقة جزءاً من مجموعة مصالح و مفاسد وملاكات الأحكام الشرعية الواقعة في العالم الفسيح فقط، فنحن لم ندع إطلاقا لإدراك جميع المصالح المفاسد الواقعية للأحكام، ولم نزعم بأننا نستطيع الكشف عنها جميعاً.
بل مع ملاحظة التعقيد والدقة الموجودة في أعمال الإنسان وسلوكياته، ونتائج ذلك في جميع أبعاد حياته المادية والمعنوية والدنيوية، والأخروية والاقتصادية، والسياسية والقانونية وفي جميع مدياتها وعواقبها، لا يمكننا أن ندعي أننا نستطيع الكشف عن سائر المصالح والمفاسد الموجودة في جانب من هذه الجوانب الإنسانية، حتى يمكننا أن نزعم أننا نعي جميع المصالح والمفاسد الكامنة وراء سائر الأحكام الشرعية ونفهمها.
3ـ رغم أن مفردة الحرب والجهاد تطلق على القتال و المحاربة بين فريقين وبين مجتمعين أو شعبين أيضاً، كذلك إنه بالرغم من إطلاق مفردة الجهاد على مكافحة الظواهر السلبية المختلفة سواء الثقافية منها، أم الاقتصادية، أم السياسية، أم العسكرية، إلا أن ما نقصده هنا فقط هو مكافحة الأمر وإزالته عن طريق القتال العسكري.
4ـ عندما نقصد تحليل ظاهرة الحرب المتعلقة بموطن بحثنا، وهي التي عادة ما يرافقها حدوث أمر هو الأخطر والأهم من بين كل تفاصيل الحرب ألا وهو قتل الإنسان وسفك دمه سواء كثر أم قل، فحري بنا أولاً أن نتناول هذا الموضوع وأن نبسط هذه المسألة، وأول ما نعرضه هو بيان يتعلق بالقتل – بنحو مطلق – في النظام التشريعي والقواعد القانونية للإسلام، ومن ثم نتناول الموضوع الأساسي وهو نفس واقعة القتل في الحرب سواء تعلق موضوع القتل بالفرد أم المجموعة، وسنستعين من أجل توضيح هذا الموضوع ببحث بعض المسائل التشريعية المتعلقة بموضوع الحرب.
توجد هناك نزعة لدى كثير من الفلاسفة وعلماء الحقوق والقانون وبعض المفكرين الآخرين ترتبط بهذه المسألة، وتقوم هذه النزعة على ضرورة احترام حرمة الإنسان وكرامته وتقديسه، مهما كانت ظروفه وطبيعة حياته التي يعيشها، ومن أي طبقة كان، وأي عمل اقترف، وأي سلوك ارتكب، وفي ضوء ذلك لا يمكن أن يحكم على أي إنسان بجزاء شاق أو أي عقاب فيه كثير من الغلظة والخشونة، والأقبح من ذلك لا يمكن الحكم عليه إطلاقاً بالموت.
ثانياً: الحرب وضرورة حفظ حياة الإنسان
تبين حتى الآن أن الفرد في مجتمع ما قد يواجه عقوبة الإعدام من أجل إزالة خطره عن مصالح المجتمع، وبقتله يكون سائر أفراده في مأمن ومنأى عن جرائمه، وفي ضوء هذا المنوال وعلى مستوى الدول والمجتمعات قد تواجه الشعوب والدول مجتمعاً ضالاً عن الطريق ومنحرفاً عن الحق والعدل غارقاً في غياهب الظلم والفساد والطغيان، ولديه الاستعداد والرغبة في التجاوز والاعتداء على سائر الشعوب والمجتمعات الأخرى، ففي مثل هذه الصورة يحكم على هذا المجتمع بالإعدام والإبادة أيضاً، ويجب هزيمته وكسر شوكته، لتشعر باقي الأمم والشعوب والبشرية بنحو عام بالأمن والاطمئنان، ومع توفر هذا الأمن من التجاوز والتعدي لن تحرم تلك الشعوب من السعادة والكمال الحقيقي.
من هنا إن المجتمعات الإسلامية – وما نقصده هنا ليس المجتمعات الإسلامية بالظاهر والاسم فقط، بل ما نريده هو المجتمعات الإسلامية في الواقع والعمل – التي تقوم على أساس العدل والحق، ونظام وطيد ينبذ الظلم والفساد مكلفة بمحاربة مثل هذا المجتمع الفاسد الظالم والمعتدي ومقاتلته، حتى يكف عن تجاوزه واعتدائه، ويعود إلى رشده ويستقيم أو يهزم عن بكرة أبيه، ويأتي مجتمع سوي بدلاً عنه.
وعلى هذه الشاكلة يتضح أن الحرب والقتال ليست سلبية في الظروف كافة وليست النزاعات باطلة في جميع الأماكن والمناسبات، فإن الأمة التي تقاتل لصد المعتدي وردعه بالتأكيد ليست كالأمة التي تكون في موقف المعتدي والمتجاوز حتماً، بل هناك فرق بينهما، فإن الطرف الذي يحارب بدواعي الدجل والخداع وظلم الآخرين لا يستوي أبداً مع الطرف الآخر الذي يقاتل لغرض مكافحة الظلم ويحارب من أجل الدفاع عن حقوق المظلومين التي غصبها الطغاة والطامعون، بل إن قيمة سلوك الطرف الأول واعتباره تكون سلبية، في حين يكون عمل الفريق الثاني وأداؤه نافعاً وإيجابياً.
أجل، إن ما يستحق كل الذم، وأشد القبح، وأعنف العقوبة هو قتل النفس المحترمة أو النفس الزكية، فإن قتل النفس لا يعني قتل إنسان فقط، ولا فساداً في الأرض فحسب، يقول الله تعالى في هذا السياق: مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا [1].
ولكن لو قتل شخص شخصاً آخر بحق وبحكم الإسلام فإنه لا يرتكب جرماً، مثال ذلك: ورثة المقتول وأولياء الدم لهم الحق أن يقتلوا القاتل وهذا معنى القصاص في الإسلام، أو يقوم المجتمع بالحكم على من يرتكب جرماً كبيراً متجاوزاً بذلك على حقوق الآخرين، أو كان سلوكه يمثل طعنه قوية في مصالح الناس المادية أو المعنوية، عندئذ يمكن لذلك المجتمع أن يعدم ذلك الفرد ويقصيه من الوجود، من هنا يمكن أن ندرك عدم المشكلة وانتفاء الضير في محاربة المجتمع الذي يسعى لتدمير المصالح المادية والمعنوية للبشر والمكون الذي يكون طبعه الفساد والكبر والاعتداء.
ثالثاً: الحروب في الشرائع التي سبقت الإسلام
عند مطالعة القرآن الكريم يتضح أن الحرب المشروعة والقتال على الحق – الذي نسميه نحن جهاداً – كان موجوداً في جميع الأديان التوحيدية، وليس تشريعه خاصاً بالدين الإسلامي فقط، ونقرأ في إحدى الآيات الشريفة ما يأتي: وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ [2].
إن الآيات المذكورة تدل على حقيقة أن هناك كثيراً من الأمم والأقوام المؤمنة قبل بعثة النبي محمد المصطفى (ص)، وأن الشرائع والأديان التي سبقت الإسلام كانت تحارب بأمر أنبياء الله الكفار والمشركين والمفسدين والطغاة وأعداء الله تعالى، فيستبسلون في القتال ويكونون غاية في الصلابة ورباطة الجأش والقوة، ويسطرون أروع الملاحم في الشجاعة والاستقامة، ولا يظهرون أمام العدو أي لون من ألوان الذلة، والهوان، والخضوع أو التقهقر.
هؤلاء قد وضعوا حاجاتهم وأمنياتهم بين يدي الله الغني المالك، وعفروا وجوههم في حضرته، وبعد الاستغفار من الذنوب وطلب العفو عن الأخطاء التي صدرت عنهم، والتوبة عن إفراطهم وتفريطهم، توكلوا على الله واستعانوا به لمواجهة الأعداء ومقاتلتهم، يرجون بذلك النصر والفوز منه تعالى، فاستجاب الله جل شأنه أيضاً دعاءهم وأعطاهم ما طلبوه، فنصرهم على أعدائهم، فضلاً عن ذلك قد جزاهم في الآخرة أيضاً أحسن الجزاء وكافأهم أجزل المكافأة يوم القيامة.
1ـ حرب بني إسرائيل لاحتلال فلسطين
جاء في بعض الآيات القرآنية الشريفة أن النبي موسى (ع) وبحسب الأوامر التي تلقاها من الله عز وجل دعا بني إسرائيل للجهاد واستنهاضهم للحرب والقتال، لكنهم لم يطيعوه بما أمرهم.
فبعد أن أعرض فرعون عن القبول بدعوة موسى (ع) لعبادة الله، ونتيجة ذلك عصى وتمرد واستكبر وأفسد في الأرض، أهلكه الله وأغرقه في البحر، اتجه موسى (ع) ومن معه من بني إسرائيل بعد أن تخلصوا من ربقة فرعون وظلمه وجوره، من مصر إلى الشام وفلسطين، وكان يعيش في فلسطين قوم كافرون وهم أناس اتصفوا بالقوة والغلظة والمهارة القتالية والحربية.
فقال موسى لبني إسرائيل: إن الله تعالى قد جعل هذه الأرض لكم، ولكن عليكم حتى تستقروا وتكونوا هذه الأرض تحت تصرفكم أن تقاتلوا، ولكن بني إسرائيل وبسبب السنين العجاف التي قضوها مع فرعون بين القتل والتعذيب والخوف والرعب، حيث تحولوا بسبب ذلك إلى أناس أذلاء جبناء قليلي الجرأة والعزم، وأيضاً بسبب الدعة والراحة والعافية التي حصلوا عليها بعد خلاصهم منه، امتنعوا عن إطاعة أمر موسى(ع)، فقالوا لموسى (ع): اذهب أنت وربك فقاتلا، وأخرجا هؤلاء الكفرة من هذه الأرض، ليتسنى لنا دخولها بعد ذلك، وبسبب هذا العصيان والتمرد على أوامر الله تاهوا في الأرض والصحاري أربعين سنة والآيات الواردة في سورة المائدة من ۲۰ – ٢٦ تتحدث عن تمام هذه القصة.
من هنا إن بني إسرائيل وبسبب تخلفهم عن طاعة تكاليف الله وامتناعهم عن الجهاد، تاهوا وضاعوا في الصحارى والوديان أربعين سنة من يوم خروجهم من مصر وحتى وفاة النبي موسى (ع)، ولكن بعد رحيله وبأمر من خليفته النبي يوشع بن نون فتحوا أرض فلسطين لتنتهي بذلك سنين الغربة والتشرد والضياع.
2ـ حرب طالوت وجالوت
تتحدث الآيات (٢٤٦) وحتى (٢٥١) من سورة البقرة عن قصة طالوت وجالوت وتتحدث عن المعركة التي دارت بينهما وهي نموذج آخر عن تشريع الجهاد وجوازه في الأديان التي سبقت الدين الإسلامي، فبعد أن فتح بنو إسرائيل بلاد فلسطين بأمر يوشع بن نون وسكنوا هناك، مضت أكثر من ٣٥٠ عام ولم يحكمهم ملك، أو قائد يقودهم، أو يدير شؤونهم الحياتية والاجتماعية؛ بل كان القضاة هم من يتقلد زمام كل هذه الأمور.
وخلال تلك المدة عادة ما تنشب الصراعات والحروب بينهم وبين جيرانهم من العمالقة العرب، وأهل مدين والفلسطينيين، والآراميين، وهذه الاشتباكات تارة تكون لصالح بني إسرائيل فينتصرون على خصومهم وأخرى يهزمون فيها.
وفي أواسط القرن الرابع دخل بنو إسرائيل حرباً ضروساً مع الفلسطينيين، وخسروا المعركة معهم بصعوبة، فضعفوا وعجزوا واستكانوا، وشردوا وضاعوا، وبعد هذه الهزيمة النكراء على أيدي الفلسطينيين وشعورهم بالذلة والمهانة ذهب زعماء بني إسرائيل القضاة الذين كانوا وما زالوا يديرون شؤونهم الحياتية والاجتماعية إلى أحد الأنبياء المعاصرين، وطلبوا منه أن يكون ملكاً عليهم حتى يهتدوا بأمره وبتعاليمه إلى طريق الجهاد والقتال في سبيله، حتى يلحقوا الهزيمة بالأعداء الذين أذاقوهم الذل والهوان، وجعلوهم أمة بائسة ضعيفة لأوقات طويلة.
وعلى كل حال اندلعت المعركة واشتد القتال بين طالوت وجالوت ويقتل الأخير على يد النبي داوود وهو أحد جنود طالوت الشجعان، ومع مقتل طاغوت زمانه انفرط عقد التماسك في جبهة العدو، وشاعت الفوضى فيها، وتفرق جيش المردة، وانتهت الحرب بهزيمة الكفار والظلمة وانتصار بني إسرائيل وجيش عباد الله.
وبعد هذه الواقعة وحدوث بعض الوقائع المتلاحقة الأخرى تقلد النبي داوود في النهاية الحكم، وأصبح ملكاً على بني إسرائيل، وبعد أن رحل النبي داود نال شرف قيادة دولة الحق والعدل خليفته وابنه النبي سليمان (ع)، وتميز زمانه بأن بلغت قوة دولة الحق والعدل ذروتها وكمالها.
3ـ الجهاد في دولة النبي سليمان (ع)
ولما كانت دولة النبي سليمان (ع) قد امتازت بخصائص ومزايا فريدة، فكانت سلطنة لا نظير لها، جدير بنا هنا أن نعرض لبعض هذه الخصائص التي جاءت في القرآن الكريم.
يناجي النبي سليمان (ع) ربه فيرجوه وهو في حضرته، فيقول: قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الوَهَّابُ[3].
وفي جواب الباري سبحانه وتعالى واستجابته لدعوى النبي سليمان (ع) ورجائه أنه قد أعطاه ووهبه خصائص ومزايا مثيرة للإعجاب والحيرة، فنقرأ في سورة الأنبياء هذه العطايا والكرامات الرائعة من الله عز وجل: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ * وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلَاً دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ[4].
وكيفما كان الأمر فإن الآيات التي جاءت في سورة النمل والتي تقدمت معنا تحكي لنا دولة النبي سليمان (ع) وتصف لنا طبيعة الجيش والجنود البواسل الذين كانوا بإمرته ذلك الجيش المؤلف من تركيبة فريدة والمنظم في أقصى غاية من الإعجاز: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الجِنِّ وَالإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ[5].
وهذا الأمر طبعاً بمثابة المقدمة والتمهيد والاستعداد لخوض ذلك الجيش الحرب، وحينئذ يكون ذلك القتال والصراع مشروعاً وجائزاً للنبي سليمان (ع) وأتباعه وجنوده.
رابعاً: الجهاد في الإسلام
حان الوقت لبيان طبيعة الحدود الشرعية للجهاد في الدين الإسلامي الحنيف، وهنا سنبدأ بعرض ذلك:
إن المسلمين عندما كانوا يعيشون في مدينة مكة لم يتمكنوا من تأسيس مجتمع إسلامي مستقل، ولم يقدروا على تشكيل خليط اجتماعي متكامل، إذ كان عددهم قليلاً، ولم تكن قدرتهم الاقتصادية والاجتماعية بتلك القوة والتماسك أيضاً، وبنحو عام كان المسلمون يُعدّون أقلية بين المشركين الذين هم كثرة، وكانوا معذبين بأنواع العذاب الجسمي والروحي من قبل المشركين، وكانوا عاجزين عن الدفاع بسبب قلة إمكاناتهم الدفاعية وشحتها.
وعليه، إن أول شيء فعله نبي الإسلام محمد (ص) بأمر الله تعالى، هو أن أرسل فريقاً من المسلمين برئاسة جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة، وبعد أن قضى هو ومن معه بعض السنين في مكة هاجر النبي ومعه كثير من المسلمين إلى يثرب التي سميت في ما بعد بمدينة النبي، وحتى ذلك التاريخ وقبل هجرة النبي (ص) ومن معه إلى المدينة لم يكن المسلمون مكلفين بمقاتلة الأعداء ومحاربتهم.
وكان المسلمون الغيارى المتحمسون قبل نزول قانون الجهاد والتكليف للقتال يطلبون من الرسول الأكرم محمد (ص) أن يأذن لهم في مقاتلة المشركين والكفار في مكة وفي غيرها.
إن طبيعة الحياة التي قضاها المسلمون بين المشركين وبهذا النحو من التعسف والقسوة الذي كان يصدر من كبراء مكة أصبحوا مقيدين في تحركهم الأمر الذي كان سبباً في تشريدهم وتعذيبهم بصنوف العذاب، وقد زعزعت تلك الأمور في نفوسهم روح القتال ومنعتهم عن محاربة المشركين، وكسر شوكتهم، وإلحاق الهزيمة بقوتهم، وحالت تلك الظروف من أن يتمكن بعض المسلمين من تخليص إخوانهم الذين كانوا تحت قبضة المشركين؛ إذ كانوا يرزحون تحت التعذيب الجسمي والنفسي.
ولكن في ذلك الوقت اقتضت مصالح الإسلام والمسلمين عدم خوض الحرب والدخول فيها، لأن عددهم كان قليلاً، ومن اللحاظ الاقتصادي هم فقراء جداً، إذ صادر المشركون أموالهم وأخذوها منهم بالقوة، وكانت قدارتهم العسكرية تكاد تكون معدومة، ولم يتوفر القدر الكافي من الأسلحة وعدد الجنود الذين يمكن الاعتماد عليهم في الحرب، لذلك لم يأذن النبي (ص) لهم بالقتال في تلك الحقبة.
إن إعطاء الإذن بالقتال في مثل هذه الأوضاع والظروف غير المهيأة، والأجواء والشرائط الصعبة التي كان يمر بها المسلمون سيكون في الواقع بمنزلة جواز قتل النفس، لذلك وحتى مع الإصرار والطلب الحثيث الذي كان يلح فيه بعض المسلمين لم يقابل بالموافقة والرضى من قبل النبي لقتال الأعداء، ذلك؛ لأن الاستعداد اللازم للحرب مازال مفقوداً، لذلك عكف المسلمون في تلك الحقبة على صناعة عمقهم ومحيطهم وإعادة تنظيم بيتهم الداخلي، ولملمت شتاتهم الأمر الذي أتاح لهم البدء بمقدمات تأسيس مجتمع مسلم حي ومتماسك، حتى يمكنهم بعد ذلك مع توفير الأسلحة والمعدات لتعبئة القوى اللازمة والقدرات المطلوبة – يبدؤون بالتخطيط الجاد للعمليات العسكرية، وإعادة الحقوق والممتلكات التي اغتصبها العدو منهم.
ولكن وفي ضوء الآيات القرآنية التي أعطت النبي الإذن بالقتال، وبعد صدور الأوامر الصريحة من النبي (ص) ببدء الحرب على المشركين نجد أن الفريق الذي كان متحمساً أكثر من غيره لخوض المعركة ضد الكفرة، وكانوا يصرون على النبي بالبدء بالحرب، نجدهم يتخلفون عن الأمر بالجهاد ويمتنعون عن الدخول في الحرب، هذا ما أخبر عنه الله تعالى في هذه الآيات الكريمة:
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ القِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا القِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلَاً * أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ المَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللهِ فَمَا لِهَؤُلَاء القَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا[6].
خامساً: تشريع الجهاد
هكذا وفي النهاية وبعد مضي وقت الإعداد النفسي والروحي وانقضاء دورة البناء الذاتي لدى المسلمين نزلت الآيات (۳۸) إلى (٤١) من سورة الحج على النبي محمد (ص) تأذن له وللمسلمين بالقتال، وتسمح لهم أن يضربوا الأعداء بكل شدة وغلظة، لتكون هي البداية لجهادهم بوجه كفار قريش ومشركيهم؛ إذ أشارت الآيات الآتية لذلك:
إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ * أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ[7].
ففي هذه الآيات الشريفة إذن للمسلمين الذين كانوا قد ظلموا، والذين ضاعت حقوقهم واغتصبت من قبل الآخرين، ورخصة في المحاربة، وجواز لهم في الدفاع عن أنفسهم، ومما لاشك فيه أن لسان هذه الآيات ولحن الرخصة التي أعطيت للمسلمين بالقتال جاءت بعد الظلم والجور الذي وقع عليهم من المشركين وتعديهم على حرمات المسلمين وأموالهم، وتشريدهم من بيوتهم، وسلب الأمن والسكينة عنهم، وعليه إن سياق هذه الآيات هو الدفاع؛ بل إن لحنها على الأكثر هو القصاص، ولم تتعرض إلى الجهاد الابتدائي إطلاقاً.
الاستنتاج
أن الحرب ضرورة لحفظ حياة الإنسان وأن الحرب ليست سلبية في الظروف كافة، وأن الحرب المشروعة كانت موجودة في جميع الأديان التوحيدية، وليست تشريعها خاصاً بالدين الإسلامي فقط، ومن تلك الحروب حرب بني إسرائيل لاحتلال فلسطين زمن النبي موسى (ع)، ثم حرب طالوت وجالوت زمن النبي داود (ع)، وبعد رحليه نال شرف القيادة ابنه النبي سليمان (ع)، وتميز زمانه بأن بلغت قوة دولة الحق والعدل ذروتها وكمالها، ثم بدأ الجهاد في الإسلام بعد صدور الأوامر الصريحة من النبي محمد (ص) وسمح للمسلمين أن يضربوا الأعداء بكل شدة وغلظة، لتكون هي البداية لجهادهم بوجه كفار قريش ومشركيهم.
الهوامش
[1] المائدة، ۳۲.
[2] آل عمران، ١٤٦.
[3] ص، ٣٥.
[4] الأنبياء، ۸۱ – ۸۲.
[5] النمل، ۱۷.
[6] النساء، ۷۷ – ۷۸.
[7] الحج، ٣٨ – ٤١.
مصدر المقالة (مع تصرف)
مصباح اليزدي، محمّد تقي، الحرب والجهاد في القرآن الكريم، مؤسّسة العرفان للثقافة الإسلامية، الطبعة الأُولى، 1436 ه.