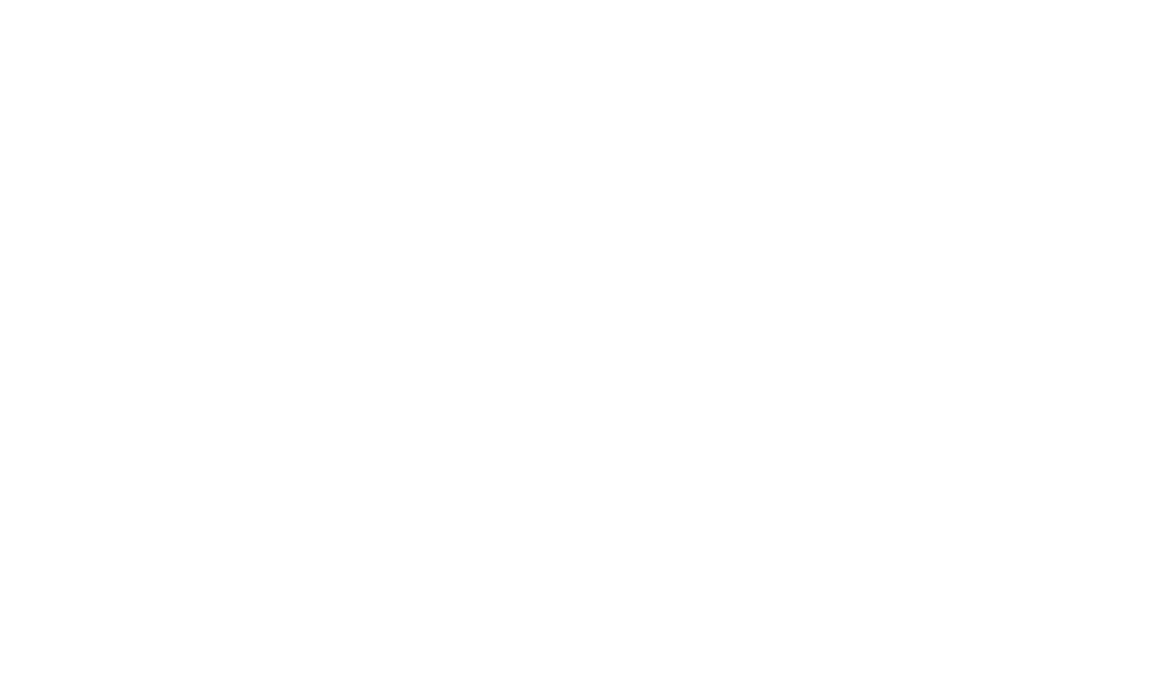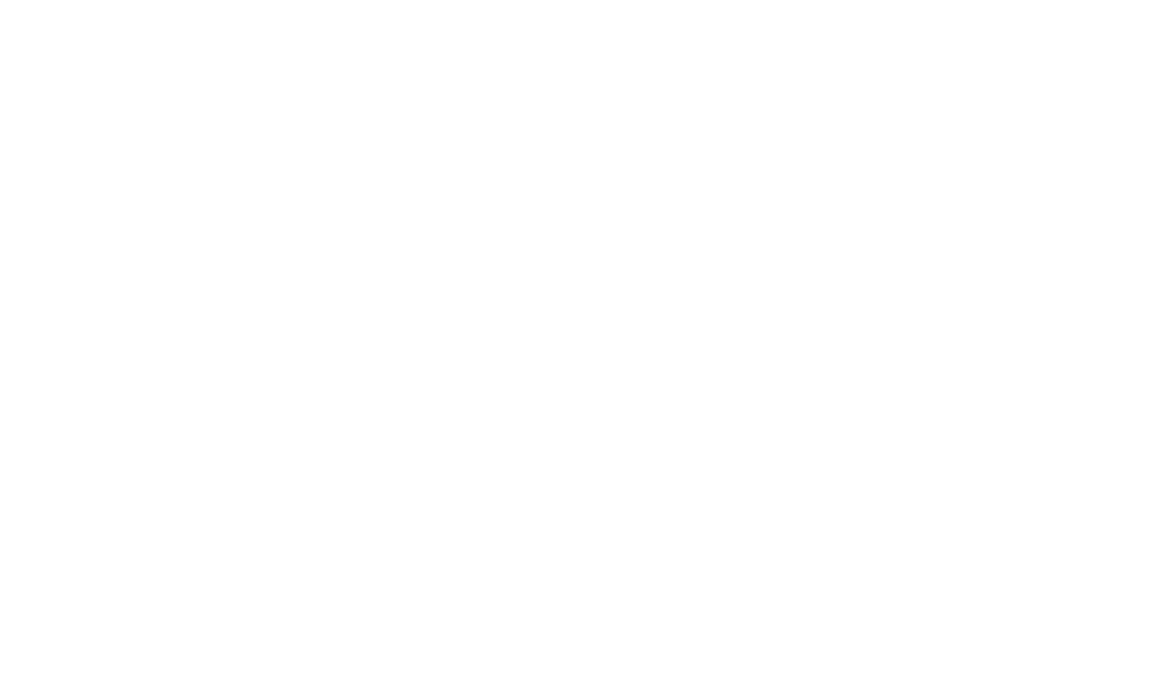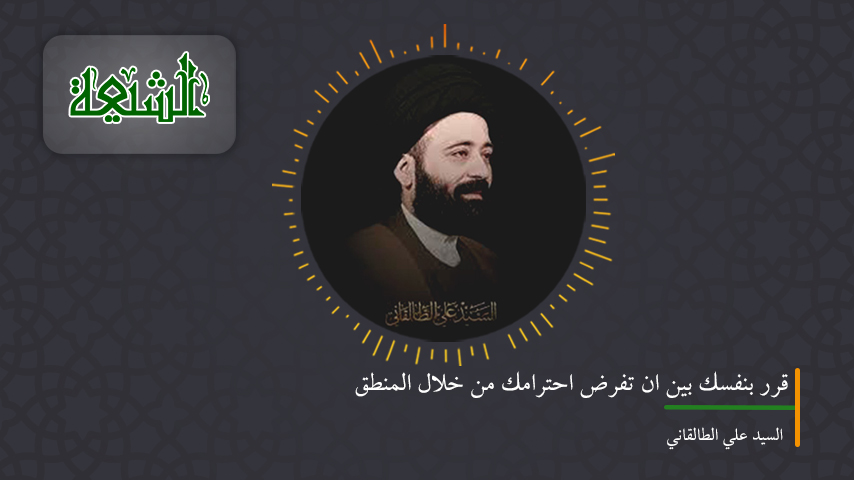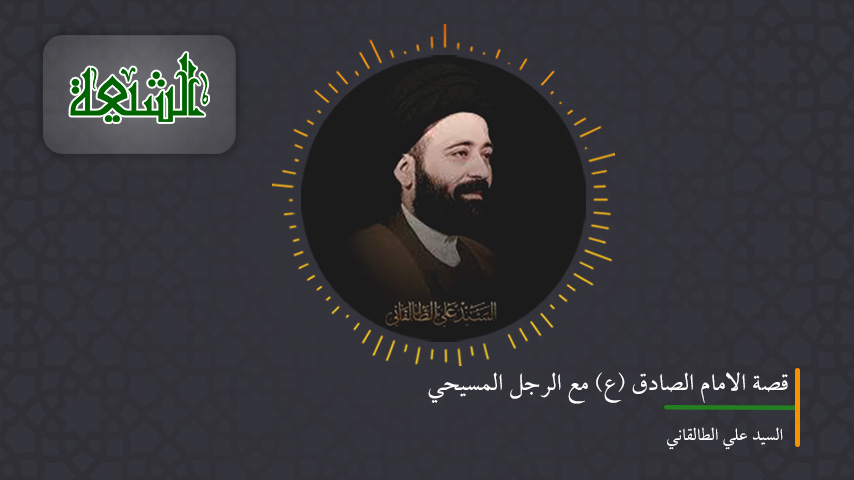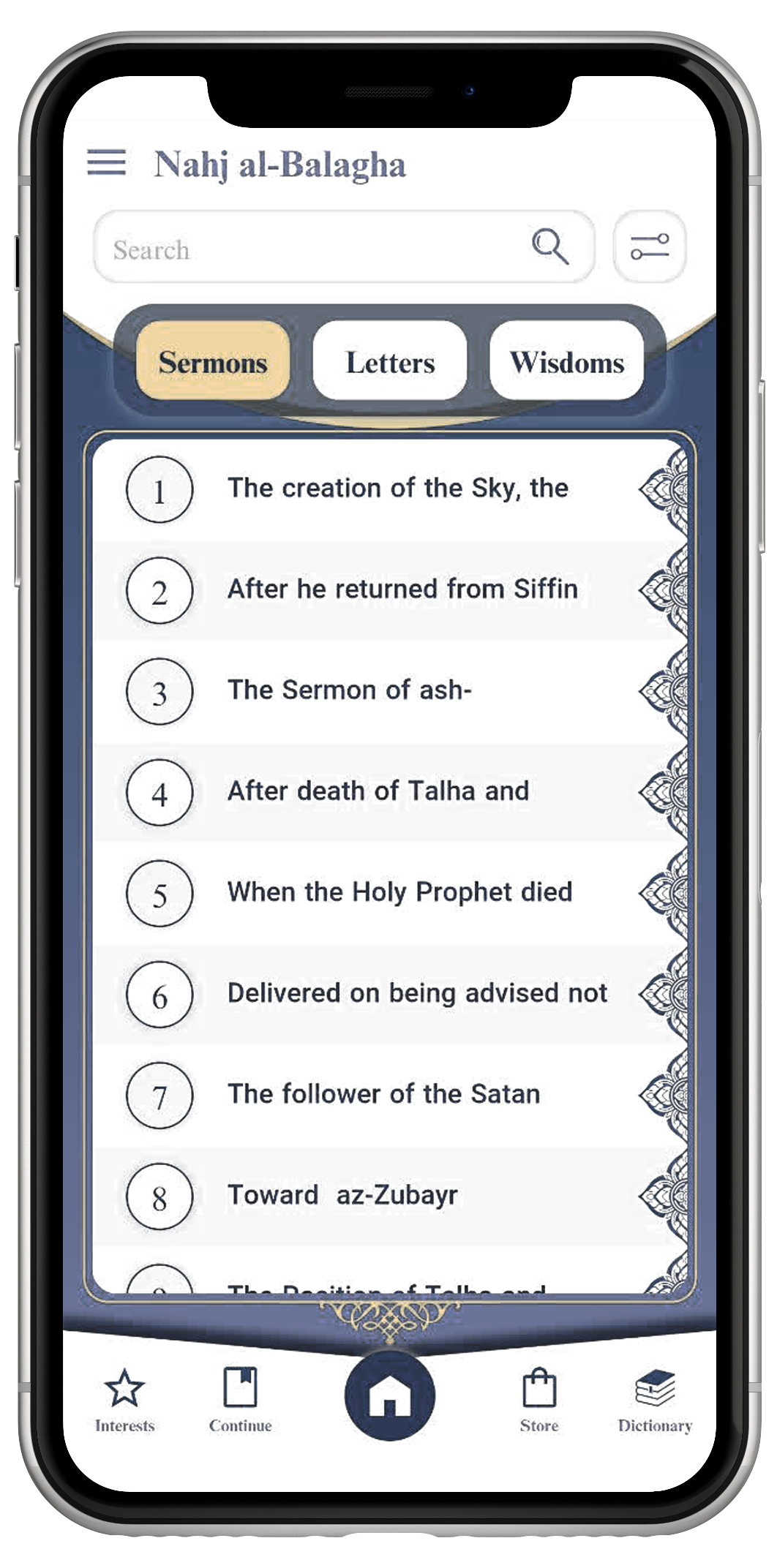من المعروف لدى الخاصة أن اليونانيين هم أقدم الناس تطورا وتقدما من الناحية العلمية حيث ثبت في التاريخ أن أكثر العلوم الإنسانية نشأت منهم ثم انتشرت فيما بعد في أرجاء المعمورة. وأحسن المثال لذلك الفلسفة الأم التي تفرعت منها جُل العلوم الغربيةّ. إن علماء المسلمين أخذوا من الغرب علوما كثيرة كالفلسفة والمنطق وغير ذلك – وخصوصا من يونان – وترجموا تلك العلوم الى اللغة العربية ثم غربلواها وأخذوا ما يوافق الاسلام وتركوا مايخالفه.{فبشّر عباد * الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه}.[1] وبسبب أخذهم لتلك العلوم من اليونان بقيت بعض الكلمات أو المصطلحات على هيئتها اليونانية مع تعريب قليل. ومن تلك الكلمات “الهرمينوطيقا”.
فالهرمينوطيقا هو علم وفن تفسير النصوص، ويعتبر من أهم المصطلحات في مجال الفلسفة والدراسات الدينية. الهرمينوطيقا تركز على فهم المعنى العميق وراء الكلمات، حيث أنها تساهم في تفسير النصوص المقدسة والأدبية على حد سواء. المصطلح الهرمينوطيقا يتكرر مرارًا وتكرارًا عند الحديث عن دراسة النصوص، لأنه يعبر عن منهجية البحث وفهم المقاصد. في الهرمينوطيقا، يُنظر إلى النصوص من خلال سياقها التاريخي والثقافي، ويُستخدم مفهوم الهرمينوطيقا لاكتشاف المعاني المخفية والغامضة.
يتبين أن الهرمينوطيقا ليست مجرد تفسير، بل هي طريقة فلسفية تهدف إلى تحقيق فهم أعمق، ولهذا السبب فإن الهرمينوطيقا تتكرر بشكل مستمر في المناقشات الأكاديمية. وإجمالاً، يمكن القول إن الهرمينوطيقا تعتبر المفتاح لفهم أذهان الكتّاب والنصوص عبر العصور، بحيث تتكرر كلمة الهرمينوطيقا في الكثير من الدراسات والنقاشات.
الهرمينوطيقا
“تعد كلمة هرمينوطيقا (Herméneutique) والتي تعني فن التأويل – محور جدل بدأ لاهوتيا مع تفسير النصوص المقدسة واستمر ابستمولوجيا (Épistémologie) مع تعدد القراءات النقدية للظاهرة الإبداعية.
والهرمينوطيقا في اشتقاقها الأصلي جاءت من لفظ (Hermenia) من هرمس (Hermes)، الإله الوسيط بين الآلهة والناس، يفسر لهم ويشرح المرمز ويفك الطلاسم، ومع آباء الكنيسة كان يعني تفسير كلمة، أما في الإسلام فقد ارتبط التأويل بخشية الله؛ وقد أودع الله هبة التأويل للعلماء المفسرين، ما يؤكد أن مصطلح الهيرمنيوطيقا قديما كان ذَا طابع قداسي مرتبط بشرح أوامر الإله.
يمثل المفكر الألماني شليرماخر (Schleiermacher) الموقف الكلاسيكي للهرمنيوطيقا، ويعود إليه الفضل في أنه نقل المصطلح من دائرة الاستخدام اللاهوتي ليكون “علما” أو “فنا” لعملية الفهم وشروطها في تحليل النصوص.[2]
لفظ الهرمينوطيقا (Hermeneutics)، مأخوذ من المعنى اليوني (hermeneuin)، بمعنى (تفسير) وقد استخدمت هذه الكلمة منذ زمن افلاطون بمعنى التوضيح وإزالة الغموض عن الموضوع، وقد اطلق ارسطو هذا اللفظ على قسم من أقسام كتاب أرغنون (حول منطق القضايا) وعادة ما توجد هناك علاقة واضحة بين الإشتقاق اللغوي لهذا الإصطلاح (الهرمينوطيقا) وكلمة (هرمس) وهو الملاك الذي ينقل رسائل الآلهة ودساتيرها إلى الأرض، وحتى القرن السابع عشر الميلادي لايوجد فرع للعلوم بهذا الإسم، وإنما حدث ذلك بعد القرن السابع عشر الميلادي فما بعد.[3]
الهرمينوطيقا ودلالة المعنى في الواقع الإسلامي
مصطلح الهرمينوطيقا مصطلح له انتماؤه الثقافي، ذلك الإنتماء الذي يشكل الحاضن الطبيعي لمضمونه الدلالي، فلا يتوقع حينها أن تكون له حركة دلالية خارج إطار البيئة التي أنتجته. وبالتالي لايتصور أن يكون هناك بحث دلالي في الثقافة العربية والإسلامية لمصطلح الهرمنيوطيقا. ومن هنا نجد كثيرًا من الباحثين يفضلون إبقاء المصطلح على طبيعته الأساسية دون أن يترجم لأي مصطلح مقابل، وذلك بناء على أن الهرمينوطيقا وما تحمله من مخزون دلالي لايوجد لها بالفعل مايقابلها في الثقافة الإسلامية والعربية.
هذا على مستوى البحث عن مصطلح الهرمينوطيقا بوصفه مصطلحًا له عنوانه الخاص في الفلسفة الغربية، أمّا على مستوى البحث الذي لايهتم بالدلالة الأصلية في سياقها الثقافي، فيمكن أن يجد مقاربة دلالية بين مصطلح الهرمينوطيقا ومصطلح آخر في الثقافة الإسلامية، تجمع بينهما حالة من الإشتراك في بعض المضامين الدلالية. وضمن هذا الإطار هناك مصطلحان لهما استخدامهما الرائج في الواقع الإسلامي ولهما مخزونهما الدلالي الخاص، ومع ذلك يمكن أن يشكلا حالة من المقاربة مع مصطلح الهرمينوطيقا، وهما مصطلحان: التفسير والتأويل، والوحدة الدلالية التي يمكن أن نستشفها بين هذين المصطلحين ومصطلح الهرمينوطيقا هو في اهتمامها جميعًا بفهم النصوص.[4]
علاقة الهرمينوطيقا بالتفسير
الهرمينوطيقا: مصطلح مدرسي لاهوتي يشير الى مجموع القواعد والمعايير التي يجب أن يتبعها المفسر لفهم النص الديني، فهي – إذا – نظرية ذات أصول دينية محضة فقد اقترنت نشأتها بدائرة الدراسات اللاهوتية. أو عنوان أطلقه أصحاب الدراسات اللاهوتية، تعبيرا عن مجموعة القواعد والمعايير التي يجب أن يتبعها االمفسر لفهم االنص الديني، ليكون مضبوطا وقائما على أًسس حكيمة، دون التبعثر والتشتّت في الآراء والأفهام، وأكثرها اعتباطا أو تحكيم للرأي على النص.[5]
التفسير: قال الزبيدي “الفَسْر: كَشْفُ المُغَطَّى، أَو هُوَ، أَي التَّفْسِيرُ: كَشْفُ المُرَادِ عن اللَّفْظ المُشْكِل”. وهذا يعني أنّ مفرة (فسر) تعني: الإيضاح وإزاحة الستر.[6]
التفسير یعنی بيان معاني الآيات القرآنية، والكشف عن مقاصدها وأهدافها أو: بيان المراد الإستعمالي لآيات القرآن، وتوضيح المراد الجدّي على أساس قواعد الأدب العربي، والأصول العقلانية للمحاوة.[7]
من هنا نفهم أن العلاقة بين الهرمينوطيقا والتفسير علاقة وثيقة ومتينة، وهي التي دعت العلماء المسلمين من استيراد هذا المصطلح “الهرمينوطيقا” إلى داخل البحوث التفسيرية.
الاتفاق والإفتراق بين الهرمينوطيقا والتفسير
الهرمينوطيقا…قضية قديمة وجديدة في نفس الوقت. وهي في تركيزها على علاقة المفسّر بالنصّ ليست قضيّة خاصّة بالفكر الغربي، بل هي قضيّة لها وجودها الملحّ في تراثنا الإسلامي القديم والحديث على السواء…وينبغي أن نكون على وعي دائم – في تعاملنا مع الفكر الغربي في أيّ جانب من جوانبه – بأنّنا في حالة حوار جدليّ، وأنّنا يجب علينا أن لا نكتفي بالاستيراد والتبنّي، بل علينا أن ننطلق من همومنا الراهنة في التعامل مع واقعنا الثقافيّ بجانبيه التاريخي والمعاصر…
هناك في تراثنا الإسلامي العريق، وعلى مستوى تفسير النص الديني (القرآن الكريم) تفرقة بائنة بين ما أُطلق عليه “التفسير بالمأثور” وما أًطلق عليه “التفسير النظري” القائم على أساس إعمال الرأي والإجتهاد، بما يؤدّي أحيانا الى تأويل النص الى ما يتجاوز محدودة ظاهرالنصّ السطحي… إن ثلاثية (المؤلف، النص، الناقد) أو (الفصد، النص، التفسير) لايمكن التوحيد الميكانيكي بين عناصرها؛ ذلك أن العلاقة بين هذه العناصر تمثّل إشكالية حقيقية، وهي: الإشكالية التي تحاول الهرمينوطيقا – أو التأويلية إذا شئنا استخدام مصطلح عربي- تحليلها، والإسهام في النظر إليها نظرة جديدة تزيل بعض صعوبات فهمها، وبالتالي تؤسس العلاقة بينها على أساس جديد…نعم، إن مهمّة الهرمينوطيقا هي فهم النص كما فهمه مؤلفه، بل حتّى أحسن ممّا فهمه مبدعه.[8]
خصائص ومميزات التفسير
1 – يسعى المفسّر في الحصول على معنى المتن وهو المراد الجدّي للمتكلم والمؤلف، والنصوص المقدسة رسائل وتعاليم إلهية للبشر، وإن هدف المفسر هو إدراك المعاني والتعاليم النهائية التي يتضمنها المتن.
2- إن الوصول إلى معاني المتن (مقصود المتكلم والمؤلف) يكمن في سلوك المنهج المتعارف والعقلائي في فهم النصوص وذلك على أساس حجيّة ظواهر الألفاظ، وأن دلالة الألفاظ تتبع الوضع اللغوي والأصول والقواعد العقلائية للمحاورة والتي يستخدمها كل متكلم ومخاطب في جميع اللغات وعلى أساسها يتكلمون ويتفاهمون.
3- قد يصل المفسر إلى الفهم التعييني للمتن (فهم النصوص) وقد يتوصل إليه بصورة ظنّية (فهم الظواهر)، وأحيانًا يخطأ في فهم المتون.
4- هناك معايير لتشخيص أخطاء المفسرين منها: قوانين المنطق، القواعد العقلائية للمحاورة (أصول الفقه)، قواعد التفسير التي جاء بيان بعضها من قبل القدماء (مثل قاعدة االتفسير بالرأي )، وبعضها الآخر دوّن من قبل بعض العلماء…
5- لاتعتبر الفاصلة الزمانية بين عصر المفسر وزمن ظهور المتن مانعًا جدّيًا دون الحصول على المقصود والمراد الجدّي لمتن القرآن. وذلك:
أ- بسبب وجود بعض القرائن الواردة عن طريق الأحاديث، شأن النزول والتاريخ والتي يمكن من خلالها اكتشاف المعاني الأصلية للنص إلى حدّ بعيد.
ب – حجيّة ظواهر القرآن؛ فإذا ما انعقد هذا الظهور في زماننا فسوف يتحقق موضوع هذه الحجيّة.
6- لايحق للمفسّر أن يحمّل النص آراءه وأفكاره المسبقة وإلا فسوف ينتهي به الأمر إلى الوقوع بالتفسير بالرأي المحرّم وغير المعتبر، ولابد أن يكون ذهنه خاليًا من أيّ رأي مسبق (وإن كان هذا غير ممكن بصورة كاملة).
7- إن مصدر القرآن هو الله سبحانه وتعالى وليس للنبي (ص) أيّ دور في تعيين أو تغيير ألفاظ ومحتوى الوحي، وهذا ما أشارت إليه الكثير من الآيات. [9]
خصائص التفسير على أساس الهرمينوطيقا ونتائجه
1- إن فهم المتن هو حاصل تركيب وامتزاج أُفق المعنى للمفسر مع أٌفق المعنى للمتن، ولهذا فإن دخول ذهن االمفسر وقبلياته في التفسير ليس أمرًا مذمومًا، بل هوشرط في حصول الفهم ولايمكن اجتنابه.
2-إن الإدراك العيني للمتن لايعني امكان الحصول على الفهم المطابق للواقع؛ وذلك لأن عنصر الذاتية (أي ذهنية المفسر وأفكاره المسبقة )هي شرط في حصول الفهم، ولايمكن الإستغناءعنه في كل فهم.
3-إن فهم المتن هو عمل لانهاية له، ولذلك فإن هناك قراءات متعددة للنص؛لأن فهم المتن امتزاج أٌفق المعنى للمفسر مع المتن – كما قلنا – وعن طريق تغيير أًفق المعنى للمفسر يمكن الحصول على تراكيب غير محدودة وبالتالي تتعدد القراءات للنص.
4- لايوجد فهم ثابت ونهائي وغير قابل للتغيير للمتن.
5- إن الهدف من تفسير المتن ليس فهم وادراك «مراد المؤلف» فنحن نواجه المتن وليس المؤلف، والكاتب هو أحد قرّاء المتن ولامرجّح له على غيره؛ فالمتن موجود مستقل، والمفسر يحاول أن يحصل على فهم النصّ من خلال الحوار والجدل بينه وبين النصّ، فليس مهمَّا عندنا ماذا يقصد المؤلف وأيّ معنى يحاول إلقاءه.
6-القرآن نصّ لغويّ ومحصول ثقافي، ولسانه مختص بالمخاطبين ولايمكن فصله عن بيئته وثقافته التي نزل فيها. وإن نصّ القرآن تكوّن عن طريق الواقع التاريخي وثقافة عصره…!؟
7- إن بعض نصوص القرآن تعتبر شواهد تاريخية صدرت تحت شرائط خاصة أمثال: الجن، الشيطان، الحسد، الربا، الدعاء، التعويذ والأحكام المتعلقة بالرزق، ولايمكن سرايتها إلى أزمنة أًخرى.[10]
ثمّ ذكر مناقشة نتائج بحث الهرمنيوطيقا في تفسير القرآن وقال:
أحد المسائل التي غفل عنها أصحاب هذه الرؤية ولها دور مهمّ في تعيين الموضوع هو اختلاف القرآن الكريم عن المتون التاريخية وحتى المتون المقدسة الأخرى (التوراة والإنجيل وملحقاتها). فالقرآن نصّ مقدس من عند الله سبحانه في جميع كلماته وحروفه، ومؤلفه ليس إنسانًا عاديًا، أي أنه ليس كلامًا بشريًا؛ فالنبي (ص) يعتبر ناقلاً للقرآن فقط وليس له الحق في تغيير الوحي بالزيادة أو النقصان وهذا ما أشارت إليه الكثير من الآيات القرآنية. وقد كان النبي (ص) أمينًا في نقل كلام الله سبحانه وتعالى إلى حد كلمة «قل» التي وردت في بعض السور.
في حين نجد أن المسيحيين لايدّعون هذا الإدّعاء في نصوص التوراة والإنجيل، فإن الذين قاموا بتدوين الأناجيل (لوقا، متّى، يوحنّا، مرقس) جاءوا بعد زمان عيسى (ع) وعاشوا أزمنة مختلفة تقريبًا؛ ولهذا فقد دوّنت الأناجيل بأربعة صور، وعلى هذا الأساس فإن هناك من اعتبر هذه الأناجيل انعكاس وصدى لثقافة ذلك الزمان. أمّا التوراة فقد دوّنت بعد وفاة موسى (ع) ولهذا يمكن أن نجد فيها أثر البيئة الثقافية وحتى بعض المسائل الخرافية. أمّا القرآن فهو يختلف تمامًا عن الكتب الأخرى، فهو ليس كتابًا بشريًا ولم يتعرض للتحريف، ولايمكن أن يكون انعكاسًا لثقافة عصره. إذا بنينا على أن جميع التفاسير وتعدد الفهم البشري في حال تغيّر وتحول فإن نفس هذه القضية الهرمينوطيقا (لايوجد لدينا فهم ثابت وغير متغير قط) سوف تكون متغيرة أيضًا، وحينئذ تكون الجملة متناقضة، ولذلك فإذا ما قبلنا النسبية في الفهم البشري بصورة كلية فلا يكون عندنا حينئذ فهم ثابت، وسوف تتعرض جميع العلوم البشرية إلى التشكيك ومن جملتها هذا الإدّعاء. أن هناك رأيين متضادين حول نية المؤلف في فهم النص:
أ- فقد أكد بعض العلماء على نيّة المؤلف في فهم النصّ واعتبروا أن هدف التفسير هو فهم نيّة ومقصود المؤلف أمثال: مارتين غلادينوس، فردريكاغوستولف، وشلايرماخر، وهذا الرأي يقترب مع وجهة نظر المفسرين المسلمين. وذلك لأن هدف المفسر هو فهم معنى المتن ومعرفة المراد الجدّي من كلام الله سبحانه وتعالى، ومن المؤكد أن القرآن ليس له مؤلفًا (بالمعنى البشري)، وإن النبي (ص) ليس إلا واسطة في وصول البيان الإلهي؛ فالمقصود من نيّة المؤلف هو الكشف عن المقصود الإلهي من آيات القرآن.
ب – رفض علماء الهرمينوطيقا الفلسفية أمثال هايدجر، وجادامر دور نيّة المؤلف في فهم المتن، وقالوا بأنه ليس هناك أهمية بالنسبة للمفسر في التعرف على نيّة المؤلف وقصده، وأي المعاني يريد إلقاءَها، وهذا الرأي قد يكون مفيدًا في فهم بعض الموارد في المتون التاريخية والأدبية، ولكن لايمكن قبول ذلك في فهم الكلام الإلهي؛ لأن هدف القرآن هو هداية البشر عن طريق الكلام الإلهي، فعلى المفسر أن يحاول إدراك الهدف الإلهي بصورة صحيحة ونقله إلى الآخرين، فإذا فرضنا أن الله سبحانه وتعالى يقصد إلقاء المطلب (أ)، وأن المفسر فهم المطلب (ب) فإنه لايعتبر موقفًا حينئذ في التفسير وفي فهم البيان الإلهي.[11]
النتيجة
إن للباحثيين الإسلاميين حول مصطلح الهرمينوطيقا رؤية مختلفة، منهم من له النظرة الإيجابية حول الهرمينوطيقا، ومنهم من له النظرة السلبية:
فالذين ينظرون إلى الهرمينوطيقا بالنظرة الإيجابية يطبّقون قواعد الهرمينوطيقا على تفسير القرآن، حسب ما يطبّق في الكتب المقدسة. لكن الذين ينظرون إلى الهرمينوطيقا بالنظرة السلبية يرون أن تطبيق قواعد الهرمينوطيقا على تفسير القرآن على حدّ سواء لايمكن، لأن تلك الكتب التي كانت تطبّق عليها قواعد الهرمينوطيقا من أجل فهم نصها منحرفة قد تلاعب فيها يدُ المتلاعبين، خلافًا للقرآن الذي محفوظ من قبل الله تعالى و”لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ” أيضا.
الهوامش
[1] – الزمر: 17-18.
[2] – مجلة حوليات المخبر، الرموز الهرمنيوطيقية في شعر عز الدين ميهوبي، No 03-04.
[3] – الرضائي الإصفهاني، دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية، ص297.
[4] – معتصم السيد أحمد، الهرمنيوطيقا في الواقع الإسلامي بين حقائق النص ونسبية المعرفة، ص58-59.
[5] – معرفت، التأويل في مختف المذاهب والآراء، ص154.
[6] – الزبيدي، تاج العروس، ج7، ص349.
[7] – الرضائي الإصفهاني، دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية، ص18.
[8] – هادي معرفت، التأويل في مختف المذاهب والآراء، ص154.
[9] – الرضائي، دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية، ص301-303.
[10] – الرضائي الإصفهاني، دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية، ص303-304
[11] – الرضائي الإصفهاني، دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية، ص304-305.
المراجع
القرآن الكريم
- بومدين بوزيد، الفهم والنص، دراسة في المنهج التأويلي عند شلير ماخر وديلتاي، الدار العربية للعلوم، ناشرون، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1، 1429هـ، 2008،
- خيرة حمر العين، الشعرية وانفتاح النصوص تعددية الدلالة ولا نهاية التأويل “دورية الخطاب”، منشورات مخبر تحليل الخطاب، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العدد السادس، جانفي 2011،
- الرضائي الإصفهاني، محمدعلی، دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن، تعريب: قاسم البضاوي، الناشر: مركز المصطفى (ص) العالمي للترجمة والنشر، الطبعة الثانية: 1431 هق – 1389 هش.
- الزبیدی، مرتضی محمد بن محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الفکر، 1414 هـ.
- فريديريك ارنست دانيال شلير ماخر (1768- 1834) المفكر الديني في العصر، الرومانتيكي، دو روح منفتحة، كان تفكيره حرا، يتجلى ذلك في كتابه “خطابات حول الدين، الذي صدر عام( 1799م ) و”مذهب الإيمان.
- مجلة حوليات المخبر، الرموز الهرمنيوطيقية في شعر عز الدين ميهوبي، No 03-04 (2015). (https://revues.univ-biskra.dz/index.php).
- معتصم السيد أحمد، الهرمنيوطيقا في الواقع الإسلامي بين حقائق النص ونسبية المعرفة، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1430 هـ – 2009 م.
- معرفت، الهادي، التأويل في مختف المذاهب والآراء، الناشر: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، المعاونية الثقافية، مركز التحقيقات و الدراسات العلمية، الطبعة الأولى، تهران- ايران – 1427 ه. ق